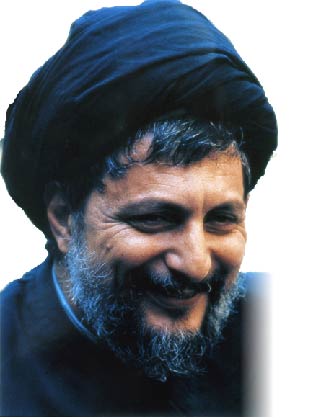مؤتمر "كلمة سواء" السنوي السادس: "حوار الحضارات"
(كلمات الجلسة السادسة)
لا بد للبحث في مستقبل الحوار بين الحضارات، وفي الآفاق المفتوحة أمامه، من الإحاطه أولاً بالمفهوم الذي نعطيه للحضارات ولطبيعتها، ومن التبصر في العوامل التي تسيرها في منعرجات التاريخ، لعلنا بمثل ذلك ندرك الحركة المستجدة لها في الزمن الحاضر ونحاول استشراق ما يمكن أن يؤول اليه مصيرها في القابل من الأيام أو من الحقبات.
ونسارع إلى القول في هذا المجال إن حركة التاريخ قد تتأثر بعض الشيء بأفراد يطلون على مسرح الأحداث ويطلقون فيه ضجيجاً خاصاً من مستحضرات أقوالهم والأعمال، إلا أن مثل هؤلاء مهما علا شأنهم لا يقررون المصير الروحي للكون بل يقتصر تأثيرهم على بعض الوجوه المادية أو الاجتماعية منه، وما تلبث أن تعود الأمور بعدهم إلى نصابها وحركة التقدم البشري إلى محاربها.
وقد يكون من المفيد بادئ ذي بدء، أن نتكلم عن الحضارة بصيغة المفرد قبل النظر اليها بصيغة الجمع، وأن نسلط عليها الضوء بما هي مقابلة للبداوة ونقيض لها. فنتصور الإنسان ما قبل الحضارة مغلوباً على أمره وسط طبيعة يصارعها بما لديه من وسائل شبه معدومة وتصرعه بما لها من قوة مادية أين منها قوته غير الموجودة بعد؟ إن مثل هذا الإطار هو الذي ينبري فيه أول ما ينبري إنسان الحضر وقد وعى علاقته بالطبيعة وبنظيره الإنسان معاً، فيتحول وجوده إلى حضور وينطلق نضاله على هدي من قيم تبيت تستهويه وتشده إلى عالم الروح. وإذا ما انتقلنا في كلامنا عن الحضارة من صيغة الجمع، فإننا نجد أنفسنا على مدى هذا الكوكب أمام انعكاسات متعددة لها، وهي تتغير من واحدة إلى أخرى، لا بفعل التنوع في طبيعة الإنسان نفسه، بل بفعل العوامل المادية والاجتماعية والفكرية التي تكون اختيار الشعوب في تقلبات حياتها. وربما كان أيضاً من الضروري بغية توضيح معنى الحضارة أن نحددها في تميزها عن الثقافة وفي تقاربها منها وبخاصة لأن الناس غالباً ما يدمجون بين هذين المفهومين، ويعنون مفهوماً منهما، حتى عندما يتكلمون عن المفهوم الآخر.
فالحضارة بالمعنى الحصري هي نمط عيش وطريقة تعامل مع الكون ومع الإنسان الآخر ومع المجتمع أو المجتمعات، بينما الثقافة هي حياة الروح والفكر والقيم بصورة أولى وهي تتطلب للحصول عليها جهداً خاصاً من كل إنسان إذ أن يكون المرء حضارياً دون أن يكون كثير الثقافة، ويمكنه أن يكون أيضاً مثقفاً دون أن يتعاطى مع كل مستلزمات الحضارة. ومن المعروف أيضاً أن الأديان بصورة خاصة لها دور مركزي في تكوين الثقافات وتفعيلها لأنها تعبر عن ارتباط المتدين بالمطلق وعن نظرته للكون وللتاريخ وللناس في علاقاته معهم وفي علاقاتهم معه. إلا أننا لا نعتقد بأن الكلام عن حوار الحضارات هنا يأخذ الحضارة بمعناها الحصري الضيق بل هو يأخذها بالمعنى الواسع الذي يشمل الحضارة والثقافة معاً. ويجب علينا التعامل مع الموضوع المطروح أمامنا على هذا الأساس.
1- بعد هذه الملاحظات، وهذه التوضيحات، نطرح السؤال أولاً حول ما سمي اليوم بفكرة تصادم الحضارات، وذلك قبل الولوج إلى موضوع الحوار فيما بينهما، سواء بالطرق التي اعتمدت له وحتى الآن، أم بالمستقبل المفتوح لإستكمال العمل في إطاره ومن أجل البلوغ معه للأهداف المنشودة. والسؤال هو هذا، هل إن الحضارات هي بذاتها مصدر صدام أم أن الصدام ينبع في الإنسانية من أسباب أخرى؟
المبدأ الفلسفي معروف وهو يقضي باعتبار المادة وليس الروح أساساً للانقسام بين الناس. فإن كانت الحضارة تعبيراً عن حياة الروح في الإنسانية فليست هي بحد ذاتها ما يجعل الناس يتخاصمون بل هي المصالح المادية، وهي قبل ذلك تلك النظرة المريبة إلى الآخر كخصم محتمل أو كمصدر تهديد للرزق وللحياة. وهذا ما يعرف عند الحيوان قبل الإنسان بالمدى الحيوي الذي نجده حتى في عالم الأسماك، حيث تنقسم المساحات والأحجام عبر خط واضح بين محيط خاص برف من الرفوف أو بجماعة معينة وبين محيط يعود لرف آخر أو لجماعة أخرى. إن مثل هذا التقسيم للمساحات الحياتية يعيدنا إلى الطبيعة الأولى أو إلى البداوة أكثر مما يدخلنا في عالم الحضارة. وربما كانت الحضارات في بداياتها تحمل على أكف أناس لم يطلقوا تماماً بعد عالم البدواة فتأتي التعابير عن حضارتهم وعن ذاتهم مزيجاً من تقدم ومن تخلف، فلا هي الحضارة المعيوشة عيشاً كاملاً بعد ولا هي البداوة المطلقة، وكأن الانسان لم يتسن له بعد أن يتخطاها. حتى لكأن مقياس الغوص في الانتماء إلى حضارة معينة أو إلى الحضارة بمفهومها الواسع موجود في إمكانية الإنسان لتخطيه الحذر من الآخر، والحكم المسبق عليه، وروح الاستعداء له، اذا ما وجده في الجهة المقابلة للخط الفاصل بينه وبين المدى الحيوي المذكور، وفي قدرة أي شخص على أن يرى في الآخر المختلف عنه مصدر تعاون وفرصة تعارف واعتراف متبادل بين أحرار. بهذا المنطلق نستطيع القول أن صراعات الناس هي بحد ذاتها علامة تخلف – إلا إذا كانت في سبيل حق سليب واستعادة لكرامة ممسوسة – وإن التقدم في الحضارة من شأنه أن يقرب الناس بعضهم من بعض لا أن يؤلبهم بعضهم على البعض الآخر لمجرد انتمائهم إلى حضارات مختلفة.
الصراعات بين البشر هي إذن وبهذا المنطق صراعات لاحضارية وليست تصادماً بين الحضارات التي ينتمي اليها هؤلاء أو أولئك من الناس. وهذا ما يحمل الأمل بتقدم الإنسانية. مع تقدم الحضارات أو مع تقدمها هي في الحضارة وفي تجسيد قيمها على أرض الواقع. وقد نسوق دلالة إضافية عن الفصل بين أسباب الصراعات والانتماء إلى حضارة من الحضارات، فهي موجودة بشكل ظاهر في الحروب التي جرت وتجري بين أناس ينتمون إلى حضارة واحدة، فالنازية الألمانية قد نبتت في قلب أوروبا وفي قارة كانت قد عرفت وحدة سياسية متقدمة في القرون الوسطى. ومع ذلك كان انقسام الشعوب الأوروبية بعضها على بعض بمثابة إدارة الظهر للحضارة التي أعطتها كثيراً من معالم هويتها.
ولكن هل يعني أن الحضارة لا تستطيع أن تصبح مصدر انقسامات أو سبباً للصراعات بين الناس؟ وهل تبرأ ساحة الحضارات كلياً من هذا الاحتمال لتحصر أسباب الانقسامات في خانة المصالح المادية وحدها؟ إنه لمن الصعب أولاً أن تدعو حضارات إلى قتل الآخرين ومحوهم من الوجود لمجرد انتمائهم المختلف عنها وأن تبقى معدودة في خانة الحضارات. وإن ما يجري في الحقيقة وعلى أرض الواقع هو تصور تعززه جماعة من الجماعات بأن حضارة ما هي أعلى من كل الحضارات مثيلاتها، وأن لها الحق في السيطرة على الآخرين سيطرة روحية ومادية لكونها هي الأولى بين حضارات الأرض. وما من شك في أن الثقافة الأوروبية قد شهدت أصحابها يروجونها في العالم على أنها الحضارة الأمثل ويحاولون أن يبرروا باسمها سيطرتهم على منابع الغنى في العالم عبر الإمبريالية. وها هم اليوم في أوروبا يعيدون النظر بهذا الاستعلاء الخاطئ ليدركوا أن الحضارات كلها هي مصدر غنى بعضها لبعض عبر التبادل الروحي فيما بينهما والتكامل الإنساني.
أما الإسلام وقد اتهم في بعض الأحيان بأنه يفرض على الغير حضارته دون سواها، فإنه بالحقيقة لم يرفض حضارة الغير بمقدار ما كان في بعض الظروف يرد الفعل بالدفاع عن حضارته وعن هوية أهله الروحية والفكرية وبخاصة عندما كان يرى استعلاء الغرب عليه وإنكاره لقيمه التي كان يجهلها أو ينظر اليها نظرة سطحية وخارجية ليس إلا. وفي كل حال فها هي دنيا العرب والمسلمين مفتوحة الأبواب والنوافذ للحوار بين الحضارات عبر تفاعل أهلها مع الحضارة الغربية في كثير من مدارسها ومعاهدها وجامعاتها العربية والإسلامية كما أن تعليم الإسلاميات بات منتشراً والحمد لله في مجمل الجامعات الغربية والمسيحية عبر العالم من أقصاه إلى أقصاه. إلا أن التأكيد يبقى مفيداً وضرورياً بأن ليس كل مسلم يمثل كل الإسلام وليس كل مسيحي يمثل كل المسيحية. فالبشر عرضة للنقص وللحسابات الخاصة على أنواعها وهم لا يحيون في كل ظرف بمقتضى دياناتهم ولا هم يجسدونها على الدوام التجسيد الحقيقي المطلوب.
2- على ضوء ما تقدم يطرح اليوم السؤال الكبير حول الحوار ومستقبله بين الحضارات وبخاصة بين المسيحية والإسلام كونهما أكثر من غيرهما ديانتين عالميتي الرسالة والانتشار، ولأن بعض الناس يحاولون زرع الشك في النفوس حول الثمار المرجوة من مثل هذا الحوار، اذا ما قيض له بنظرهم أن يتحقق. وأول ما يتبادر إلى الذهن في هذا المجال أطروحة الكاتب الأميركي صاموئيل هانتيغتن الذي أنذر في أطروحاته بوقوع صدام آت لا محالة بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية. لكن هذا الكاتب يدين نفسه بنفسه، حين ينطلق بأفكاره من منطلقات سياسية وليس من منطلقات فكرية، إنه يربط بين الثقافة والقوة، وبين ضعف الغرب وزوال سلطته الإمبريالية، ليؤكد تراجعاً ممكناً للحضارة الغربية وصعوداً خطراً عليها للحضارة الإسلامية. ونحن نلفت هذا الكاتب كما نلفت الغرب كله إلى ضرورة إعادة ما انقطع من وصل في الحضارة الغربية بينهما وبين القيم الدينية المسيحية بالذات. إذ إن هذا الغرب لا يدرك أنه اذا ما أفرغ ذاته من المسيحية فإنه يفرغ ذاته من ذاته، لا أقل ولا أكثر. أما الحضارة المسيحية الحقة، فهي التي وقفت في مؤتمر القاهرة حول المرأة والعائلة منذ أربع سنوات، ممثلة بالكرسي الرسولي إلى جانب الشخصيات الإسلامية المشاركة فيه من إيرانيين وعرب وأفارقة للدفاع عن قيم إنسانيه وأخلاقيه بدونها تزهق روح العالم على أنقاض مادية صنمية خرقاء.
ولنقل في هذا الشأن أن الإمبريالية الغربية قد ولت غير مأسوف عليها فهي قد استغلت المسيحية وانتشارها لمآرب سياسية واقتصادية وهي لم تقم أصلاً من أجل المسيحية ونشر تعاليمها، هذا فيما الإيمان المسيحي مدعو للولوج في مجمل ثقافات الأرض، وفيما التعبير عن هذا الإيمان لا يتم بالثقافة الغربية وحدها ونحن هنا مسيحيون شرقيون. وفي كل حال، فإن الغرب المسيحي لا يجاري نبي الشؤم هانتيغتن بما راح يروّج له من أضاليل، بل على العكس، فإنه بات يتعاطى مع الثقافات المتعددة في العالم على أساس من التبادل المرشح إلى ازدياد في الأزمنة الآتية وليس إلى نقصان. والإسلام نفسه قد عرف انتشاراً عالمياً صار معه المسلمون مندرجين في بلدان متعددة القوميات والإثنيات من مشارق الأرض إلى مغاربها. فهو ليس ابن قومية واحدة ولغة واحدة على الرغم مما للعربية من مكانة خاصة في صلاته واتصالاته. وقد بات متعايشاً والمسيحية في مجمل الدول والمجتمعات إلى حد أنه صار يصعب القول أن العيش المشترك هو نصيب بعض المسلمين وبعض المسيحيين في العالم، فيما تحيا الأكثرية منهم في دول ذات لون واحد. على هذا الواقع الجديد نفتح أبواب المستقبل وهو قابل لازدياد لا لنقصان أو تغيير.
وإن هذا الأمر متوافق مع طبيعة الإسلام والمسيحية أكثر مما يتوافق مع أوضاع الديانات الكونية الأخرى. فالإسلام والمسيحية يتوجهان إلى كل الشعوب بينما الديانات الأخرى تبدو وكأنها تكتفي بحدود انتشارها منذ الآف السنين. فإن كان الأمر كذلك، وبما أن لا إكراه في الدين، فكيف يمكن لمن هم أقرب الناس مودة بعضهم من بعض ألا يتحاوروا ويتعاونوا على نشر روح التوافق في الأرض التي لو شاء ربها لجعل الناس فيها أمة واحدة؟
إن آفاق المستقبل في ما يعود للحوار بين الأديان تضعنا منذ اليوم على سكة تصحيح العولمة المادية والسياسية بواسطة العالمية الروحية والإنسانية التي تلهم اليها بخاصة المسيحية والإسلام. فهذه العالمية تبنى على المساواة بين البشر وبين حضاراتهم بوصفها تعبيرات متعددة عن الإنسان نفسه. وبما أن الانسان فينا واحد فإن غنى أية حضارة لا يخص أبناءها وحدهم بل هو ملك للإنسان في الإنسانية كلها إذ لا احتكار لأمور الروح كما لا يمكن احتكار الشمس والهواء من قبل أحد. وبما أن مصدر الأديان واحد، سواء ارتكزت على التقاليد أو العقل أو الوحي نفسه، وبما أن الحاجة إلى الدين هي من صنع الخالق وليس من المخلوق الذي وجدها في نفسه، فلا مجال لغير التلاقي والتعارف والتحاور بين من يعتنقون الأديان فهم خدام في رحابها لا سادة عليها، وإن سيادتهم في الحياة لا يمكنها أن تتعارض وروح السيادة الإلهية التي تنشر فينا عبير السخاء والرحمة والخير لا أنفاس النفور من الآخر وحرمانه من نعمة الوجود.
إن عالماً ينكر الحوار بعد اليوم ويجافي التثاقف والتعاون على أساسا لاحترام المتبادل لجميع منابع الإنسانية فيه، لهو عالم يحكم على نفسه بالفناء. فلقد أصبح للموت الجماعي طريقة وهو الاقتتال ورفض الآخر كما صار للحياة طريقها وهو الاعتراف بالآخر، أياً كان لأن فيه ظلاً من رحمة الله. وإذا كان العالم قد عرف يوماً الركض إلى مناجم المعدن الذهبي فإن هذه المناجم قد أصبحت اليوم أوسع مدى في مكتنزات الحضارات عند الشعوب، فهلا تحمسنا لاكتشاف المعدن الأصيل في قلوب الآخرين وأفكارهم وفي التعابير الحية للحقيقة المزروعة في أعماق كيانهم؟
وإن ما يجمع الناس في الإنسانية هي تلك الصورة الإلهية التي ضاعت في تفاصيل حياتهم وفقدت لمعانها مع غبار الايام والمتاهات التي عبروا فيها وما يزالون. أما استعادة هذه الصورة فهي بحد ذاتها تفتيش عن الأصل وعن طبق الأصل لا تنكر له عبر صنميات جديدة ومصنوعات أيد غير يد الله. فالضلال في هذا كفر بالنعمة والحقيقة عبادة وشكر. ألا فليعطنا الله أن نكون من أبناء الحقيقة والعباد الصالحين، وشكراً.