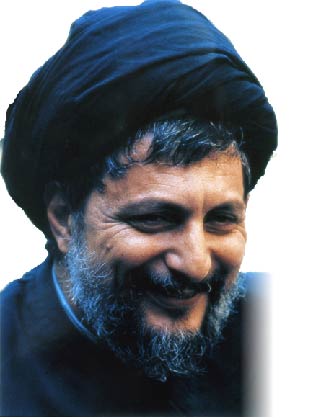مؤتمر "كلمة سواء" السنوي السادس: "حوار الحضارات"
(كلمات الجلسة الثالثة)
أمتنا اليوم مصابة لأنها محصورة ومحشورة بين الأصوليتين، الأصولية الاسلامية والأصولية الأميركية والاصولية كما عرفها الأستاذ سمير فرنجية تعتبر أنها عودة إلى الاصول وهي في الحقيقية ايجاد مرجعية ومفاهيم في ذهن أصحابها يعترونها- أي يعتبرون هذه المفاهيم - هي الأصول فيما ولو فرضها على الناس.
والموضوع الآن الذي يشغل بال مثقفينا العرب والمسلمين هو حوار الحضارات وفي رأيي أنا هذا الحوار له ثلاثة أوجه: العولمة هي شكل من اشكال الحوار أو الصراع كذلك ما يسمى صراع الحضارات وكذلك تفوق الحضارة الغربية وقيمها.
تلقف المثقفون العرب، والمسلمون عامةً، مقولة صراع الحضارات (وحوار الحضارات وَجْهٌ آخرُ لها) بشغف كبير. والمقولة طرحها بدايةً استاذ جامعي أميركي، لكنه استخدمها بطريقةٍ تختلف عما فعله العرب والمسلمون. فعلى الرغم من أنها مقولةٌ ثقافيةٌ مطروحة لأهداف سياسية استراتيجية لدى الأميركيين، فهي تعالج في اطارٍ ثقافيٍ بحتٍ عندنا، وبذلك جردت من السياسة، فكأن المثقفين عندنا لم يدركوا المغزى السياسي لها، أو ليس لديهم من السياسة ما يقولون عنه شيئاً والنتيجة هي ان المقولة ثقافية - سياسية عند من طرحوها بينما هي ثقافية بحتة عندنا؛ فكأن الذين يشنون صراعاً حضارياً بحتاً هم نحن لا هم.
طرح المقولة استاذ بروتستانتي محافظ في هارفرد في العام 1993 ضمن مقالةٍ نشرتها مجلة Foreign Affairs، ثم وسعها في كتاب صدر في العام 1996، وكان اهتمام الغربيين بها أقل بكثير من مثقفينا؛ سنعود اليه. المهم الآن هو الاشارة الى أنّ أية مقولة ثقافية تبقى وهمية، مجرد ايديولوجيا بالمعنى السيء، اذا لم تؤد وظيفة ما. ومن الممكن فَهْمُ وظيفة هذه المقولة لدى مثقفينا اذا بحثنا الأمر في سياقاتٍ ثلاث: العولمة وتحدياتها، صراع الحضارات وحواراتها، وتفوق الحضارة الغربية وقيمها. وهذه السياقات تتعلق بفهمنا لما يجري في العالم وبوعينا لدورنا فيه وبموقفنا من نقاط الضعف لدينا. لقد تلقفنا مقولةَ العولمة كي يتدعم لدينا الوهم بأن العالم يتآمر علينا (لا لنفهم اواليات عمله). ثم استقبلنا مقولة "صراع الحضارات" مشترطين ان يتحول الصراع الى حوار كي نكون طرفاً فيه منعزلاً عنه وفي مواجهته دون انخراط جدّيٍ في العالم. ثم انشغلنا بالرد على مقولة تفوق الحضارة الغربية وقيمها المسيحية كي نبرر للعقل المستريح استقالته من السياسة، علماً بأن ممارسة السياسة تتطلب إعمال الفكر وإبداع الرأي وتعبئة الارادة، وهذا ما نفعله، فبقي تفوق الغرب حقيقة قائمة ما استطعنا التغلب عليها أو تجاوزها. ولكي لا يبقى مجال لالتباس الرأي نقول إن العولمة وَهْمٌ وإن حوار الحضارات (وصراعها) وهمٌ أكبر، وإنّ الحقيقةَ الوحيدة التي يجب التصدي لها هي تفوق الغرب، وإنّ تفوقَ الغرب ليس مسألةً تقنيةً بل هو حصيلةُ تفوق القيم خاصةً الأخلاقية منها. وهذا إذا أردْنا أن تكون صلتُنا بأمتنا وبتاريخها صلة غير ايديولوجية، أي غير وهمية، صلة مبنية على الواقع وحقائق التاريخ. ومن أدرى بحقائق التاريخ إلا من يعانيها؟
النظام العالمي الراهن
لقد ساهمت مقولة العولمة (وهي تعبيرٌ استخدمه الأميركيون لأغراضٍ سياسيةٍ بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وحرب الخليج الثانية) في تعميق مواقف المواجهة بيننا وبين الغرب (بل بيننا وبين العالم)، وفي اختزال رؤيتنا للعالم تحت عنوان المواجهة. فيما اعتبرنا النظام العالمي فرصةً يمكنُ أن نستفيد منها (وأن يستفيد منها الغير، وربما ضدنا)، ولم نعتبرها شأناً متعدد الاحتمالات؛ فكان خيارنا أن نحشر أنفسنا في الزاوية بحجة المؤامرة المحاكة ضدنا.
ونسجنا حول ذواتنا قفصاً ايديولوجياً حبسْـنا أنفسنا فيه. وكان الأمر سهلاً، إذ إننا كنا نخرج من مقولات الصراع ضد الاستعمار والامبريالية، ثم الامبريالية الجديدة، فجددنا المواجهة تحت عنوان تحديات العولمة. فكان التعبير الجديد عن مفاهيم قديمة بمثابة الوقوع في الفخ.
وغاب عن ذهننا ان الدول الوحيدة التي خرقت جدار التخلف، في النصف الثاني من القرن العشرين، حققت ذلك دون توافق دون ما يسمى "المواد الأولية"، ودون انتظار ما يسمى "التحول الثقافي" (أي إحداث تغييرات جذرية بحيث تصبح الثقافة المحلية ملائمة لمتطلبات التقدم)، ودون البرهان مقدماً على أن التقدم لا يحتاج إلا لإرادة التقدم (سواءٌ أكانت ديكتاتورية أم تقدمية)، هي الدول التي تعولمت، أي انخرطت في السوق الرأسمالية والتي أسست على قاعدة العمل والإنتاج.
كما غاب عن ذهننا أنّ التقدمَ التقنيَّ (وهذه مسألةٌ تتعلقُ بالقرار السياسي دون أي شيء آخَر) تتيح حَرْقَ المراحل وإحرازَ تطورٍ اقتصادي، وبالتالي اجتماعي، في وقت قصير جداً. فالدولة لم ينته دورها في عصر "العولمة" الموهوم، بل انتهى عصر الدول "الوهمية"، التي استطاعت التسلل إلى البقاء من خلال ثغرات الحرب الباردة. لكنّ المجتمعات التي أحدثت تقدماً حقيقياً في أواخر القرن العشرين لم تأبه كثيراً لمتطلبات الحرب الباردة، ولا لما بعدها، رغم ارتباطاتها بهذا الفريق أو ذاك، ولم تتحكم بها الاعتبارات "الشعبوية".
وعندما ثبت خطأ مقولة "التنمية المستقلة" على يد أنظمة أسيويةٍ شرقيةٍ لم تكن "مستقلةً" بالمعنى الذي عهدناه، لم نعدل نظريتنا عن التنمية. فما أدركنا أن التنمية المستقلة، وهي نظرية صدرت في الخمسينات على يد بول باران وسويزي وغيرهما، هي نظرية تصلح لمرحلة النضال الوطني من أجل الاستقلال، ولم تكن خطأً في حينه، إلا أنها لم تعد تفي في مراحل لاحقة بعد الاستقلال. فهذه النظرية، على صحة ما فيها من مقدمات، تستدعي التضحية بالنمو لصالح الاستقلال، وهذا أمر يصلح لمرحلة يكون فيها الاستقلال هو موضوع النضال، أما عندما يتحقق الاستقلال، فلا مجال للإبقاء على النمو موضوعاً ثانوياً، إذ يصبح هو الأولوية الأولى.
لكنّ الأسس النظرية التي تأسست عليها مقولة "التنمية المستقلة" بقيت صحيحة، لأن النظام ما زال رأسمالياً عالمياً مبنياً على استغلال الشعوب في البلدان الاخرى، واستغلال الأفراد في البلدان الصناعية المتقدمة. فهذا النظام لا يختلف اجتماعياً (العلاقات بين الطبقات والفئات الاجتماعية) عما كان الأمر عليه منذ خمسة قرون، كما لا يختلف اقتصادياً عما كان عليه في بداية القرن العشرين، وعما كان عليه في مراحل سابقة في المناطق التي جرى ضمها تباعاً للسوق الرأسمالية العالمية.
يحتاج هذا النظام العالمي بحكم طبيعته الرأسمالية الى أن يتوسع دائماً، توسعاً أفقياً جغرافياً باحتلاله مناطق جغرافية جديدة (الهند والعالم الاسلامي قبل القرنين التاسع عشر، القارة الأميركية قبل القرن السادس والسابع عشر، ومناطق شمال آسيا وسيبيريا وأوروبا في مراحل مختلفة) وعمودياً بتعميق مجال التبادل الرأسمالي الذي يخترق اقتصاديات البلدان المدمجة ويخضعها لضرورات التبادل السلعي ويجعلها تابعةً للسوق الرأسمالية أو يلغيها كلية.
وقد كان الأجدر أن تقودنا الدراسات لتاريخ العالم الى الاستنتاج أنّ عالمية النظام غير عولمته، بمعنى أن تكون للنظام العالمي مرجعيةٌ واحدةٌ ذات قدرةٍ على أخذ القرار. إن العالمية موجودة منذ زمن طويل (فالرأسمالية لا يمكن إلا أن تكون نظاماً عالمياً يتوسع أفقياً ثم عمودياً وباستمرار)، ولكن العولمة لم تحدث بعد العام 1989، بل بقي النظام عالمياً (والأرجح أن عولمة النظام العالمي قد بدأت منذ 11 سبتمبر، فالولايات المتحدة لا تترك للآخرين إلا خيار "المع" أو"الضد" والذين "مع" يتلقون التعليمات للتنفيذ، أما الذين "ضد" فيُحكم عليهم بالدمار) وبعد 11 أيلول ما تحاول الولايات المتحدة، أن تفعله هو أن تصبح حكومة تحكم العالم وليس من خلال الأمم المتحدة فهي عملياً ألغت الأمم المتحدة، ولذلك كلام ابن لادن بأن علينا أن نرفض الأمم المتحدة هو كلام خاطئ بكلية لان الأمم المتحدة الجمعية العامة كانت بمعظم الأحيان لصالح العرب، مشكلتنا ليست مع الأمم المتحدة بل مع مجلس الأمن حيث للأمريكين حق النقض.
وإذا كانت عالميةُ النظام العالمي غير عولمته، فإنّ التمييزَ بينهما لا يعني أخْذَ موقفٍ لصالح هذا أو ذاك. فالنظام العالمي لم يكن يوماً إلا رأسمالياً مبنياً على الاستغلال، استغلال الأفراد لصالح أصحاب رأس المال، واستغلال شعوب بكاملها لصالح دول المركز الرأسمالي. كما أنّ النظام المعولم الذي تحكمه دولة مهيمنة ليس مثالياً ولن يكون كذلك ما دامت الدولة الرئيسية فيه، أي الولايات المتحدة، لا تستطيع أن تقدم فكرةً سياسيةً واحدةً تجعله مؤسَّساً على السياسة لا على الأمن، علماً بأن اي نظام مؤسس على اعتبارات أمنية لن يكون إلا نظاماً قمعياً وقسرياً واستبدادياً. ومن غير المفيد لهذا النظام العالمي، إذا أريدت عولمته، أن يتأسس على المبدأ الاسرائيلي (الشاروني، ولا فرق بين شارون الليكودي وحزب العمل) القائل بحل أمني لمشكلة سياسية. إن عولمة النظام لا تقوم على مبدأ "القرية الكونية"، ولو كان الأمر كذلك لكان الترحيب واجباً. لكن المثال المقترح، الذي شارك في وضعه وصياغته عرب مع غيرهم من أصحاب النوايا الحسنة، هو غير الواقع. وهو غير النموذج الذي تهتدي به الدولة الرئيسية صانعة القرار. فالقرية الكونية تعتمد مبدأ التشاور بين بشر ذوي نوايا حسنة تجاه بعضهم البعض، وفي ذلك تفاؤل انساني مبرر. اما النظام المعولم، خاصة بعد 11 أيلول، فهو يعتمد على محاربة الارهاب والجريمة، ويفترض بحكم الضرورة (ربما؟) نوايا سيئة متبادلة بين البشر. وفي نظام تؤدي اوالياته الى ازدياد الهوة بين الاغنياء والفقراء. والى تهديد الكرة الأرضية بالتلوث والأسلحة الشاملة، والى نكث الاتفاقات الدولية التي تحد من الأخطار، لا بد أن تكون هناك نوايا سيئة، ولا بد أن تكون النوايا السيئة متبادلة.
يتيح النظام العالمي حركة المال والسلع والأشخاص بوتائر مختلفة لكل منها. فالمال يتحرك من بلد الى بلد بحرية كاملة، بفضل تطور أنظمة الاتصالات والكومبيوتر، والسلع تتحرك بحرية أقل، وما زالت منظمة التجارة الدولية تحاول تخفيف العوائق أو إزالتها، أما حركة الأشخاص فما زالت تخضع لقيود (مهنية أحياناً). فالأشخاص يتمتعون باحترام لدى النظام الدولي أقل من السلع، وهذه بدورها، تتمتع باحترام أقل من المال، فأين هي العولمة؟
حوار الحضارات وصراعها
جاءت مقولة "صراع الحضارات" فقامت الدنيا ولم تقعد. وكان إصرار النخب الثقافية والسياسية عندنا على قلب المقولة الى "حوار الحضارات". ففي الصراع نعرف أن موازين القوى تقود باتجاه واحد هو أن نسحق وندمر، أما الحوار فهو يسمح لنا بأن نكون طرفاً. وبذلك نستريح من عناء الجهد والعمل وتعبئة الارادة لنصنع الأمة ونوحد القدرات ونضاعف الانتاج. ولو بني الموقف على دراسات متأنية للأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والتاريخ لأدركنا أن صراع الحضارات وحوارها وجهان لعملة واحدة، وأن الحضارات لا تتصارع ولا تتحاور، بل الناس هم الذين يتصارعون ويتحاورون لأسباب سياسية واقتصادية، وأن مواقفهم لا تنبع من معطياتهم الحضارية والثقافية، لو كان تصرفي ينبع من كوني عربي مسلم لكنا جميعاً أو معظم الموجودين في هذه القاعة يتصرفون بشكل متشابه تماماً. ولكن سلوكنا وتصرفنا لا ينبع من كوننا مسلمين أو غير مسلمين تنبع من رؤاهم للمستقبل، ومن الأهداف التي يحددونها لأنفسهم ولمجتمعاتهم. ولأدركنا ايضاً أن الحضارات ليست كتلاً يعمل كل منها وكأنه آلية منتظمة، بل فيها من التناقضات الداخلية ما يفوق، ربما، التناقضات بين حضارة وأخرى، ويتواطأ بعض أبناء حضارة ما مع آخرين من حضارة أخرى ضد بني قومه. ولأدركنا، كما عبر بروديل (المؤرخ الفرنسي العظيم) أن مقولة الحضارات لا تؤدي الى الفهم إلا إذا أخذت على المدى الطويل (والمدى الطويل هنا هو القرون لا عشرات السنين)؛ وأن إخضاعها للعوامل والرؤى والمواقف السياسية المباشرة لا يؤدي إلا إلى الوقوع في نوعٍ من العنصرية الجديدة· ووقعنا في الفخ مرةً اخرى.
ولو استندنا الى تاريخنا لاستنتجنا من دراسة كتب الجغرافيا والرحلات (ابن بطوطة، وابن جبير، وابن فضلان، والإدريسي، وابن خرداذبه، وابن رسته وغيرهم...) أن حضارتنا العربية الاسلامية لم تفترض آخر مغايراً او مضاداً. فما الحديث عن الآخر والحوار معه الا نوع من التشاطر الثقافي الذي قادنا اليه انصاف المثقفين ومخططو السياسة. إن حضارتنا العربية - الاسلامية لم تشيد جداراً بينها وبين البرابرة، كما فعل الصينيون وكما فعل اليونان، وذلك لأنها لم تفترض أن الآخرين برابرة، ولأنها لم تفترض أنّ المجالات الحضارية الاخرى "آخر" مغاير لها. فحضارتنا على مدى التاريخ مزيج من حضاراتٍ أخرى، وهذا هو سر عظمتها. وقد تخلينا حاضراً عن عظمة هذا التركيب الثقافي لننساق وراء مقولاتٍ وضعها دارسون غربيون عن الذاتية والمغايرة والتفرد والخصوصية، وهؤلاء ليسوا بعيدين عن مراكز البحث الاستراتيجي في بلادهم.
أما الذين يمكن أن يقولوا إننا في تاريخنا قد قسمنا العالم الى دارين "دار الحرب" و"دار السلم"، كما ورد عند الفقهاء وكما عبّرت عن ذلك كتب السير (الفزاري، وأبو يوسف، والشيباني وغيرهم) فالجواب هو أنّ هؤلاءِ الفقهاءَ أنفسَهم كانوا في الوقت نفسه يسعون الى التسوية بين الدارين عن طريق دُورٍ متوسطةٍ أو مُلْغية، مثل دار العهد ودار الموادعة، لأنّهم كانوا يركّزون على العلاقات السياسية والعسكرية، ولم يروا في الأمر فروقاتٍ حضاريةً أو ثقافية. وهم كانوا يعلمون ما لا نعلمه نحن، وهو أنّ الصراعَ بين الحضارات، حين يوجد، لا يكون صراعاً حضارياً أو ثقافياً إلاّ للتبرير الإيديولوجي، لتبرير أفعالٍ سياسيةٍ وسياساتٍ عسكرية ومنافسات اقتصادية تستخدم الحضارات مطيةً كما يستخدم الطائفيون في لبنان الدينَ مطيةً لغاياتٍ مباشرة.
لقد بنى أسلافنا (إذا صح التعبير) حضارةً مفتوحةً على العالم لا انفصام بينها وبين أصحاب الديانات أو الثقافات الأخرى، ولا جدران بينها وبين "البرابرة"، ولا استعلاءَ على مَنْ يخالفونها في الدين ونمط العيش؛ بَنَوا حضارةً للإنسان فحوَّلها المعاصرون حضارةً للمسلمين بتأثير من مقولاتٍ عن الصراع والحوار بين الأديان والثقافات صادرة عن مراكز دراسات استراتيجية غربية. وكان "المعاصرون" القوميون قد صادروا مشروع الأمة العربية التاريخي ليضعوه في قوالب القومية على النمط الاوروبي، دون دراسة وفهمٍ لتجربة الأمة التاريخية ففشلوا لأنهم لم يدركوا أن هذه الأمةَ سيرورةٌ تاريخيةٌ؛ كانت وستبقى قيد التكون والتطور، وليست معطى من الماضي يحتاج الى مجرد ابراز وإعادة تجسيد. ولم يدركوا أيضاً أن الهوية، بل الأمة، مشروعٌ للمستقبل، وأنّ المشروع يجب أن يكون سياسياً قبل كل شيء، أي قبل أن يعتبر حضارياً، وأنّ المشروع سيؤدي الى ولادة أمةٍ جديدةٍ لا إلى تكرار وجودٍ مضى. وباعتبارهم الأمة معطى من الماضي فقد وضعوا بينها وبين الآخرين فاصلاً (خلافاً للتجربة التاريخية) وكانوا بذلك تمهيداً للإسلام السياسي الذي يضم الفرق المتطرفة التي جعلت بين المجال الحضاري الاسلامي والعالم خطاً فاصلاً، خطاً للمواجهة الحضارية والثقافية (لا السياسية) مع العالم. وكان لا بد لهذا الخط الفاصل أن يكونَ قاعدةً للهزيمة الدائمة وللخسارة في كل مواجهة حتى الآن.
إنّ الآخرَ كامنٌ فينا، بحكم تكوين أمتنا التاريخي؛ وهذا الأمر يتيح لنا أمكانياتٍ كبرى للتحرر، لتجديد مشروعٍ تاريخيٍ للأمة، مشروع لا يمكن إلاّ أن يكونَ عالمياً. وهذا الامة ما عرفت في تاريخها المغزى والمعنى لذاتها إلا عندما كان لديها مشروعٌ كونيٌّ مجاله العالم، لا بمعنى الفتح والغلبة بل بمعنى سعة الأفق والقدرة على الاستيعاب والتجاوز، استيعاب الثقافات المحلية وتجاوز الذات في سبيل العالمية. وقد كان الموالي، في العصور الإسلامية الأولى، آخر كامناً في الامة؛ وكان دمجهم في جسم الأمة تعبيراً عن كونية المشروع، وما كان الخيار بين استئثار العرب بالسلطة من ناحية أو دمج الموالي من ناحية أخرى خياراً لاواعياً، بل جاء الأمر حصيلة صراعٍ فكريٍ طويل دام خلال عهد الأمويين وأدى إلى الإطاحة بهم.
يستخدم الغربيون مقولة صراع، أو حوار الحضارات، لأغراض سياسية، فهم يتعاطون بالصراع بوجهيه الثقافي والسياسي في آن معاً. أما عندنا فإن التعاطي يقتصر على الوجه الثقافي، إذ لم يتبق من السياسة غير أشلائها مع تزايد ضعف الأمة، وتراجُع وعي نُخَبها السياسية والثقافية. إن التراجع عن السياسة، بمعنى السلوك على أساس حساب المصلحة وموازين القوى، واصطناع التسويات ومراكمتها، إلى سياسات الهوية حيث للرموز أولوية على المصالح وحيث الحق هو دافع التصرف لا الأهداف الممكنة التحقيق، وحيث صحة الموقف (سلاح الموقف) تتفوق على فن الممكن، هذا التراجع عن السياسة يخلي المجال للصراع (أو الحوار) الحضاري. وتستغل مقولة "صراع الحضارات" هذا الهاجس الديني عندنا، فنستجيب لها بلهفة، وننتهي إلى أن نكون نحن من يشن صراع الحضارات في حين يمارس غيرنا صراع السياسات ونبقى نحن نسعى وراء المستحيل في حين يمارس غيرُنا فنَّ الممكن.
وربما وجب التمييز بين الصراع (أو الحوار) الحضاري على المدى الطويل وعلى المدى القصير. فعلى المدى الطويل تتواصل الحضارات وتتفاعل، بل انها ذاتها تتكوّن وتتطوّر بفعل التواصل فيما بينها. وإذا كان علماء التاريخ والآثار وتاريخ العلوم والاكتشافات ما يزالون يتناقشون حول تشابه الحضارات في أفكارها الدينية وفي منجزاتها العلمية والتقنية، وهل حصل الأمر بالانتقال من مكان إلى آخر (مما يستدعي الاعتراف بأصلٍ واحدٍ لها) أو أن تطورها في مناطق وحضارات مختلفة جاء مستقلاً بعضُهُ عن بعض (مما يستدعي الاعتراف بتعدد الأصول). وعلى كل حال، وجد بعض كبار الباحثين في تاريخ الأديان ضرورةً للاستنتاج بأن وحدة الحضارة الإنسانية هي الأساس رغم التعدد (سيمفونية واحدة بألحان متعددة كما يقول جوزف كامبل). فما من دين اعتبر نفسه متميزاً (وكل الأديان تُثبِتُ ذلك لنفسها) إلا ووجدنا عناصر كثيرةً من عباداته عند أديانٍ أخرى أو في إثنياتٍ سابقةٍ له. فالتوحيد المطلق، والتنزيه عن الصفات، والتشبيه بكائنات حيّة أحياناً، والأم العذراء، والثالوث الالهي، والتطهر بالماء، والركوع؛ كلها دلائل على التواصل البشري منذ التاريخ السحيق. وبعض هذا التواصل محفوظ في حفريات أثرية، كأن يتمّ اكتشافُ مدينتين سومريتين في اقليم السند من شبه القارة الهندية؛ وبعضه يستدل عليه من القرائن كالاستنتاج أنّ القارّةَ الأميركية أعيدَ اكتشافُها بضع مرات قبل كولومبوس، عن طريق الجزر البولينيزية أو عبر مضيق بيرينغ الذي هاجر سكان الشمال عبره إلى ألاسكا، أو من شمال اوروبا (الفايكنغ).
أما على المدى القصير فإنّ الغالبَ على تَوَاصُل الحضارات هو الصراع. ذلك لأنّ الغالب حينذاك هو الإرادة، إرادة الحكام والمغامرينَ والمهاجرينَ الذين تعني الرموز الحضارية ومفاهيمها بالنسبة لهم أقل بكثير مما يعنيه تحقيق فوائد مباشرة أو مكاسب يحققونها على حساب الغير. بل هم يضحون أحياناً بقيمهم الحضارية والأخلاقية، وحتى بالرموز الدينية، من أجل المصالح المباشرة.
يعني هذا الكلام أنّ الطابع الغالب على المدى الطويل هو الحضاري، وعلى المدى القصير هو السياسي، لكنه لا يُلغي إمكانيةَ حدوثِ حوارٍ حضاري أو ديني بقرار سياسي، فهناك حركات سلمية يزداد انتشارها على مدى العالم، وهي تستحق التقدير والتشجيع. لكن ما يخشى منه هو أن تتحول الحضارات والأديان، على أيدي هولاء وغيرهم إلى جواهر ثابتة أو أن يزعم هؤلاء لأنفسهم الحقّ بتمثيل مجتمعاتهم لأنهم يختصرون الحضارات والأديان التي يمثلونها في بعض الجواهر الثابتة، فيكون ذلك عائقاً في وجه تطور البحث الموضوعي العلمي بدل أن يكون دافعاً له. ومن يجول في المكتبات أو يقرأ الصحف والمجلات كثيراً ما يشاهد عناوين كتب ومقالات تقول "الاسلام كذا وكذا..." أو "يقول الاسلام كذا وكذا..." والحقيقة أنّ الاسلامَ كغيره من الأديان أو المجالات- الحضارات يتنوع ويتعدد بحيث يستحيل حصره في مقولات أو جواهر مهما كان عددها، وأنّ المسلمين لا الإسلام هم من يقولون كذا وكذا.. وأنّ الاسلام لا يقول كذا وكذا.. إلا لمن يريد أن يقوّله ذلك. والبحث في شأن المسلمين يضطرنا إلى البحث التاريخي والاجتماعي وإلى اعتماد المنهج العلمي وإلى الاعتراف بالتعدد والتنوع في اطار المجال الحضاري الديني نفسه؛ أما البحث في شأن الاسلام دون المسلمين فهو يقود إلى مصادرة الاسلام لصالح مقولات في ذهن البعض، وإلى اختصاره في مفاهيم يعتبرها اصحابها معبِّرةً عن جوهره، بينما هي لا تعبر إلا عن رغبات معتنقيها، ومتى جنحت هذه المفاهيم إلى التطرف السياسي يحدث التمييز بين الاسلام والمسلمين، وربما جاء المسلمون غير مطابقين للصورة المرسومة سلفاً عن الاسلام، فيتم التنكر لهم. وهذا ما حدث فعلاً على يد بعض الأصوليين المسلمين الذين قالوا بوجود الإسلام وانكروا وجود المسلمين (على اعتبار أنهم في عصر جاهلية)، لقد أنكروا في الحقيقة وجود الأمة كتاريخ وسيرورة، واحتفظوا ببعض الأفكار التي ما زالت مختلف أطراف الإسلام السياسي تعتمد عليها. وإذا كان الامر للحكم على النتائج، فإنّ النتائجَ الحاليةَ سلسلةٌ من الحروب الأهلية والمواجهات مع العالم الخارجي دون اعداد العدة إلا التأكيد على بعض المسلّمات، والغضب الجامح. فانقلبت الصورة إلى استنزاف للأمة طويل المدى.
التفوق لمن؟
ثم جاءنا كلام برلسكوني عن تفوق الحضارة الغربية بقيمها المسيحية، فقامت الدنيا ولم تقعد، وطلب أمين عام الجامعة العربية اعتذاراً، وإلاّ.... إنّ هذه المقولة البشعة لا تأخذ بالاعتبار أنّ المسيحية وقيمها جاءت من الشرق، وأنّ التفوقَ لم يكن دائماً حليفَها. ففي مراحل من التاريخ كان التفوق عند المسلمين. لكنّ المشكلة الأكبر في الردود عليها والتي لا تأخذ بالاعتبار أيضاً أنّ كلَّ أمةٍ تعتبر أنها هي أفضل الأمم عِرْقاً وخُلقاً، كما لا تأخذ بالاعتبار أنّ هناك الآن تفوقاً غربياً يجب الاعتراف به. والتفوق ليس مسألة قيم بمقدار ما يتعلق بانجازاتٍ تقودُ إليها ظروفٌ تاريخية تجتمعُ في وقتٍ من الأوقات لتجزّر الطاقات في سياقات سياسية وعسكرية معينة. ومثلما قال بعض الدارسين إنّ التقدم والرأسمالية يعودان الى سمات "بروتستانتية" في اطار الحضارة الغربية، قال آخرون إنّ الامر نفسَهُ كان يمكن أن يقال عن سمات كاثوليكية ثقافية، في اطار تلك الحضارة. ومثلما يقول باحثون، وهذا هو الرأي الشائع، أنّ البروتستانتية "الطهرانية" هي في أساس الانجازات التي أحرزتها أميركا الشمالية خاصةً الولايات المتحدة: يقول باحثون جديون إنّ الأساس هو في انتشار الكاثوليكية قبل البروتستانتية. والاستنتاجُ الوحيدُ الأكيدُ هو أنّ الخلفية الحضارية أو الثقافية لا يمكن أن تفسِّرَ الفرقَ بين التقدم والتأخر عند أي شعب أو مجتمع، بل هي السياسة في سياقات تاريخية لا يمكن التنبؤ بها، ولا يمكن الحديث عنها، قبل أن تحدُثَ لأنها شديدةُ التعقيد.
لقد انشغل بالُنا، على مدى العقود الماضية، بالامبريالية والعولمة والمؤامرة الدولية أكثر مما انشغل بموضوع المؤامرة وهو هذه "النحن" المشتتة، وانشغل بالُنا بصراع الحضارات وحوارها أكثر مما انشغل بدراسة تجربتنا التاريخية وفهمها. والآن ينشغلُ بالُنا بتفوق الغرب أكثر مما ينشغلُ بتأخرنا وتشتتنا وتمزقنا، الخ... لقد انشغل هذا البال "بالآخر" أكثر مما "بالنحن"، ولأننا لم نفهم النحن، لم نستطع فَهْمَ الآخر الموهوم.
إنّ الخطورةَ في الردود على برلسكوني وأمثاله (فكأن ما قاله ليس هو الضمير المستتر عند الغرب، وكأنه لم يكن كذلك على مدى العصور)، هو أنه يشغَلُنَا عن أنفسِنا وعن اقتراح مفاهيمَ جديدةٍ للعمل والسلوك في وقتٍ يتعرض العالمُ فيه لتحولٍ كبيرٍ بعد 11 أيلول. فأن يقاتل بعضُ العرب في أفغانسْتان لا في فلسطين، وأن ينشأ نظامٌ يزعُمُ أنه إسلامي ويمنع البنات من التعليم، هو تعبيرٌ عن أزمةٍ في الوعي والعمل، وفي الوعي قبل العمل. والتفجيراتُ التي حدثت في الولايات المتحدة في 11 أيلول هي تصدير للأزمة. وأن لا نستطيعَ تصديرَ الاّ الأزمات هو مؤشرٌ على الانهيار. وأن لا تجد الجامعة العربية شيئاً تفعله في هذا الوقت العصيب غير الرد على مقولةٍ حضاريةٍ يعرف الجميع أنّ صاحبها يضمرها حتى ولو لم يقلها، هو تعبيرٌ عن غياب إرادة الفعل لحلّ الأزمة أو لتفادي الانهيار.
إنّ ما يحتاجُ اليه العربُ اليوم، كما في الأمس وكما في الغد، هو آليةٌ للعمل العربي المشترك من خلال الاطار الذي توفره الجامعة العربية، والعمل العربي المشترك حَدُّهُ الأدنى التنسيق بين الدول العربية في الشأن الاقتصادي، وفي شأن التعاطي مع العدو الإسرائيلي، كما هو أيضاً تنسيق العلاقة بين العرب والعالم (بما فيه بقية العالم الاسلامي). إنها بالاختصار تحديد موقع العرب من أنفسهم، وهذه العلاقة هي التي يجدر أن تحدد علاقتهم بالعالم (قبل الوقوع في أفخاخ المقولات من الخارج، وقبل الاستجابة لأهواء الغرائز عند الذين لم يستطيعوا تجاوز المألوف).
لا يستطيعُ العرب ولا المسلمون البقاءَ في "غضبهم" وكأنّ العالَمَ لا يعنيهم، أو كأن المحتوم عليهم أن يخوضوا مواجهةً معه. وقد أثبتت نظريات التنمية المستقلة عدم صحتها، وأدت الى تراجع اقتصادي كبير عند الدول التي طبقتها بأسلوب انعزالي عن العالم، هذا في حين استطاعت الدول المنخرطة في العالم إحراز تقدم اقتصادي كبير استخدمته قاعدة لتحررها السياسي، وبما قد يبدو من مظاهر التبعية السياسية. وقبل ذلك وبعده استطاعت أممٌ تختلف جذرياً عن الغرب في حضارته، أن تتحرر من هيمنته، وأن تقيم تواصُلاً معه من أجل التقدم، والمشاركة في مصائر العالم.
ولا يستطيع العرب والمسلمون اعتبار أن ما جرى في 11 ايلول لا يعنيهم، إنْ بحجة أنّ جماعة بن لادن هم من تبنتهم السياسة الاميركية سابقاً في وجه السوفيات، أو بحجة أن السياسة الاميركية أخطأت على مدى العقود السابقة تجاه العرب في فلسطين، أو بحجة أن الفاعلين أفراد معزولون عن مجتمعاتهم، أو أنهم قد لا يكونون عرباً ولا مسلمين. قد يكون هذا كله صحيحاً. ومع ذلك فما حدث هناك يعنينا، ليس فقط لأن الضحايا مدنيون أبرياء، بل لأن النظام العالمي يعنينا، وكل تغيرٍ فيه سيؤثر فينا.
إننا بحاجة إلى أفكار جديدة والى ابتداع مفاهيم تتيح لنا العمل كجزء من هذا العالم الذي ينبغي أن نشارك فيه مشاركةً فعالة، كي لا نبقى الموضوع المنفعل بمقولاتِ طروحاتِ من لا تهمهم مصلحةُ هذه الأمة.
لقد كنا حتى الآن موضوعاً منفعلاً سلبياً، يلهث وراء الحدث، نتلقى الضربات، ونغرق في الهزائم، فلا نفهم كيف ولماذا؟ فنلجأ للتبريرات ولنظريات التآمر الخارجي علينا. وقد آن الأوان أن تحزم نخبنا الثقافية والسياسية أمرها لتغيير هذه الحالة، وأن نشترك في ذلك جميع المؤسسات العربية والاسلامية، وفي مقدمتها الجامعة العربية. فقد أصبح العقل المستريح خطراً علينا.
إن ما نحتاجه الآن ليس أن نتلهى كثيراً بمقولات العولمة والحوار والصراع الخ، بل عمل عربي مشترك للخروج من الهزيمة ولكي نستطيع أن نحقق ما حققه الغرب من تفوق. إن الغرب حقاً يتفوق علينا وهذا التفوق ليس مسألة تقنية محضه بل هو تفوق مادي وروحي أيضاً الموضوع الأساس هو كيف لا نبقى موضوعاً منفصلاً سلبياً نسير وراء أو نلهث وراء مقولات يطلع بها دارسون غربيون من مراكز للداراسات الاستراتيجية وكيف نستطيع أن نبدع مفاهيم جديدة لمرحلة جديدة تلبي حاجاتنا الفعلية.