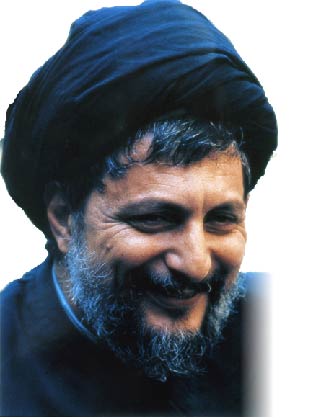مؤتمر "كلمة سواء" السنوي الرابع: "الهوية الثقافية"
(كلمات الجلسة الثالثة)
تشن آلة الهيمنة الإمبريالية والصهيونية حرباً شعواء ضد الأمة العربية، لكي تبقى في إسار التخلف والتبعية والتجزئة، وتنصاع من ثم لمتطلبات "السلام الصهيوني". وفي هذا السياق يقوم التطبيع بدوره البارز في مواجهة الثقافة العربية والإسلامية.. فكيف تقف هذه الثقافة في مواجهة التطبيع؟
لا غلو أن نقتنع - ابتداء - أن الميزة القاتلة في الصراع العربي- الصهيوني، في حقيقته النهائية، أن شرط الاعتراف بالآخر يعني تلقائياً إنكار الذات نهائياً. وهذه الميزة نادرة في تاريخ الصراعات البشرية، وهي كفيلة- في ضوء شواهد متواترة في تاريخنا- بصيانة إرادة الأمة وشحنها بالقدرات اللازمة لخوض صراع الإرادات والهويات في المنطقة· إن "الدولة الإسرائيلية" ستبقى اختبارنا، بالنظر الى الارتباط العضوي بين النهضة العربية والإسلامية وتصفية الكيان الاستيطاني الصهيوني في فلسطين. وهذا المبدأ الشرطي مفروض علينا وليس خياراً" بل يمكن القول إن شرط الهوية يتأسس على إلغاء تلك "الهوية المعادية"، ليس كحالة كيانية ودولة فحسب، بل كحالة عربية وإسلامية مستشرية أيضاً. بهذا المعنى فإن "اسرائيل" تقع في نطاق الذات، أكثر مما تقع في نطاق الآخر، مع أنَّها تمثل هذا "الآخر" من ناحيتي الدور والوظيفة، وهنا تماماً يأخذ الصراع والتطبيع بعدهما الحاسم.
ولذلك فإن الذين يتخوفون من التطبيع، ويدعون أحياناً الى الانغلاق، هم أْظلم المستهترين بأصالة الثقافة العربية والإسلامية وقدرتها وقوتها وتفوقها بما لا يقاس على "الثقافة الصهيونية"، تلك الثقافة التي لا تملك سوى استخدام منظومة بالية من الأساطير التاريخية والدينية، فضلاً عن استعارة الخطاب الثقافي الغربي. وهذا الخطاب الأخيرة، إذا ما أحسنا استملاكه وتوظيفه لن يبقى لدولة "إسرائيل" أي تبرير بالاختلاف، أي بالوجود.
لقد حققت آلة الهيمنة الإمبريالية والصهيونية الكثير من الانتصارات في المعارك السياسية والعسكرية والاقتصادية، وهي تخوض الآن أعنف المعارك وأشرسها لحسم "المعركة الثقافية" لكي تدك آخر حصون المقاومة، وتسقط هذا "السور العظيم" الذي يحمي الأمة ويصون هويتها ووجودها على المدى الطويل. لأن كل أمة تتجسد في هوية، والهوية عبارة عن ثقافة قبل أي شيء آخر.. وهذا هو أصل المسألة، ومصدر الخطورة في معركة الوعي أو معركة العقل.
ومن أجل تحديد أبعاد هذه "المعركة"، وميادينها وأسلحتها، ستتفرع هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: أولها - يعالج أصل التطبيع لتوصيف طبيعته ومضمونه وآليته، نظرياً وتطبيقياً، وثـانيها - ينصرف إلى تأصيل الصراع الأساسي في المنطقة لتعيين الأطراف الحقيقية في الجبهة المعادية، ومن ثم وضع "المعركة" في إطارها الشامل والصحيح، وثالثها - يحدد منهج المواجهة ووسائلها وآلياتها، فضلاً عن محدداتها وضوابطها.
أولاً - أصل التطبيع
ينصرف مفهوم التطبيع إلى عودة الأمر إلى مقتضيات وضعه الطبيعي. وهو مفهوم مستقر في القانون الدولي يعني العودة إلى الحال الطبيعية في العلاقات بين الدول. ذلك أن القانون بفروعه ومجالاته كافة لا يلزم أشخاصه بالتعامل جبراً وقسراً، وكل ما يعرفه أنه يحظر لغة الاعتداء؛ فالأصل في الأشياء الإباحة والترخيص، والقول بغير ذلك - على صعيد القانون الدولي - يعني إلزام كل دولة بأن تتعامل مع الدول كافة بطريقة محددة، وهذا أمر يجافي المنطق وطبائع الأشياء، إلا في حال التعاهد دون قيد أو شرط في لغة الانتصار المطلق، أي حال الاستسلام. وهذا هو عين التطبيع في إطار المشروع الإمبريالي الصهيوني للهيمنة، الذي يتنافى مع كل ما هو طبيعي في العلاقات بين الدول.
ويمكن القول ان عملية التطبيع - من حيث الجوهر وإن لم يكن قد تم تداول نفس المفهوم بعد - كانت تشكل جزءاً لا يتجزأ من العملية الاستعمارية. فمن المعلوم أن حركة الاستعمار - بصفة عامة، والاستعمار الاستيطاني الأوروبي - بصفة خاصة، قد بنيت على "افتراضات عنصرية" معينة، تنطلق من مبدأ التفوق الإثني الثقافي للحضارة الغربية والرجل الأبيض. وكانت هذه الافتراضات بدورها، هي التي أضفت الشرعية، في نظر المستعمرين، على إدخال "عنصر أجنبي" من أهل الغرب على قارات "العالم الآخر". وبمعنى آخر كان افتراض التفوق يصاحب الاستعمار ويشكل جزءاً عضوياً منه، وكان دور عملية التطبيع أن تضفي الشرعية على هذا الافتراض، أي على الاستعمار، لدى أصحاب الأراضي الأصليين على أساس أن "رسالة الرجل الأبيض" المزعومة كانت تستهدف ملء الفجوة الحضارية بين أهل الغرب وأهالي هذه الأراضي. لقد بدأت حركة الاستعمار بلغة "حق الرجل الأبيض.. وواجبه" في نقل الحضارة إلى السكان الوطنيين الأقل تحضراً، وذلك باحتلال أقاليمهم احتلالاً مادياً، ولو كان ثمن ذلك "القضاء على السكان الأصليين".. ولا شك أن تلك طريقة غريبة لإدخال الحضارة إلى شعب عن طريق إبادته! وكان المطلوب من جهاز التطبيع أن يجعل ذلك "الحق.. الواجب" مسوغاً.
فما هي طبيعة هذا الجهاز المفاهيمي: التطبيع؟.. ما المقصود منه في سياق الصراع العربي - الصهيوني وعمليات التسوية الجارية؟.. وما هي آليته؟
إن من المتفق عليه، فقهاً وقضاءً، أن مهمة الدولة تتحدد في حماية النظام العام.. لا خلقه. وهذا النظام العام وليد ضمير الأمة ووجدانها، وهو ما استقر في إرادتها ووعيها من نظم قيم ومعتقدات، ومن آمال وتطلعات، ومن ثم فهي فكرة دائبة التطور والارتقاء. والتطبيع من حيث هو فعل إرادي يحول دون النمو والارتقاء التلقائيين للأمة، باعتباره يضع ما لا حصر له من القيود على مسارب السلوك الذاتي، كما أنه يحول دون قيام المجتمع المدني كمجتمع مفتوح وحركي ومحكوم بنواميس الحياة وسنن الطبيعة، وهو بهذه المثابة يتعارض مع فكرة المواطنة كوصف موضوعي عقلي عام ومجرد.
وبيان ذلك أن الدولة لا يجوز أن تلغي الفرد، ولا يجوز أن تمتد بسلطانها إلى تلافيف الضمير وحركة العقل، وقديماً قيل: لقد أراد "روبسبيير" أن يقيم الفضيلة فأقام الرعب. إن الدولة تعكس نشاط الأمة وروحها، وتعبر عن قيمها وتطلعاتها، وهذه هي الشرعية الحضارية التي تترسمها الشرعية القانونية· وبهذا المعنى فإن الحكومة ليست إلا جهازاً في خدمة الأمة باعتبار أنها هي التي تملك الصفات الأساسية التي يمتاز بها الشعب. وكل ما تعمله الحكومة ينبغي أن يتمثل في صيانة هذه الخصائص، لا الادعاء بتملكها. ومن ثم تظل ثقافة الشعب فوق الحكومة، وإن كانت السلطة تحاول أن تكيف هذه الثقافة على هواها فتشوهها، وتحرف معناها. ذلك أن ثقافة الشعب المعبرة عن روح الجماعة تظل في انطلاقها وحريتها إلى أن يفسدها حكم المستبدين أو تحكم المتزمتين. وقد تتعرض الجماعة لخطر شديد، ولكن الخطر الأشد أن تغتصب السلطة ثقافة الأمة وتسيطر على حياة الجماعة، وتكتم أنفاس الناس، وتقيد حريتهم في أن يختلفوا بمعتقداتهم وآرائهم وطرق تفكيرهم وأساليب حياتهم.
فهل يراعي التطبيع الجاري هذه الأصول، أم أنه سيلوي حركة المجتمع، ويتطاول إلى التحديد المسبق لمساراته، فيتحول من ثم إلى تطويع؟
إذا كان التعريف القانوني المنضبط لمفهوم التطبيع يقوم على "العودة إلى العلاقات الطبيعية بين الدول" فإن المروجين له في حالنا قفزوا فوق حقيقة تاريخية وهي أن دولة "إسرائيل" لم تكن موجودة أصلاً قبل خمسين سنة حتى تدعو الدول المجاورة إلى إعادة العلاقات معها إلى طبيعتها! ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنهم أعطوا "العلاقات الطبيعية" هذه مفاعيل محددة تؤدي في النهاية إلى تكريس الهيمنة الكاملة للدولة الجديدة على مجمل دول المنطقة، وهي هيمنة لا علاقة لها بحال "العلاقات الطبيعية"، بل إنها على العكس من ذلك تنال من حقوق طبيعية مستقرة للدول ولمجتمعاتها وأفرادها، لأنها تفرض عليهم شروطاً على المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية والإعلامية والثقافية، لا نظير لها في أية علاقات طبيعية، بل وحتى علاقات جيدة ومتميزة، بين الدول في العالم، بما في ذلك علاقة "إسرائيل" ذاتها بحليفها الأكبر: الولايات المتحدة! وفي الحقيقة، ينصرف التطبيع، في المفهوم الصهيوني، إلى إقامة علاقة مخالفة للطبيعة مع الدول العربية!
فقد فرضت مقتضيات التطبيع على مصر - مثلاً - أن تعادي "عوالم طبيعية" تنتمي إليها انتماء أصيلاً راسخاً؛ وهي الأمة العربية والعالم الإسلامي وعالم عدم الانحياز، فور التوقيع على "معاهدة السلام"! وحسب هذا التطبيع كان على الفلسطينيين أن يعدلوا، وربما يلغوا من حيث الجوهر، ميثاقهم الوطني الذي أجمعوا عليه لعشرات السنين، وناضلوا من أجل ثوابته على امتداد قرن كامل، من دون أن يكلف هذا التطبيع نفسه عناء مطالبة "إسرائيل" بإجراء التغييرات الضرورية في إيديولوجيتها وقوانينها وممارساتها لكي تلاقي التعديل الفلسطيني.
وفي ظل هذا التطبيع يصبح من واجب الدول العربية التي توقع على "معاهدات سلام" مع "إسرائيل -كما حدث في مصر والاردن وفلسطين- إعادة النظر في مناهجها التربوية، وإعادة كتابة التاريخ نفسه، وحتى كتابة الجغرافيالأجيالها الجديدة - لأن المقررات الجغرافية التي تدرسها السلطة الفلسطينية الآن تقوم على وجود تاريخي اسمه فلسطين جنبا الى جنب مع وجود تاريخي آخر بين قوسين اسمه اسرائيل- بل لقد وصل الأمر إلى درجة المطالبة بحذف آيات من القرآن الكريم بادعاء أنها تسيء إلى اليهود و"إسرائيل"، كما فعلت سلطات الاحتلال مع المناهج التربوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حيث ألغت كلمة "الجهاد" - مثلاً - حيثما وردت في آيات قرآنية.
ويوضح ما تقدم أن إخضاع الثقافة العربية والإسلامية لمنطق التطبيع بات أحد أبرز عناصر مشروع الهيمنة الإمبريالية والصهيونية، على أساس أن العمق الثقافي والحضاري لأمتنا، المستند الى مخزون روحي ضخم وإلى رسالة إنسانية خالدة، يبقى العنصر الأقوى في المقاومة الذاتية لهذه الأمة على مدى السنوات. فالثروات قد تتبدد، والمعادلات السياسية قد تتغير، وموازين القوى لا يمكن أن تبقى ثابتة في عالم متغير، أما ما يبقى في الأمم فهو ثقافاتها وحضاراتها، فإذا زالت هذه أو وهنت، زالت الأمم نفسها أو وهنت، لأنها فقدت عنصر هويتها ووحدتها وتماسكها الأقوى.
ومن هنا بات "التطبيع الثقافي" في نظر الكيان الصهيوني هو الأهم، فعبره يمكن النفاذ إلى كل مجال آخر، وفي غيابه تمكن إعادة بناء المقاومة الذاتية للأمة. مع ملاحظة أن ما يميز مشروع "التطبيع الثقافي"، عن غيره من مشروعات التطبيع السياسي والاقتصادي، أنه لا يحمل مشروع إحلال "هيمنة ثقافية صهيونية" على الحياة الثقافية العربية والإسلامية، كما هو الأمر في المشروعات الأخرى، لعراقة الهوية الثقافية والحضارية لأمتنا - من ناحية، ولعدم وجود "ثقافة صهيونية" واحدة بالأساس بالنظر إلى طبيعة الكيان الاستيطاني الصهيوني - من ناحية أخرى.. بل هو في الحقيقة مشروع تدمير وتفكيك المقومات الذاتية للثقافة والحضارة العربية والإسلامية، إنه تدمير للأواصر وتفكيك لها على المستويات كلها؛ تفكيك بين الأقطار وداخل كل قطر، بين الأديان وداخل كل دين، بين المذاهب وداخل كل مذهب، بين الأقوام التي تسكن الوطن العربي وداخل كل قوم، بل هو تفكيك للتواصل بين الماضي والحاضر، كما للتفاعل بين الأجيال داخل الحاضر ذاته... ضرباً للمستقبل كله. إنه باختصار تجريد الأمة من ثقافتها لكي تصبح شبيهة بثقافة الكيان القائم في قلبها، أي من دون ثقافة أصيلة موحدة وراسخة. وهكذا يفضح البعد الثقافي لعملية التطبيع كل المفهوم الرائج لمفهوم التطبيع ذاته؛ إنه ليس مفهوماً "سلمياً"، يسعى إلى "عودة الأمور إلى طبيعتها"، بل هو بكل وضوح مفهوم عدواني عنصري، يلقي الأضواء على الطبيعة الاستعمارية لكل جوانب عملية التطبيع الأخرى. فضلاً عن أن الدولة الصهيونية تحاول من خلال التطبيع أن تحصل على ما لم تحصل عليه من المكاسب بالقوة والحرب، ولذلك يمكن تعريف هذا التطبيع بأنه غزو اقتصادي وتجاري وثقافي. والأكثر فداحة، أنها تريد من خلال التطبيع الحصول على كل شيء من دون أن تدفع شيئاً في المقابل، بينما هي سترد إلى صاحب الحق بعضاً من حقوقه المغتصبة!
ومن ناحية أخرى، تكشف "معاهدات السلام" التي تم التوقيع عليها بين "إسرائيل" وكل من مصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، عن الهوة السحيقة بين نصوص التطبيع - من ناحية، والمعنى الصحيح لكل من "العلاقات الطبيعية" و"السلام" بين الدول - من ناحية أخرى. فقد تضمنت هذه المعاهدات نصوصاً تلزم كل طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية ضد العداء للطرف الآخر، وهو نص لا نظير له في أية معاهدة بين دولتين في العالم، ويعتبر اعتداءً صريحاً وصارخاً على حريات وحقوق المواطنين العرب في تلك الأقطار وعل منظماتهم الشعبية، إذ بمقتضى ذلك يقع تحت طائلة العقاب كل من يعبر عن رفض للمعاهدة، سواء بالمشاركة في ندوة أو بالكتابة! كذلك تنص تلك المعاهدات على تقييد حرية الرأي بشكل لا مثيل له في العالم، ويحظر على صحف المعارضة الدعاية ضد العدو من قبل أي تنظيم أو فرد.
وفضلاً عن ذلك فإن تلك المعاهدات لم تكتف بتقنين منع الاعتداء على "إسرائيل" بل تجاوزت إطار القانون إلى إطار السياسة لتتغلغل إلى تلافيف الوجدان وتتدخل في مسائل من متعلقات الرأي والفكر والثقافة. ومن الجدير بالذكر هنا أن قرار مجلس الأمن رقم (242) عام 1967- ورغم الانتصار الإسرائيلي الضخم - ينص فقط على "إنهاء حال الحرب"، ولم يتطرق إلى إلزام كل طرف بالتعامل مع الآخر. بل إن "إسرائيل" نفسها لم تطمع في تلك الآونة في أكثر من حال السلم وعدم الاعتداء، دون أن يعني ذلك حال من التطبيع، التي هي حال متقدمة على عدم الاعتداء. وحقيقة الأمر أن مجلس الأمن كان منسجماً في هذا القرار مع اختصاصه القانوني الذي لا يتعدى منع الاعتداء وحفظ السلم الدولي، أما التطبيع فهو مفهوم اجتماعي وثقافي واقتصادي وسياسي يتجاوز أفق القانون.
ومن المفارقات الصارخة في هذا السياق، أن يحدث هذا "الاستسلام العربي الرسمي" لمطلب التطبيع - الذي لم يتضمنه قرار مجلس الأمن، رغم أنه صدر في أعقاب هزيمة ساحقة - بعد الانتصار العربي الكبير في حرب 1973!
ثانياً - الصراع الأساسي
يتمثل الصراع الأساسي الذي تشهده المنطقة في محاولات القوى الاستعمارية المتغيرة فرض وترسيخ التبعية والتخلف والتجزئة على المنطقة العربية - من ناحية، وزرع المشروع الصهيوني للمساعدة على تكريس هذه الأهداف - من جهة أخرى. وإذا كان لهذا الصراع جذوره التاريخية البعيدة، فإن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى كانت مميزة نوعياً، لأنَّها شهدت تبلور أصول الصراعات الحالية، التي ترتبت على "التسوية التاريخية" التي فرضها "الغرب" على المنطقة، والتي تتمثل، بصفة خاصة، في "وعد بلفور"، أي "المشروع الصهيوني" - من ناحية، و"ظاهرة التجزئة"، أي "المشروع القطري"- من ناحية أخرى، لأن كليهما نشأ بقرار غربي، وفي الفترة نفسها تقريباً، ولتحقيق نفس الأهداف، والتي تتلخص في ضرب "القومية العربية"، بالنظر الى أنها تشكل "نقيضاً" جذرياً لهما، وللهيمنة الغربية معاً.
ومؤدى ذلك أن الصراع ضد قوى الهيمنة المعاصرة - بشكل عام، وضد الهيمنة الأمريكية - بشكل خاص، سيستمر حتى بفرض التوصل إلى "تسوية شاملة" للصراع "العربي-الإسرائيلي"، بالمعنى المتداول الآن، وأن الدور الصهيوني سيستمر أيضاً في خدمة أهداف الولايات المتحدة في المنطقة إلى جانب تحقيق مصالحه الخاصة. ولذلك ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن المشروع الصهيوني ظهر أساساً قبل حفر قناة السويس، وتبلور قبل وجود الاتحاد السوفييتي، ووضع قبل اكتشاف النفط في المنطقة العربية، وتجسد قبل أن تحصل البلدان العربية الموجودة راهناً على استقلالها كافة .. مما يؤكد أنه قد تأسس لحساب المصالح الاستعمارية الكبرى، وأنه ارتبط بها منذ البداية، حتى أصبحت الرابطة بينهما الآن رابطة عضوية.
ولا شك أن الصراع العربي - الصهيوني هو الصراع المباشر الذي قد يكون أكثر خطراً في الأجل المتوسط، لأن الطرف الصهيوني يسعى إلى فرض هيمنته على الوطن العربي، فضلاً عن خلق وقائع جديدة كل يوم على الأرض، على حساب الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني في وجوده وكيانه وفي وطنه، استناداً إلى الانتصار العام الذي حققته الحركة الصهيونية على مدار القرن الماضي - من ناحية، وحقائق القوة الشاملة المتاحة لطرفي "الصراع" - من ناحية ثانية، وطبيعة الالتزام الأمريكي الرسمي بأمن "إسرائيل" ، بكل معانيه وأبعاده، في إطار الدور الأمريكي وتوجهاته في المنطقة وفي العالم - من ناحية ثالثة. مع التأكيد على أن المشروع الصهيوني له أهدافه ومصالحه الذاتية، وأنه بدوره أصبح قادراً على التأثير على مراكز الهيمنة العالمية، وليس مجرد "أداة" لها.
ومعنى ذلك أن أية تسوية مهما كان شكلها ونطاقها لن تحل الصراع ولن تنهيه، طالما استمر "الوجود الاستيطاني الصهيوني" في فلسطين، بنوازعه العنصرية والعدوانية والتوسعية، وبارتباطه العضوي بالقوى الاستعمارية. وعلى أساس أن الصراع ضد الصهيونية و"إسرائيل" ينتمي إلى نمط الصراعات التاريخية - الاجتماعية الممتدة، فهو صراع حضاري طويل الأمد، ناجم عن استهداف قوى هيمنة غربية - والحركة الصهيونية جزء منها - فلسطين وما حولها في الدائرة العربية، باستعمار استيطاني إحلالي عنصري صهيوني، جنباً إلى جنب مع وسائل الاستغلال والسيطرة الأخرى.
ومن ثم كان يتوجب على العرب، في زمن المفاوضات، التمسك بتعريف للصهيونية لا يكون خاضعاً للمساومة. إنها حركة عدوان على العرب احتلت فلسطين من أجل امتلاك موقع للهيمنة على العرب جميعاً.. وقد نجحت من خلال الإرتباط العضوي مع القوى الاستعمارية الطامحة إلى إخضاع العرب. تغيرت القوى الداعمة لها، والأهداف التكتيكية لهذا الدعم، ولكن "الثوابت" استمرت كما هي : حراسة التجزئة العربية، والتبعية، والتخلف، والتصدي لمشاريع الاستقلال الوطني والتوجهات الوحدوية العربية.
وفي سياق هذا الصراع الكبير، وطوال أكثر من قرن، كانت "ثقافة النهضة" في الوطن العربي تصارع "ثقافة الإمبريالية"، التي دعمت التخلف والتبعية والتجزئة وزرعت الدولة العبرية لحراسة هذه الغايات الاستعمارية، سواء من ناحية الوقائع المادية أو من ناحية الوعي الاجتماعي. وفي خضم هذا الصراع المرير والمديد اندمجت "ثقافة الصهيونية" وبخاصة مع قيام دولة "إسرائيل"، في صلب "ثقافة الإمبريالية"، بحكم وحدة الغايات الاستراتيجية ووحدة المنطلقات الفكرية.
وإذا كان الاستعمار التقليدي يقوم على الاحتلال، أي على القوة، فهذا التحالف الاستعماري الجديد يحتاج إلى الثقافة. ومعنى ذلك أن المشكلة الأساسية مع التطبيع المزعوم تتمثل في المشروع الثقافي التطبيعي الخطير الذي ستضخه قوى الهيمنة الإمبريالية والصهيونية لمحاصرة الأمة وطمس هويتها وثقافتها، وهزيمتها نفسياً، لأن المستعمر بهذه الهزيمة النفسية يدك آخر معقل من معاقل الوجود العربي والإسلامي. وبمعنى أوضح، فإن الفاعل الاقتصادي والسياسي سيؤدي دوره في هذا التأسيس الجديد، ولكن الفاعل الثقافي سيكون له التأثير النهائي.
وتجدر الملاحظة أن هذه الحرب الثقافية ليست من ابتداع الأدب السياسي العربي، وإنما هي حقيقة كبرى تلقي بظلها على العقل الأطلنطي، وعبرت عنها كتابات عدد من المفكرين الاستراتيجيين الأمريكيين، طالما أنه لا مجال أمامهم للدفاع بعمق عن الثقافة الغربية المأزومة إلا بشن حروب ثقافية. وتأتي في هذا الاتجاه كتابات كل من الكاتب الاستراتيجي "ليند" - بعنوان: الدفاع عن الحضارة الغربية، وعالم السياسة المشهور "هنتنجتون" - بعنوان: صدام الحضارات، والفيلسوف الأمريكي الياباني الأصل "فوكوياما" - بعنوان: نهاية التاريخ.
ومعنى ذلك أن المرحلة المعاصرة تضع الأمة أمام "حرب من نوع جديد"، تسعى إلى تحقيق هدف مزدوج: من ناحية - حصار تجربة النهضة السابقة في الخمسينات والستينات، وتصفية آثارها إلى درجة محوها أو تحويلها في الذاكرة من حلم إلى كابوس، ومن ناحية أخرى - بناء تحصينات تحجز المشروع الحضاري النهضوي العربي والإسلامي عن إمكانية تجديد نفسه والتلاؤم مع مستقبل من حق الأمة أن تتطلع إليه. ويمكن القول ان هذه "الحرب من نوع جديد" هي حرب المستقبل، وهي تقوم على الاستغناء عن كل ما عرفه تاريخ الصراع من أشكال الحروب؛ فهي تعرف الاستغناء عن بؤر معينة - أرض أو موارد - تدور المعارك لاحتلالها أو لتأمينها، وعن مسرح استراتيجي للعمليات له تخومه وتضاريسه، وعن جهة قتال محددة تنطلق أو تتوقف عليها النيران، وفوق ذلك فهي حرب لا تحتاج إلى السلاح أو قوة النيران. يلحق بهذا أن هذه "الحرب" يصعب متابعة حركتها، بما في ذلك حساب خسائرها، فليست هناك جيوش تتقدم أو تتراجع، وليست هناك خسائر بشرية أو مادية يمكن حصرها. وأخيراً، فإن ذلك كله غير مرئي لأن هذه "الحرب من نوع جديد" تشتعل وتحتدم في عقول البشر وفي وعيهم وفي ضمائرهم - أهم من ذلك في ذاكرتهم - والمنتصر فيها لا يستولي على جغرافيا، وإنما يستولي على تاريخ، ولا يكتفي بحصار الواقع وإنما يحاصر الخيال أيضاً.. وهنا الخطر.
وإذا كانت الصراعات البشرية عبر التاريخ كلها تتجسد في "صدام إرادات"، وإذا كانت حصيلة هذا الصدام هي الفيصل في حسابات النصر أو الهزيمة، فإن هذه "الحرب من نوع جديد" كانت تستهدف "نزع إرادة الأمة" أو "احتلال إرادة الأمة" بديلاً من احتلال الأرض. وقد لعبت الهزيمة العربية الفادحة في حرب عام 1967 دوراً أساسياً في هذا المجال؛ لأن الجماهير العربية التي خرجت ترفض الهزيمة، وتطالب بالاستمرار في الحرب رغم الهزيمة في معركة، كانت تؤكد بشكل جازم "ان قطعة من الأرض العربية قد تكون عرضة للاحتلال، ولكن أية قطعة من الإرادة العربية ليست عرضة لأي احتلال". وتبرز أهمية هذا الموقف التاريخي في أن الجماهير العربية، لأول مرة في مسيرة الصراع، هي التي اتخذت قرار الحرب في غمار الهزيمة المريرة... تلك الحرب التي تفجرت فعلاً يوم 6 أكتوبر/تشرين أول1973، وهي التي قدمت التضحيات الغالية التي صنعت الانتصار.. ولكن "السياسة" خذلت "السلاح" في تلك الحرب التي تبقى مجيدة رغم كل الاعتبارات.
ويكفي أن علينا - الآن - أن نواجه حاضرنا بسؤال: هل نجح المطلوب من نزع إرادة الأمة؟ أو أن الإرادة العربية لا تزال فيها بقية إرادة كامنة؟ قد يطالعنا المشهد العربي العام من المحيط إلى الخليج موحياً بأن المطلوب تحقق. لكن هناك مشهداً بعينه يبرز أمامنا في عواصم ومدن عربية عديدة يومئ إلينا بأن المطلوب لم يتحقق، وأن إرادة الأمة لا تزال حية وواعية، بدليل أن شعوب الأمة تقاوم محاولات تطويع إرادتها، بما في ذلك تطبيع - غير طبيعي - لا تقبله في العلاقة مع "إسرائيل". ومع ذلك تظل الموازين متأرجحة على حافة خطرة، بينما هذه "الحرب من نوع جديد" تواصل ضغوطها على إرادة الأمة، وبالتركيز على تاريخها، وذاكرتها، ووعيها، وفكرها، وتلك هي ميادين القتال في هذه "الحرب من نوع جديد".
وربما يكون علينا هنا أن نعترف بأن أبرز "الحروب" التي انتصر علينا فيها الكيان الصهيوني هي حرب المصطلحات، بكل دلالاتها الثقافية واللغوية والإعلامية والدبلوماسية. فمنذ أن قام هذا الكيان على الأرض المغتصبة في فلسطين وهو يرفع شعار "السلام"، فيما تاريخه الحقيقي هو سلسلة متصلة من حروب العدوان والتوسع والمجازر الجماعية. وقد وصل نجاحه إلى الذروة حين طرح شعار "الأرض مقابل السلام"؛ وكأن الأرض المحتلة بعد1967 هي بيده بينما السلام بيد العرب، والمطلوب فقط هو تبادل متكافئ بينهما، في حين أن الحقيقة الساطعة تؤكد أن هذا الكيان يحتل الأرض ويهدد السلام في الوقت ذاته. كذلك نجح الكيان الصهيوني في ترويج شعار "الإرهاب" مستغلاً بعض الممارسات المدسوسة على قيم العروبة والإسلام، التي كثيراً ما تكون مفخخة ومجهزة في أجهزة الاستخبارات الإمبريالية والصهيونية. فضلاً عن أن الممارسات الصهيونية القائمة على حملات الإبادة الجماعية والاغتيالات الفردية تمثل أعلى درجات الإرهاب، بل تشكل دليلاً دامغاً على إرهاب الدولة. ولكن الكيان الصهيوني، مستنداً إلى الدعم الأمريكي، والعجز العربي بالمقابل، نجح في قلب الحقائق واستطاع أن يوحي بعلاقة ما بين العروبة والإسلام - من جهة، والإرهاب - من جهة أخرى. وقد بلغ الكيان الصهيوني ذروة النجاح، في حرب المصطلحات، عندما طرح شعار التطبيع المغلوط.
ومن الجدير بالذكر أن هناك مسؤولية أساسية يتحملها النظام العربي في هذا المجال، سواء السلطات الحاكمة أو مجموعات النخبة السائدة.
وتكفي الإشارة - بداية - إلى أن التنازلات التي أقدمت عليها النظم الرسمية الحاكمة ذهبت إلى النقطة القصية في المشهد دون مقتضيات حقيقية تفرض ذلك؛ ويقصد بذلك التطبيع السياسي والاقتصادي مع الدولة العبرية، وإدخالها إلى نسيج المنطقة، قبل أن تكون قواتها قد جلت عن الأراضي العربية المحتلة منذ حرب عام 1967، وهو الهدف الأعلى الذي التزموا به بأنفسهم رغم ما ينطوي عليه من تنازلات فادحة.. ذلك ما شاءه السياسيون العرب من أولئك الذين يتصرفون في مصير شعوب الأمة العربية من دون استشارتها، ويرتبون على حقوقها التاريخية أو على أجيالها القادمة، التزامات سياسية قاطعة قد لا تقوى على نقضها أو إعادة النظر فيها مستقبلاً. قد يملكون الحق في أن يسوغوا ما اقترفوه من أفعال بذريعة "انعدام البديل"، ولكن لشعوبهم قطعاً أن تقدم رأيها في ما اختارته حكوماتهم من سياسات. والأكثر أهمية أن فكرة "انعدام البديل"، في جوهرها، تجعل الزعماء العرب في حلّ من تبعة مسؤوليتهم عن سوء الأداء في السياسة الخارجية·ولا شك في أنه عندما تضيق الخيارات إلى هذا الحد، ولا يبقى سوى بديل واحد، تكون "الهزيمة الكاملة" - أي هزيمة الإرادة - قد وقعت لا محالة. ففي التعامل مع النظام العالمي المتغير يكون أمام الدول العربية خيارات أخرى غير الخنوع تحت شعار "الواقعية"، والمواجهة غير المسؤولة باسم "الثورية". فبينهما خيارات وبدائل عديدة، حقيقة وموضوعية، ولكنها رهن بجسارة الفكر، وحرية الإرادة، وصلابة الفعل. أما حين يصل القرار السياسي - أي قرار سياسي - إلى الإقرار بأنه لا يملك بدائل غير ما هو معروض، أو مفروض، عليه إذاً فان العمل السياسي يفقد أهليته وشرعيته. فمعيار قيمة القرار أنه اختيار بين بدائل، فإذا لم يعد هناك غير بديل واحد، كما يقولون، بشأن "السلام" المعروض أو المفروض علينا، فلا مفر من التسليم بأنه "سلام الاذعان"، وليس "سلام الشجعان".
وفي ضوء ما تقدم يمكن القول ان "التطبيع الإيديولوجي" بين الحكومات لا يعكس بالضرورة نوعاً من "التطبيع الثقافي" بين الشعوب، وإذا كانت الإيديولوجيا من اختصاص الأنظمة فإن الثقافة هي من اختصاص الشعوب. قد تكون الرأسمالية هي الإيديولوجيا السائدة التي سعت إلى الجمع بين الأنظمة و"إسرائيل" على قاعدة المصالح. غير أن "الثقافة العربية" و"الثقافة الصهيونية" تتناقضان وتتنافران، ولن تتمكن الإيديولوجيا من تقليص حدة التناقض والتنافر بينهما. وبين الإيديولوجيا والثقافة ما هو مختلف حتى حدود التناقض. والمواجهة مفتوحة بين الأنظمة التي لا تستمد إيديولوجيتها من ثقافة الشعوب، والشعوب التي لا تجد ثقافتها في إيديولوجيا الأنظمة. وهذا هو التفسير الموضوعي لسياسات القمع والعنف التي تعتمدها بعض الأنظمة التي عمدت إلى قبول الاعتراف بالعدو الصهيوني والدخول في "علاقات طبيعية" معه. كما يلاحظ أن هناك نفوراً بين الثقافة العربية والأنظمة العربية، في حين أن ثمة تماهياً بين "الثقافة الصهيونية والإيديولوجيا" ودولة "إسرائيل"؛ النظام من طبيعة شعبه وثقافة شعبه، في حين أنهما منفصلان في معظم الدول العربية، منفصلان حتى التناقض والتصادم.
إن جوهر عملية التسوية الجارية يؤكد أن "السلام" المزعوم عبارة عن "سلام أنظمة وشركات متعددة الجنسية" تعمل لحساب المنظومة الرأسمالية العالمية، أي أن سيادة رأس المال في المنطقة تفضي حتماً إلى تطبيع العلاقات بين الأنظمة العربية و"إسرائيل" وستدفع بقوة وعنف إلى مواجهات بين تلك الأنظمة والشعوب العربية، قد تسقط التطبيع، وربما عملية التسوية برمتها.
وفي إطار تحديد دور مختلف القوى التي تساهم في عملية التطبيع وتتبناها في محيط النظام العربي، فإن الأدعى للتأمل والتساؤل، على هذا الصعيد، أن تتقدم فئة عربية أخرى، هي فئة المثقفين، بمساهمتها في هذا المشهد السياسي الجاري، أي ضلوعها في عملية التطبيع الثقافي وحتى السياسي، من دون أن يكون هناك من أسباب تدعوها إلى ذلك. وموطن الاستغراب هنا أنها إذ تختار أن تقدم هذه المساهمة، بما لفعاليتها من دور في صناعة الوعي الجمعي، تختار أن تقدمها على مثال ما قامت به الطبقات السياسية الحاكمة، رغم ما ينطوي عليه ذلك من هتك لمحرمات أو عبث بمقدسات ثقافية. فمثل هذا التطبيع لا يمكن أن يشكل حواراً، بمقدار ما هو اعتراف بنتائج، بل بشرعية القطيعة التي أحدثتها الصهيونية في الحوار الطبيعي الذي قام ثقافياً بين العرب واليهود، وما انقطع إلا بعد قيام الكيان الصهيوني الذي أنجز جريمة العصر: الاقتلاع المزدوج للفلسطينيين من أرضهم - من ناحية، ولليهود من أوطانهم وقومياتهم وثقافاتهم - من ناحية أخرى.
كذلك فإن مثل هذا التطبيع الثقافي ليس مجرد انفتاح على "الثقافة اليهودية" - التي تعني أمرين: النظام الرمزي الذي يعبر اليهود من خلاله عن الهوية الدينية الخاصة بهم، وهي مغلقة شأن كل هوية دينية، ثم النظام الرمزي للتعبير عن خبرتهم التاريخية والاجتماعية داخل أوطانهم وقومياتهم كأقلية دينية أو كمواطنين أسوة بغيرهم.. وإنما هو انفتاح على "المؤسسة الثقافية الصهيونية" التي تعني ذلك الخليط من الأساطير التاريخية والأفكار التلمودية العنصرية عن "التفوق العرقي" لفصيلة "شعب الله المختار" و"أرض الميعاد"، فضلاً عن الأفكار الاستعمارية التي أدمنت على تبني إيديولوجيا الإنكار، نزولاً على مقتضيات رسالة الرجل الأبيض، فسوغت للمؤسسة العسكرية محو شعب من التاريخ.
وفضلاً عن ما تقدم، ربما "جاز" لرجل السياسة أن يبرر حال الاستكانة لديه فيعزوها إلى أحكام توازن القوى، وموجبات العمل بقاعدة المرحلية والواقعية السياسية، ومقتضيات انعدام البديل، لكن إذا كان من شأن ذلك أن يقضي بالاعتراف - ولو على مضض - بتواضع جغرافيته، فإن للمثقف جغرافية أرحب بكثير: له التاريخ والذاكرة والرموز. وهو لهذا السبب - وخلافاً للسياسي - غير قادر على التخلي عنها، أو المساومة عليها، أو ترويض نفسه - وغيره - على ممارسة نسيان الهوية أو تزوير التاريخ أو تزييف الذاكرة الوطنية تحت أي ظرف. ولكن الواقع يكشف أن عدداً من "المثقفين" لم يكتف - للأسف - بالقيام بدور "فقيه السلطان"، وإنما أضاف إليه دور "مهرج السلطان". فليست الثقافة الحقيقية هي الرضوخ للواقع القهري، وهي لا تنتمي - بهذا المعنى - إلى الواقعية، بل إن الثقافة الحقيقة هي التي تساهم في تغيير الواقع وفي تحقيق النهضة.
وهنا تنبغي الإشارة إلى أن انخراط بعض قليل من "مثقفينا" في عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني ليس فعلاً معزولاً عن سوابقه، أي ليس من دون تاريخ: إنه ثمرة خطايا سالفة، فهو يتغذى من عملية تطبيع تحتية جرت بين المثقف والسلطة وكان من نتائجها انهيار الرادع الايديولوجي والنفسي والأخلاقي. وغني عن البيان أن انهيار ذلك الرادع هو الذي فتح الطريق لديهم إلى تل أبيب. وإذا كانت هناك من قيمة لهذه الملاحظة، فهي في تجديد الانتباه لمخاطر فقدان الثقافة وظيفتها الأصلية حين تصبح مجرد متاع شخصي يقبل التوظيف الاقتصادي. ها هنا لا تصبح الثقافة مجرد رأسمال مادي (بعد أن كانت رأسمالاً رمزياً) يُدِرُّ الربح على صاحبه، بل تصبح ضريبة باهظة على مصالح المجتمع والوطن والأمة.. وبئس المصير!
إن المثقف يمثل الضمير الجَمْعي للمجتمع والوطن والأمة، وهو حارس الهوية والتاريخ والذاكرة، والمنتصر للحقيقة أينما كانت، والمتصرف في ملكوت المعرفة والتاريخ. لذلك هو غير معني إلا بما ينبغي أن يكون. أما رجل السياسة، فلا يملك غير أن يعيش الحاضر والممكن بعيداً عن مبدأ الحق والحقيقة. إنه يحتاج إلى ثقافة تقيم الاعتبار للتنازل، والتسوية، والمساومة، والحد الأدنى، لأنها وسيلة إلـى تحصيل الممكن؛ بينما لا يستطيع المثقف أن يساوم على الهوية وعلى الحقيقة لأنه إن فعل يساوم على نفسه وعلى دوره. وثمة فارق عظيم بين الموقعين لا يجوز تجاهله. وعلى ذلك، يمكن الاختلاف مع السياسي في ما ذهب إليه تحت وطأة ما اعتبره اضطراراً تاريخياً للتكيف مع حقائق ميزان القوى، أما المثقف، فليس من المفهوم كيف يستطيع أن ينتحل دور السياسي "الواقعي" من دون أن يفقد ملامحه كمثقف! حين يفعل ذلك، مساهماً في تحقيق انتصار "الممكن" على الواجب، والأمر الواقع على الحق والحقيقة، فسيكون عليه أن يملك "شجاعة" الإقدام على تزوير التاريخ، وعلى تشويه ذاكرة الأمة ووجدانها. لعلّه من الجائز للمرء أن يتصرف في حقوقه على الوجه الذي يشاء، لكن حقوق المجتمع والأمة ممتنعة عن أي شكل من أشكال التصرف الشخصي، لأنها ملكية عامة. ليست في بلادنا العربية مؤسسات تفرض القيد على جنوح رجال الدولة والسياسة إلى التحكم في مصائر جموع الناس. لذلك حين يعمد هؤلاء إلى اتخاذ قرارات ترهن مصير الشعب من دون استشارته أو احترام إرادته، فسيكون أسوأ وضع للمثقف أن يضع حرفته (أي معرفته) رهن إشارة هذه الحفنة من رجال الأمر الواقع. ومن هنا أهمية التزام منطق المقاومة.. لا منطق المساومة.
ثالثاً - منهج المواجهة
تنبغي الإشارة بداية إلى أن تاريخ العرب - قديماً حديثاً - كان في أغلبه الأهم تاريخ هزائم ونكسات عسكرية وجغرافية. ومع ذلك لم تستسلم الأمة ثقافياً ولغوياً حين انهارت دفاعاتها العسكرية، وسقط عمرانها السياسي والاقتصادي على الأرض. إذ في مواجهة كل نكبة تعرضت لها الدولة وأفقدتها توازنها، كان المجتمع قادراً على امتصاص الضربة، والحؤول دون سريان مفعول نتائجها خارج المدار المادي. بذلك حفظت الأمة شخصيتها الثقافية من المسخ والاستلاب.
وفي ظروف عالم اليوم، من الملاحظ أن مسلسل التطبيع الثقافي يفتح هوية العرب على تحد جديد، وبخاصة حينما يكون هذا التطبيع - على نحو ما هو عليه - فقرة في نص امبريالي صهيوني جديد يتلى على المنطقة وأهلها الشرعيين، عنوانه: "نظام الشرق الأوسط"، وهو النظام الذي يتطلع إلى انتزاع رابطة العروبة من نسيج العلاقة بين أهل المنطقة وأقطارها الأصيلة، فيعيد تركيبها على مقتضى كيمياء ثقافة واجتماعية جديدة.
وفضلاً عما تقدم، لا بد من تأكيد أن التطبيع الثقافي، بمعناه الواسع، ليس حالاً ينتظر، بل هو حال تعيشها الأمة منذ عقود، بل هو الحال التي مهدت للكثير من مظاهر الانهيار والتردي التي تعيشها الأمة. ومعنى ذلك أن المطلوب هنا هو مواجهة حال التطبيع الثقافي، لا مجرد منع حدوثه، لأنه بالفعل يشن حملته الضارية على الأمة منذ زمن. وهذا التطبيع سيجعل العدو الصهيوني بين ظهرانينا، أي يجعل المرض خفياً كدبيب النمل، ماكراً مخاتلاً كالثعلب.
ويمكن القول أن أول المؤشرات على مدى فعالية الدور الذي تقوم به الثقافة العربية والإسلامية في مواجهة التطبيع، إنما يتمثل في هذه الشحنة الضبابية الخانقة التي تلقيها كلمة التطبيع في وجدان كل عربي ومسلم.. ومن المهم أن ذلك يحدث بصفة تلقائية، ودون أي جهد من حاكم أو مثقف. ومن الثابت أن مصدر الأسى العميق لهذه الآلية، آلية التطبيع ورد الفعل التلقائي في مواجهته، أنها آلية تعتمد القسر والتطويع، ولا تقوم على الإرادة الحرة المستقلة التي تبحث عن مصلحتها وترعى غايتها، بما ينسجم مع كل ما هو طبيعي في وجدانها وضميرها ونظم القيم والمعتقدات التي تعتنقها. لقد أصبحت كلمة التطبيع في سياق عملية التسوية الجارية، بمثابة كلمة سيئة السمعة، حيث تستدعي على الفور كل ما تعبر عنه، على شريط أحداث كئيب ومرير، يمتد من الهزيمة، إلى التطويع، إلى الهيمنة، بخاصة وقد وقر في أذهان البعض أن التسويات الجارية في جوهرها هي تسويات هزيمة.. لا تسويات خيانة، رغم ما ترتب عليها من استسلام رسمي فاقد الشرعية.
ولا شك أن الخبرة المصرية في هذا السياق لها أهميتها من وجود عدة، فضلاً عن فضل السبق! فمن المعلوم أن "إسرائيل" قد اشترطت أن يكون التطبيع في مقابل الانسحاب من سيناء - بمقتضى بنود المعاهدة - كضمان لاستمرارية "عملية السلام" حتى بعد إتمام عملية الانسحاب، وعلى نحو يكفل رابطاً لا ينفصم بين البلدين. ومعنى ذلك في النهاية هو ان يحل "وجود مدني إسرائيلي" في مصر كلها محل "الوجود الإسرائيلي العسكري" في سيناء. بل ذهبت المعاهدة إلى أبعد من ذلك، ونصّت على ان يتم التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين قبل انسحاب "إسرائيل" الكامل من سيناء. لقد تمّ تبادل السفراء، وابرمت اتفاقات متعددة تتعلق بالسياحة والتجارة والبترول الخ.. و"إسرائيل" مازالت تحتل خُمسي سيناء. وشرط التطبيع في نظر "إسرائيل" هو الضمان ألا يتكرر في1982 ما وقع في1957، وهو انسحابها من سيناء دون ان تكون لها "قبضة ما" على مصر تحول دون نشوب حرب أخرى بين البلدين. وهذا مؤشر في حد ذاته على مدى يقينها من وجودها غير الطبيعي.
غير ان هذه "المعادلة" - أي التطبيع مقابل الجلاء - إنما تقوم على إلتباس، هو ان العمليتين ليستا بالعمليتين المتماثلتين حتى يجري تبادل بينهما. ذلك أن الجلاء عملية عسكرية تخضع لأوامر تصدرها الحكومة الإسرائيلية للجيش الإسرائيلي. أما التطبيع، فليس هو بالعملية التي تخضع للاتفاقات التي تبرمها الحكومة المصرية فقط، بل يتوقف أيضاً على استعداد الشعب المصري لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، وهو أمر لا تمتلك الحكومة المصرية السيطرة عليه.
ومن المؤكد ان القيادات المصرية قد حرصت كل الحرص على ألا تترك لحكومة "إسرائيل" أي مبرر لمؤاخذتها على عدم احترام التزاماتها حيال التطبيع. ولكن الحكومة الإسرائيلية لا بد ان تكون قد لاحظت ان جماهير شعب مصر، وبخاصة طلائعه المثقفة، قد وقفت من عملية التطبيع موقفاً زاد عداءاً، وان هذا العداء للتطبيع لم يكن من الممكن نسبته فقط إلى عناصر يمكن اتهامها بالتطرف والتعصب، على أرضية دينية أو غير دينية.
فان افتراض ان تصبح "العلاقات بين المصريين والإسرائيليين" علاقات "طبيعية" إنما يقتضي كافتراض سابق عليه ألا تتعارض هذه العلاقات مع الأوضاع "الطبيعة" للمصريين، أي ألا تطرح قضية "التطبيع" مع "إسرائيل" قضية "هوية" بالنسبة لشعب مصر. وبالفعل، فكيف يمكن للمصريين -المصريين كافة، وليس فقط "المتطرفين" أو "المتعصبين" بينهم - ان يقبلوا كأمر "طبيعي" عقيدة حكومة "إسرائيل" المعلنة بأن فلسطين العربية لا وجود لها قط، أو قانون الكنيست بضم القدس العربية واعتبار المدينة المقدسة بشقيها عاصمة ابدية للدولة اليهودية، أو تكرار قول "القيادات الإسرائيلية" بأن من حق "إسرائيل" القيام بغارات تأديبية ضد أية دولة عربية، وبلوغ عدوان إسرائيل حدّ ما فعلته ضدّ العراق ولبنان وتونس، فضلاً عن الشعب الفلسطيني؟
لقد أصبح "تطبيع" العلاقات مع "إسرائيل" - في نظر شعب مصر، بمختلف فئاته واتجاهاته، ومن مختلف المنطلقات السياسية - أمراً يتعارض مع كل ما هو "طبيعي" في نظره هو. أصبحت مقتضيات "السلام" نقيض ما تقتضيه "هوية" شعب مصر. ونجم ذلك من صميم بنية "السلام المنفرد". لقد فرض هذا "السلام المنفرد" على شعب مصر أن يعادي أعداء "إسرائيل"، وأعداء "إسرائيل" هم عوالم ينتمي إليها شعب مصر - انتماءاً طبيعياً أصيلاً - تاريخاً وتراثاً ونضالاً وهوية: العالم العربي والعالم الإسلامي وعالم عدم الانحياز.
ومن هنا أصبحت المعادلة التي تقوم عليها "المعاهدة المصرية الإسرائيلية" تكشف عن أوجه خلل في صميم بنيتها الأساسية: الحكومة المصرية تؤكد أنها تنجز شروط التطبيع على الوجه الذي حددته المعاهدة، وعلى "إسرائيل" ان تنجز في المقابل التزاماتها بالانسحاب من سيناء. وحكومة "إسرائيل" تتهم الحكومة المصرية بأن شعب مصر لا يلبي التطبيع، أو ربما كان عدم تلبية شعب مصر للتطبيع تدبيراً حكومياً خبيثاً يجري بمقتضاه تعطيل التطبيع عمداً، وقصره على تدابير رسمية وشكلية فقط، في انتظار جلاء إسرائيل من سيناء، وحتى تعود مصر مرة أخرى بعد ذلك إلى الحظيرة العربية.. وهو "منطق" جدير بالتأمل، في ضوء ما حدث في الواقع.
وقد لاحظ قادة الكيان الصهيوني أن مقاومة الشعب المصري للتطبيع بدأت في الثقافة أولاً لتنتقل إلى بقية مجالات الحياة، فكانت لجنة الدفاع عن الثقافة القومية هي أولى هيئات المجتمع المصري التي تصدت لمشروع التطبيع، وهبَ بعدها الشعب المصري بكل فئاته إلى إغلاق المنافذ أمام التغلغل الصهيوني، فيما حرصت الدولة نفسها على التزام منهج "السلام البارد" مع الكيان الصهيوني، منطلقة من أن المعاهدة تفرض على مصر إقامة "علاقات" مع هذا الكيان، ولكنها لا تفرض عليها طبيعة هذه العلاقات ونوعيتها ومدى حرارتها. ولعل هذا الموقف المصري الشعبي والرسمي هو في صلب المأزق المتعاظم الذي تعيشه العلاقات المصرية - الإسرائيلية خصوصاً، وحتى المصرية - الأمريكية عموماً، وهو ناجم بالإضافة إلى المناخ الثقافي والوطني الموجود في مصر، عن شعور متعاظم لدى جماعات النخبة المصرية الرسمية والأهلية، فضلاً عن كل الاعتبارات المبدئية القومية والوطنية، بأن الفكرة التي يقوم عليها "نظام الشرق الأوسط" وما يداخلها من مشاريع "تطبيع" تسعى إلى تهميش مصر وعزلها عن دورها الإقليمي والعربي.
إن تعطيل التطبيع في مصر هو انتصار للثقافة، ولقد كان من الطبيعي "بعد أن تسكت المدافع" ان تندفع الثقافة لكي تحمل الراية من أجل التصدي لعملية التطبيع. فكيف نواجه التطبيع؟ وفي الحقيقة: كيف نواجه مشروع التدمير والتفكيك الثقافي الذي ينطوي عليه التطبيع، وبخاصة في ظل الاختلال الجسيم في موازين القوى والهجمة الإمبريالية الصهيونية على المنطقة بهدف إخضاعها.. مرة واحدة وإلى الأبد؟!
من ناحية أولى، تتمثل نقطة البداية في الإقرار بأن هذا التيار الآتي - التطبيع - ليس بإعصار، لكون الأمة تقبع على تراث ثقافي عميق، مما يجعلها أمة غير سهلة الانصياع للبدائل الثقافية الدخيلة. وبتعبير أكثر دقة، إنها أمة ترتكن إلى تراث ثقافي غير هش، بل قادر على النهوض بتأملاتها الحاضرة وآفاقها المستقبلية، ولهذا فإن ثقافتها المتراكمة تنطوي على عناصر مقاومة وضوابط تتحسس الطارئ والدخيل. ولهذا فقد وصفت بأنها أمة مواجهة، إذ ابتليت بأقسى محن التاريخ، وهبت عليها أعتى العواصف، وتعرضت لسلسلة من محاولات الطمس والمحو، ومع ذلك فقد زادتها تلك المحن قوة شكيمة وصلابة إرادة· ويبقى وجدان الأمة ووعيها الحقيقي هو أهم مقياس لكل سياسة والسد العالي المنيع أمام التطبيع.
لقد نجح العرب، في أكثر من موقع وعبر أكثر من مرحلة تاريخية، في تجربة مقاومة محاولات تدمير المقومات الثقافية الذاتية لهويتهم، لا مجال لتعدادها جميعاً، سواء جرت هذه المحاولات مع حملات الغزاة الفرنجة والتتار والمغول، أو مع مشروع التتريك الذي حاول أصحابه استغلال الولاء العربي للرابطة الإسلامية المتمثلة بالدولة العثمانية لضرب الثقافة العربية واللغة العربية.
ومن ناحية ثانية، من المؤكد أن مقاومة هذا النوع من المشاريع، ولا سيما الثقافية منها، لا يجوز أن تنحصر بالتحذير السلبي من مخاطرها، أو بالإجراءات الشكلية التي لا تتصل بها، بل يجب أن ترتقي إلى مسؤولية تطوير ثقافتنا القومية إلى المستوى الذي نجابه به لا مشروع "التطبيع" الصهيوني فحسب، بل نجابه أيضاً كل التحديات الثقافية والحضارية التي يحملها لنا العصر.
وبهذا المعنى فإن المقاومة الثقافية للتطبيع لا تكون أبداً من مدخل الانغلاق حيث ننكفئ على ذواتنا، ونتآكل من داخلنا، ونغرق في صراعات الفرق والملل والاجتهادات الضيقة. وأساس ذلك أن الانغلاق الثقافي هو الوجه الآخر للتفكيك الثقافي، وبالتالي يصب في خدمة مشروع التطبيع الثقافي مهما تعارضت نيات أصحابه ورغباتهم مع هذا المشروع. ولذلك تحتاج هذه المقاومة إلى "ثقافة المواجهة".
ومن ناحية ثالثة، إذا كان عنوان مشروع التطبيع الثقافي هو التفكيك الثقافي لوحدة الأمة وتدمير مقومات تماسكها، فإن العنوان المضاد يبقى هو "ثقافة الوحدة"، أي الثقافة الحريصة على تنمية عناصر الوحدة في مجتمعنا، وتعزيز أواصر التماسك بين أبناء أمتنا. وبهذا المعنى تصبح "ثقافة الفتنة" واحدة من أبرز العناصر الممهدة للتطبيع الثقافي، بل هي ركن رئيسي من أركان ثقافة التطبيع. فالتطبيع مع أعداء الأمة لا يستقيم إلا بالفتنة داخل صفوف الأمة ذاتها.
غير أن الحديث عن ثقافة الوحدة يجب ألا يوقعنا بالخطأ المقابل، أي في "ثقافة القهر" باسم الانسجام، وثقافة الصهر باسم التماسك، وثقافة هيمنة اللون الواحد باسم الوحدة· فداخل الثقافة العربية والإسلامية الواسعة هناك تنوع يمكن أن يتحول إلى مصدر ثراء لتلك الثقافة. ومن ثم فإن "ثقافة الوحدة مع التنوع" تتطلب أول ما تتطلب تكريس قيم القبول بالآخر داخل المجتمع الواحد، واحترام الآخر، والسعي للتكامل معه في إطار هذه الوحدة.
ومن ناحية رابعة، إن من أبرز معالم الحضارة العربية والإسلامية أنها حصيلة تفاعل حضارات سبقتها وشعوب اجتمعت في ظلها، وأديان موجودة في أرضها، فمن أبرز المساهمين فيها مسلمون غير عرب، وعرب غير مسلمين، على نحو جعلها تمثل تطوراً نوعياً مميزاً في الحضارة الإنسانية بأسرها. ولا شك ان هذه السمة المتميزة للحضارة العربية والإسلامية الجامعة لم تعطها دوراً كبيراً على مستوى الماضي فحسب، بل تعطيها كذلك دوراً مهماً على مستوى المستقبل. فمن أبرز الدعوات الثقافية التي تسعى الحركة الصهيونية لإنجاحها على المستوى العالمي، وخصوصاً الأمريكي، هو الترويج لفكرة الحضارة اليهودية - المسيحية باعتبار اليهودية والمسيحية حضارة واحدة، تعتمدان على كتاب واحد، وبهذه الحضارة يتحول يهود العالم من مجموعة قليلة العدد إلى قوة كبرى بعد انضواء المسيحيين تحت لوائهم.
وفي ظل هذه الدعوة تكاثرت كنائس جديدة في الولايات المتحدة، وفي ظلها تمارس الضغوط المتصاعدة على الفاتيكان لفك ارتباطه بالقدس، وتمسكه بهويتها العربية. إن هذه الدعوة، من دون شك، هي أخطر الأسلحة التي تسعى الحركة الصهيونية إلى استخدامها لمواجهة الحق العربي، بل لتكريس هيمنتها على المنطقة، وهي دعوة لا يمكن مواجهتها إلا عبر دعوة حضارية بالحجم ذاته، تركز على التلاقي التاريخي للمسيحية والإسلام، وحتى اليهودية، في صنع الحضارة العربية عبر العقود الماضية.
في ظل هذا التكامل يصبح ممكناً قيام عنصر توحيد بين العرب وغير العرب من المسلمين المقيمين على الأرض العربية، وبفضله تتمكن المسيحية المشرقية العربية من أن تلعب دورها التاريخي كجسر حضاري بين المسيحية والإسلام، بين الشرق والغرب، فعروبة المسيحيين المشرقيين تعطيهم صلة خاصة بالإسلام، ومسيحيتهم تمنحهم القدرة على التخاطب الفاعل مع الغرب المسيحي.
إن بلورة هذا المشروع الحضاري العربي الجامع تمثل، كذلك، أحد أبرز بنود جدول أعمال مقاومة التطبيع الثقافي، لأن هذا المشروع يضرب مصدراً رئيسياً من مصادر قوته على المستوى العالمي.
ومن ناحية خامسة، لأن الثقافة هي مسؤولية فكرية وعلمية وأخلاقية، فإن المثقف العربي مسؤول بشكل خاص في مواجهة مشروع التفكيك الثقافي العربي. والعقل الصهيوني بات يدرك أنه إذا كانت الثقافة العربية صعبة الاختراق، لعراقة جذورها ومتانة مقوماتها، فإن مهمة اختراق بعض المثقفين العرب تبقى أسهل، وبالتالي يمكن استخدامهم كأحصنة طروادة لاختراق الحصون الثقافية العربية.
واختراق المثقفين العرب لن يأخذ بالضرورة شكل الاختراق الصهيوني المباشر، فمثل هذا الاختراق يكشف أصحابه ويقلل من تأثيرهم، بل هو يأخذ شكل الترويج لقيم ومفاهيم وعلاقات تصب مباشرة في تدمير المناعة الثقافية العربية· فالترويج لأنماط الاستهلاك الغربي، مثلاً، ونشر ثقافة اليأس في الأمة، والإيحاء بوجود تناقض بين متطلبات العصر والانتماء القومي والروحي، والادعاء بأن لا تقدم اقتصادياً واجتماعياً إلا في ظل اقتصاد السوق وشروطه العالمية، وتقديم الخصوصيات الثقافية للجماعات المتعايشة داخل مجتمع واحد على أنها عناصر تناقض وتناحر لا يمكن الجمع بينها، والسقوط باسم الواقعية في منطق الترويج لكل مشاريع الأعداء، والاستهتار بسلم القيم الأخلاقية السائدة، والتفريط بكل شروط المناعة الاجتماعية وتصويرها من مخلفات الماضي، والالتحاق بركب السلاطين، وافتعال الخصومات وتغليب الثانوي من الخلافات على الجوهري من الصراعات... الخ.، كلها أشكال متعددة لنمط واحد، يعتمد على نوع من المثقفين الذين سقطوا فريسة المشروع الاستعماري الثقافي، فكانوا عن وعي أو غير وعي جنوداً في خدمة التطبيع.
ومن ناحية سادسة، يجب أن لا تنسينا ثقافة النخبة التركيز على الثقافة العربية الإسلامية الشعبية، لأن هذه الثقافة الأخيرة تمثل عمقاً بعيد الأغوار راسخ الجذور، ولأن المواطن العربي الإسلامي العادي هو مادة العروبة والإسلام، والعجلة والفلك الذي تدور عليه أمتنا نهوضاً وانكفاء. وحقيقة الأمر أن سوسيولوجيا اليوم هي سياسة الغد على حد تعبير بوتول. وعلى هذا فالتحصين السوسيولوجي الثقافي لأمتنا يتم من خلال العض بالنواجذ على منطقنا الشعبي وموضع حماسنا واعتزازنا، بأدبنا وفولكلورنا، بموقعنا في الحياة، بموسوعتنا الثقافية، بجمالياتنا وأخلاقياتنا، بحبنا الرفيع للحياة، فهذه الديناميات هي القلاع الحصينة والروافع الناهضة. وحقيقة الأمر، أننا إذا تمسكنا بهذا المنهج استطعنا القول ان التطبيع مجرد أسطورة؛ ذلك أن العامة يملكون سلاحين، سلاح الإيمان وسلاح اللسان. وبهذين السلاحين أخفق التطبيع الصليبي، واندحر عندما استل السيف العربي من غمده الإسلامي، وبهذين السلاحين خرج العثمانيون من الأقطار العربية يعرفون من العربية وآدابها وفلسفتها وعلومها أكثر بكثير مما تركوا من كلام تركي في اللهجات العربية.
ونمضي أبعد.. ألم يأتِ الغرب بقضّه وقضيضه متقاسماً كل أسلاب الرجل التركي المريض متوهماً أن الإنسان العربي مريض أيضاً، فإذا به يخرج بأثمان باهظة دفعها عرب المغرب والمشرق بلا حساب. وفي هذا السياق أيضاً تنبغي الإشارة إلى الأجيال الجديدة، فإن الاهتمام بتربيتها وبصقل معارفها وتنمية مداركها، وربطها بالطرق الحديثة، بتراثها والعصر، بقضايا أمتها وتحديات العلم، بنظرتها إلى دورها ومسؤوليتها في المجتمع، يشكل أيضاً مجالاً مهماً من مجالات تنمية الثقافية القومية ومقاومة كل مشاريع التطبيع القديمة والمحدثة.
وبشكل أكثر تعميماً، يمكن القول إن المواطنة الحرة - بالمفهوم الموسع الذي يشمل كل عربي - هي أساس بناء المجتمع المدني الأهلي المتفاعل الحي المفتوح الذي بدوره هو القلعة الحصينة. وعلى هذا المجتمع المدني ستقام المقاطعة الصلبة الرصينة للمشروع الثقافي المقارع النقيض. وسبيلنا تعبئة ثقافية عربية تقوم على مشروع نهضوي أساسه الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومبناه الخيار الحضاري والدولة المؤسسات، ومناط أمره القيم الروحية النابعة من الأديان باعتبارها "ثورات إنسانية استهدفت شرف الإنسان وسعادته". وسيكون للمرأة الدور الكبير في هذه المعركة باعتبارها "مدرسة.. إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق"! فهي واهبة الحياة للطفل ومصدر تنشئته الأولى على قيم الدين والأمة وآداب العروبة وإنسانيتها. وما إغراق المرأة العربية بمظاهر الحياة الغربية سوى هدف أساس في مشروع التطبيع والتطويع.
يرى مؤرخو الحضارات المعاصرة، ومنهم رولان برتون في كتابه جغرافيا الحضارات، أن في عالمنا المعاصر سبعة مدارات حضارية كبرى تتوسطها الحضارة العربية الإسلامية الممتدة من نهر الغانج إلى المحيط الأطلسي... ولقد ملأت هذه الحضارة سمع الدنيا عدلاً وتقدماً، وملكت ناصية التاريخ، وكانت يدها اليد الطولى الأولى والأخيرة، وهذا هو معنى قول الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان: نحن الزمان من رفعناه ارتفع.. ومن وضعناه اتضع!
وهذه الإشارة إلى التاريخ تأتي قصداً مقصوداً، لكي نعرف أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟! ثم نمضي إلى تأكيد أنه ليس من المتصور - مهما هان نفر من الحكام - أن تهن إرادة الأمة أو ترتهن. فهذه الأمة لن تبيع روحها أو تطأطئ رأسها أمام هجمة الهيمنة الإمبريالية والصهيونية، مهما كان عنفوانها أو جبروتها، بل ستعود إلى ذاتها وثقافتها - الحافزة لا العبء - تنطلق منها لتتبارى مع الآخرين في "معركة تفتح الزهور".. وليكن ردنا على المعركة النقيض: معركة التطبيع والتطويع، صرخة مدوية، أطلقها منذ نحو نصف قرن قائد العروبة المعاصرة جمال عبد الناصر: إرفع رأسك يا أخي.
ونحن مع هذا القائد نقول: يا أحرار العرب، ويا أحرار المسلمين اتحدوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون.