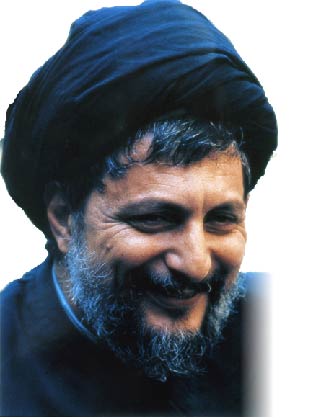إخواني الأعزاء،
السلام عليكم ورحمة الله،
في هذه الليلة الطيبة، ليلة مولد الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، في هذه المناسبة الطيبة التي أوحت لتلك القلوب، وفتحت تلك الحناجر بذكر الله، وبالاعتراف بمودة ذوي القربى التي أمرنا بها، لا شك أنها أفضل أجر وأطيب شكر يقدمهما نبينا ويقدمهما الله من قبل، لأبناء جاليتنا الأعزاء وللمواطنين الكرام، في هذه الرحلة، وخاصة للأخ العزيز المضياف أبي الفضل العباس حفظه الله. ولا شك أن في هذا غنى عن شكري له ولهم جميعًا.
وأدخل في مناسبتنا الكريمة التي بدأ بها شيخنا الجليل العالم التقي الشيخ حسن (حفظه الله)، وجعل سميه الشيخ حسن بيضون يفرش لنا بساط الريح، فيحملنا عليه إلى ملكوت الله، إلى مقام القرب لصاحب المودة، إلى تلك الوجوه البهية التي ملأت الدنيا بعلمهم وتقواهم، هذه المناسبة هي مناسبة ولادة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) المدفون في مشهد (خراسان) في أقصى شرق العالم الإسلامي.
الإمام علي بن موسى من آل بيت سمعتم ما ورد في القرآن الكريم: ﴿قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى﴾ ]الشورى، 23]. لماذا يسلك نبينا بأمر من الله فيطلب منا أن نود ذوي القربى؟ وهل يعتبر هذا جزاء لعمله؟ كلا! وهو القائل لأمهم جميعًا فاطمة الزهراء (عليها السلام) التي هي بضعة منه، والتي هي ريحانته من الدنيا، والتي هي أحب الناس إليه، يقول لها بقسوة العدل: يا فاطمة اعملي لنفسك، فإني لا أغني عنك من الله شيئًا.
هذا النبي الذي يحمل رسالة: ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ [الحجرات، 13]. فيقطع بذلك جميع الجذور والرواسب والانتسابات والزعامات التقليدية، وجميع شؤون الدنيا، يقطعها بهذه الآية، معتبرًا أن الناس سواسية كأسنان المشط متساوين أمام الله، هاشميًا، أم حبشيًّا عربيًّا، أو حبشيًّا أبيض أو أسود، كلهم شخص واحد كأسنان المشط أمام الله الواحد الأحد، الذي ﴿لم يلد ولم يولد﴾ [الإخلاص، 3]، وليس له رحم ولا قرابة، ولا طائفة، ولا قبيلة، ولا انتساب.
هذا الله العلي الواحد يقف أمامه جميع الناس، بشعوبهم وقبائلهم، ثم يقول: أيكم أقرب إلى الله؟ هو الذي يعمل ويكون أتقى من غيره. هذا النبي لا يعتبر أن مودة قرباه هي أجر رسالته لسبب عنصري أو عاطفي، فإنه، كما تدل عليه سيرة حياته، قد تناسى نفسه برسالته، وفي دينه، وأمام ربه، فكان ينقل للناس عتاب ربه، وتربية ربه، وكان يعتبر نفسه يمثل الرسالة فقط. وشرفه بأنه عبد لله، وأمرنا في صلاتنا وهي رمزه وتأثيره، يطلب منا ونحن 600 مليون أو يزيد في العالم، حينما نتوسل إلى الله، ونتقرب إليه، ونحب أن ندعو لنبينا، نقول: أشهد أن محمدًا عبده. هذا النبي الذي يقول لشخص دخل عليه وهو راكب مستعد للذهاب إلى الجهاد، فجعل يعظِّم النبي بالانحناء والركوع والتواضع، فيقول له: تمهل يا هذا إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد... هذا الشخص الذي ما احتفل يومًا بعيد ميلاده، ولا احتفل بعيد رسالته، ولا احتفل بيوم هجرته، وإنما المسلمون جعلوا يوم هجرته مبدأ تاريخهم، هو ما احتفل لنفسه، وما اعتبر لنفسه أمام الله شيئًا ولا جعل يوم مولده عيدًا، ولا أمر المسلمين أن يحتفلوا بيوم ولادته، وإنما هذا من المسلمين وفاء له.
هو احتفل بثلاثة أعياد: الجمعة، والفطر، والأضحى، أيام عبادة إلهه و ربه وربنا... تناسى نفسه في سبيل الله، فهل تريد منه أن لا يتناسى أولاده؟ نعم هو تناساهم، ولكن مودة ذوي القربى لها تأثير في أجر الرسالة، فإن المودة والعاطفة المجردة، هذه الصفات والعناوين اعتبرت في الإسلام مقدمة للعمل. نحن نقول لأحدنا: ادخل إلى المدرسة، واجعل ابنك في المدرسة لكي يتعلم. فهل الدخول إلى المدرسة تعلُّم؟ كلا إنما الدخول إلى المدرسة يهيىء للطالب جوًا يدرس فيه، وينفعل مع الدروس التي تلقاها في المدرسة فيتعلم، فالدخول إلى المدرسة مقدمة، ولو اكتفينا بالمقدمة لما عملنا شيئًا.
المودة في حد ذاتها كعاطفة إنسان، وكانفعالات نفس، لو اكتفينا بها وحدها لما أصابت شيئًا، ولما قربت بعيدًا، ولما منعتنا من شيء، ولا أثرت فينا. إنما المودة والحب سبيلان للتقرب إلى من نحب، ولمحاولة إرضاء من نحب، ولمحاولة الابتعاد عن غضب من نحب، نتبع طريقته، ونرضيهم، وما رضاهم إلا رضا الله. هذا المعنى من المودة جعل في الإسلام أجرًا للرسالة أو سبيلًا لإكمالها والعمل بها، ولهذا أكد هذا القول القرآني الرسول الكريم، بأحاديث متواترة منها قوله: مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، ومنها قوله: إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، ومنها أقواله الكثيرة التي تؤكد على الناس أن يتمسكوا بأهل البيت، ويحبونهم، ومن وراء حبهم المتابعة.
ويفسر ذلك الإمام الصادق الذي سمعتم بعض ذكراه يقول لأحد الصحابة، في جواب قوله، حينما يسأله سيدي: نحن نسمي بأسمائكم، نحن نسمي أبناءنا وبناتنا بأسمائكم، فهل ينفعنا ذلك؟ يقول الإمام: نعم، وهل الدين إلا الحب، ثم أكد دفعًا لكل شبهة ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم﴾ [آل عمران، 31]. الحب لله أو لرسوله أو لآل بيته، إنما هو أثر وذكر وشفاعة، إذا ألحقنا به المتابعة بالعمل، وما اكتفينا بالحب والود والعاطفة فحسب.
وقد كانوا بالفعل متممًا ومكملًا وباعثاً وداعيًا وسبيلًا في علمهم وسيرتهم وأقوالهم ومواقفهم لرسالة جدهم رسول الله. ولهذا، نجد أنهم من أول يوم شمَّروا عن ساعد الجد، فبدأوا بتعليم الأمة كل حسب إمكاناته، وحسب ظروفه التاريخية التي عاشها، فالإمام علي (عليه السلام) في أيام الخلفاء الراشدين، كان يشترك، ويقوم، ويبين، ويشير، ويُستشار في جميع مهام الإسلام، وكان يشترك في جميع الأمور، ثم حينما استلم الخلافة كان نِعْم الخليفة لرسول الله، يقول الحق، ويحكم بالفقه، ولا تأخذه في الله لومة لائم، لا يجامل ولا يساير، مطبقًا قول رسول الله: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار.
ثم جاء دور الحسن السبط، فقام بالأمر، ثم تركه لأمور تعرفونها، فعاش في المدينة ناصحًا مراقبًا، منتظرًا أمر الله، مبينًا لحقائق الدين. ثم جاء الحسين (عليه السلام) فقام بالتضحية الكبرى، فأراق دمه فدية للإسلام وصيانة لرسالة جده، فاستشهد هو ومن معه من أولاده، وسبيت نساؤه ونساء أهله وأولاده. كل ذلك اعتبره فدية صغيرة أمام رسالة الله، قائلًا: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. وقد جاءت بعد استشهاده زينب بنت علي إلى مقتله، ووراءها نساء أهل بيت الحسين وبناته وبنات أصحابه وأهل بيته، وهي أمام منظر الأعداء والقتلة الذين كانوا ينظرون بشماتة، ويتربصون أن يجدوا بنت علي تبكي، جاءت كالجبل الراسخ، رافعة جسد الحسين (عليه السلام) المقطع قائلة: اللهم تقبل منا هذا القربان.
ثم جاء دور علي بن الحسين (عليه السلام)، وقبل ذلك أحب أن ألفت نظركم إلى آثار قتل الحسين في العالم، فهذه الدماء التي هي ثأر الله ما هدأت حتى قضت على يزيد وخلفائه وبني أمية. فمنذ أول يوم لمقتل الحسين بدأت الثورات الصغيرة تنبع في جيش ابن زياد وجيش يزيد، ثم دوت وتجلجلت فبدأت الثورات في الكوفة ثم في المدينة. ثم جاء التوابون، ثم انتقلت الثورات واحدة تلو الأخرى رافعة جميعها شعار "يا لثارات الحسين". ثم جاءت نهضة بني العباس، وكانوا رافعين شعار "يا لثارات الحسين". قضى الحسين باستشهاده على المنكر والبغي والفساد، وجعل نفسه ضحية للإسلام، أعاد الأمور إلى نصابها قدر المستطاع، وهو بذلك ما أراد شيئًا لنفسه، وإنما أراد إثبات وتسجيل وإقامة دين جده قائلًا حينما خرج من المدينة: فوالله، ما خرجت أشرًا ولا بطرًا، وإنما أردت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أريد الإصلاح في أمة جدي ما استطعت.
ثم جاء دور علي بن الحسين زين العابدين، وكان يعيش في أحرج أيام حياة الإنسان، فقد كان يزيد بمواقفه الصلبة، وقتله لـلحسين ونهبه للمدينة، وأمره بهدم الكعبة... ثم جاءت بعده جماعة ما كانت أحسن حالًا من يزيد. كان زين العابدين يعيش في هذه الحالات التي لا يمكن لأحد أن يتفوه بكلمة، فلعب دور الداعي، فكان يجلس في مجلس الرسول، وكان يقرأ الدعاء، وليس أهون من الدعاء. ولكن في دعائه علم وتربية وتوجيه ونصيحة، مثلًا ما كان يقول علي بن الحسين: كن للظالم خصمًا وللمظلوم عونًا، لأن هذا ممنوع في حكم يزيد وأتباعه، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من مظلوم ظُلِم بحضرتي فلم أنصره. تعبير آخر دعائي، متوجه إلى الله، ولهذا نجد في كتاب "الصحيفة السجادية" -أدعية الإمام زين العابدين- كنوزًا واسعة من العلم والفقه والعقيدة والشريعة والأخلاق أجمعها.
ثم جاء دور الإمامين الباقر والصادق، فكان الجو مهيئًا لهما للتعليم والتدريس، ففتحا أبواب مدرستهما وعلما علماء وأئمة وجماعة، وملآ العالم الإسلامي بالفقه والعقيدة وهكذا كل يقوم بدوره، ويصون دين جده. وأحب أن أقف هنا عند الإمامين الباقر والصادق، لكي أذكر نقطة مختصرة.
فالإسلام حينما بدأ ينطلق في القرن الأول، وصل في أواخره وأوائل القرن الثاني إلى مراكز الحضارات العالمية، وصل إلى الإسكندرية، إلى اليونان، العراق، مهد الحضارة الآشورية والكلدانية والبابلية، مهد قوانين حمورابي وأمثال ذلك، وصل إلى الأهواز، وإلى الهند وإلى الحضارة الهندية هذه الفتوحات كانت للمسلمين، ولكن لقاءهم مع تلك الحضارات جعل بينهم وبين الأمم المختلفة المتحضرة تلاقيًا. فبدأ المد الإسلامي يمتد ويرجع، ويأتي بالحضارات والكتب فتترجم وتوزع وتقدم إلى علماء الإسلام، فبدأت التيارات الفكرية تحوم من كل جانب أمام الفكر الإسلامي الحنيف. فوجد المسلمون أنفسهم أمام هذه الحضارات ولا نبي أمامهم، هنا يقف الباقر والصادق كالأسود، يقتحمان هذه المعارك ويعطيان لكل شيء حكمه، ولكل موضوع حديثه، ولكل موقف فلسفي أو كلامي بحثه، ولكل ظاهرة رأي الإسلام فيها. فإذا فتشت في هذا الوقت بالذات تجد توجيهًا كبيرًا حول الجبر والاختيار، حول المعاد والحشر، حول الأشياء الجديدة والمعاملات الحديثة، حول الفقه الحديث والقوانين المتغيرة المتنوعة. وقفا لكي يوجها العالم الإسلامي، فتمكن من جراء ذلك أن يحتضن تلك الحضارة فيهضمها في جسد الحضارة والثقافة الإسلامية، ثم ينمي وينتج حضارة إسلامية رائعة مشرقة، فقدم للعالم تلك الحضارة التي أُلِّفت فيها كتبًا، ودُوِّنت في كثير من التواريخ، والتي هي بحق مفخرة للإسلام وللعرب، حتى قال أحد كبار علماء السياسة: لو أمكن أن نسمي أمة باسم آباء العلم لوجب تسمية المسلمين والعرب باسم آباء العلم.
ومن الطريف أن الإمام الصادق كان يعطي آراءه وتعليماته ومواضيع يشرحها، وكان يطبق على جميع هذه الأحكام والمواضيع الآيات القرآنية، ويقول هذا وأمثاله يُعرف من كتاب الله، فكان يفسر القرآن تفسيرًا دقيقًا على ضوء خبرة البشر، وتقدم وعي البشر. وأحب أن أزيد كلمة هنا، وهي مشكلة من مشاكل الفكر الحديث، لنجد إلى متابعة هذا النوع من التفسير في عصرنا الحاضر بمواجهة الحضارات الغربية والشرقية، حتى نتمكن أن نتخذ موقفًا. هذا السؤال الذي يراود فكر كثير من شبابنا هو أن الإسلام دين جاء منذ أربعة عشر قرنًا، والقرآن كتاب أُنزل منذ أربعة عشر قرنًا، هذه الأحكام هي للإنسان ولصلاته مع غيره، وهذه الأحكام هي لتوجيه المجتمعات وقيادة الأفكار الاشتراعية، منذ وقتها إلى اليوم تغير كل شيء، تغير الإنسان، المجتمع، وسائل النقل، تغيرت الحضارات، تغيرت معالم الثقافة والحضارة، فهل يمكن للدين أو كتاب جاء منذ أربعة عشر قرنًا أن يوجه الإنسان في حضارته في القرن العشرين، ويقود الإنسان لمواجهة الفكر الحديث في القرن العشرين وقد تغير كل شيء؟
والجواب أننا نفكر ونبحث في مفهوم التطور نقول تغير وتطور كل شيء، ما هو مفهوم التطور والتغير؟ كلمة لا نمر عليها إلى تحليل ولا نخاف منها على غموضها، التطور وسببه وصانعه من هو؟ هل يأتي جماعة من المريخ؟ أو عوامل سماوية؟ أو عوامل تخرج من تحت الأرض فتغير المجتمعات وتطور وتكشف الفكر الحديث والآثار الجديدة، والخوافي الحديثة للموجودات؟ كلا، فصانع التطور هو إنسان، والإنسان يتفاعل مع عالمه فيخلق التطور، كيف ذلك؟
الإنسان في أول يوم لا يعرف شيئًا، يعيش حياة بدائية ساذجة، لا يملك لنفسه شيئًا، هذا الإنسان الأول، فكر وفاضت الحاجات عليه، الركب والاكتشاف والتطور، فاكتشف النار، ما خلق النار، عرف النار، فالنار كانت موجودة، والإنسان كان موجودًا. عرف الإنسان البدائي النار قرأ سطرًا من كتاب الكون، وطوى صفحة من كتاب الله، فعرف النار، واستغلها وتصرف فيها، فغير حياته، وغير البيئة التي يعيشها، فبدأ يطبخ ويتدفأ فغير نفسه وغير مجتمعه البدائي. ثم بدأ ينطلق في الكون فيقرأ في كل يوم صفحة، ويطوي في كل يوم صفحة جديدة من الكون، والصفحات كانت موجودة منذ الأزل، وستبقى موجودة إلى الأبد، والإنسان هو الإنسان، يطوي كل يوم صفحة فيتأثر بما يقرأ، ويفعل شيئًا جديدًا فيغير نفسه ويغير مجتمعه، هل التطور غير ذلك أيها الإخوة؟
اليوم نحن ما هي ميزات مجتمعنا؟
عندنا الكهرباء نسمع صوت إنسان يتكلم في أقصى الشرق، فنفهم ونعي ونعمل ونحن في الغرب، نبني بيوتًا، ومعنا سيارات وسائل النقل، المصانع، التلفزيون، الراديو وغير ذلك... هذه ميزة مجتمعاتنا. هذه الأشياء التي نعتبرها أسبابًا في تقرير حياتنا وحياة مجتمعاتنا، هل هي مخلوقة منذ الإنسان الأول؟ كلا، مكتشفة من قبل الإنسان، اكتشف الإنسان الكهرباء فاستعملها، يعني قرأ صفحة جديدة من كتاب الكون فطبقها على مجتمعاته، فأصبح وعيه في زيادة، تفكيره في تقدم، وتفاعله في إكثار. إذًا، صانع التطور هو الإنسان، خالق التطور هو الإنسان. اكتشف فعرف صورة جديدة، وتأثر بصورة جديدة فغير مجتمعه، هل للتطور مفهوم غير هذا؟ أنا لا اعتبر ذلك.
طيب! التطور يتلخص بهذا التعريف. ذلك الإنسان في قطب، والعالم في قطب، يتفاعل الإنسان مع العالم، يعرف فيأخذ، ويفهم شيئًا جديدًا فيعطي أثرًا جديدًا لحياته الاجتماعية.
فالتطور هو تفاعل الإنسان والكون، الإنسان ما خلق جديدًا، والكون ما خلق جديدًا، قديم كلاهما، ويتفاعلان كل يوم تفاعلًا جديدًا. أمام هذين العنصرين، الكون والإنسان، هناك عنصر ثالث هو دين الله، وكلمات الله التي كانت منذ أربعة عشر قرنًا أو يزيد، كانت توجه الإنسان في سيره، في كونه، وكانت تقود الإنسان في معركته مع عالمه، كانت تعطي دروسًا عملية لأن يعيش الإنسان الحياة الطيبة في العالم، كلمات الإنسان.
وهنا ألفت نظر الإخوان إلى هذه الكلمة، الكلمة!! ماذا نفهم عن كلمات الله؟ وما الفرق بين كلمات الله وبين كلمات الإنسان؟ إذا قال أحد شيئًا، إذا تكلم أحد بكلام، فأنت تفهم من كلامه ما هو ظاهر، ولكن لا يحق لك أن تتجاوز مستوى معرفة المتكلم وثقافته. ولهذا، إذا سمعت من الطفل شيئًا، وكانت كلمته تدل على معانٍ كبيرة، لا يحق لك أن تقول ابني أعظم من أينشتاين لأنه عرف في أول حياته شيئًا ما عرفه أينشتاين، ليس لك حق، لماذا؟ لأنه يجب عليك أن تفهم من كلام الطفل بمستوى فهم الطفل، وكلما زاد فهم المتكلم ووعيه وخبرته وثقافته، يحق لك أن تفهم من كلامه أكثر وأكثر.
أذكر مثلًا مختصرًا: اليوم نحن أمام قوانين مدنية، وهذه مقياس لحكم القضاء، ولفهم المحامين، وللقاء المحكوم، والمدعى والمدعى عليه، تفهم من القانون معناه، ثم يأتي المحامي فيفسر لك كلامًا ومادة القانون تفسيرًا أدق وأعمق مما فهمته أنت، فيجب عليك أن تعرف أن قصد المقنن وإرادة المقنن. هذا المفهوم العميق، لماذا؟ لأن المقنن كان عنده من الوعي والخبرة والإحاطة بكبريات الأمور ما يتمكن أن يعطي القانون، وإلا ما كان يفلح بأن يسن شريعة وقانون. وهكذا في نصوص الاتفاقات، الاتفاقيات الدولية، الشركات والمؤسسات والدول تتعاطى الاتفاقيات بعضها مع بعض، فتجد تفسيرًا جديدًا لعبارة الاتفاقية، يتمسك به أحد الطرفين فيضطر الطرف الآخر للخضوع، ولا يحق له أن يقول: أنا ما كنت أفهم من هذه المواد هذا المعنى، لا يحق لك أن تقول هذا، لأن الافتراض أن المتعاقدين كانا على وعي كبير، افترضا وجود هذه الصور، ووضعا لها حلولًا فيجب علينا أن نفهم ونتعمق في كلامه، فنفهم من كلامه الشيء الكثير. فكلما ارتفع مستوى وعي المتكلم وثقافة المتكلم، يحق لنا أن نتعمق وأن نفهم شيئًا جديدًا إلى أن نصل إلى مستوى ثقافة المتكلم ووعيه.
نحن أمام كلام الله، والله لا حد لثقافته، ولا حد لمعرفته، ولا حد لمعلوماته وهو خالق الأشياء، ويعلم كل شيء، وحواس وحقائق كل شيء، فالأشياء المكتشفة اليوم، والأشياء التي لم تكتشف إلى اليوم، الله يعلم كل شيء، فحينما يقول كلمة، يقول الكلمة بمستوى وعيه وثقافته التي لا حد لها، فيحق لنا ونحن في القرن الأول من الهجرة أن نفهم المعاني الظاهرة، ثم نفهم أشياء جديدة، فنتعمق في القرآن، فنجد فيه مفاهيم جديدة. ثم يأتي القرن العشرون ويزداد وعينا وخبرتنا وثقافتنا ومعرفتنا وتطورنا، نرجع للقرآن نتمكن أن نفهم ونتعمق في معاني القرآن، فنكتشف معانٍ جديدة.
أذكر مثلًا صغيرًا، أرجو أن لا أوجد مللًا في ذهن الإخوان الأعزاء، الوردة هي حقيقة واحدة، وردة أمامك، الطفل ينظر إلى الوردة كلعبة أليس كذلك؟ المريض ينظر إلى الوردة كهدية وكذلك المسافر، ست البيت تأخذ الوردة فتجعلها زينة لغرفتها والديكور، المهندس ينظر إلى الهندسة والأشكال الموجودة في الوردة، العالم الطبيعي ينظر إلى خواص هذه الوردة، الطبيب يتعمق فيكتشف آثارًا جديدة لهذه الوردة لبعض الأمراض أو لا يكتشف، وهكذا كلما تعمق الإنسان يكتشف أشياء جديدة من الوردة. أتستطيع أن تقول الطفل على خطأ، أو المريض، أو المسافر على خطأ، لأننا اليوم عرفنا الأشياء الكثيرة فلا يجوز أن يقبل هذه الوردة كهدية؟ لا، بل يقبل كهدية. هل يحق لك بعد اكتشاف خواص الوردة، ومعرفة أن الوردة تأخذ أوكسيد الكربون وتعطي أوكسجين لاستنشاق الإنسان، هل يحق لك أن تقول لا يوجد ديكور؟ الوردة لا يجب أن تكون زينة ويجب أن تكون وسيلة لإعطاء أوكسجين للإنسان؟ هل يحق لك أن تقول إننا اكتشفنا خواصًّا جديدة فأصبحت الوردة ليست أشكالًا هندسية؟ لا، كل من هذه النظرات صحيحة ولكن تختلف الوجهات، جانبًا وعمقًا وارتفاعًا.
هذه كلمة من كلمات الله، الوردة، وهناك كلمة من كلمات الله، الآيات؟ فحينما كنا نفهم من قوله: ﴿ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنما يصعد في السماء﴾ [الأنعام، 125]. حينما يسمع الإنسان هذه الكلمة قبل ذلك بقرن، يفكر أن الإنسان حينما يطلع إلى الجبل يضيق صدره فيتعب، فإذا كان الجبل عاموديًّا كالصعود إلى السماء يتعب أكثر، هكذا كنا نفهم، لكنا اليوم يحق لنا أن نفهم أن الإنسان حينما يصعد إلى السماء، وليس هناك أوكسيجين ولا هواء، والجاذبية تخف فيصبح صدره حرجًا ضيقًا يشعر كأنه يموت.
كنا نفهم من الآية الكريمة في قصة فرعون وموسى(عليه السلام): ﴿فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرًا من الناس عن آياتنا لغافلون﴾ [يونس، 92]، نفهم منها معنى عاديًّا، وهو أن فرعون غرق والله أنقذ جسده حتى يكون عبرة للناس، لكن بعد أن جاء شامبليون واكتشف الخطوط الهيروغليفية، ودخل في الأهرام، ثم عرف مقابر الفراعنة، واكتشف أجسادهم المحنطة وأخرجها كلها، وجعلوها في المتحف فاكتشف تاريخ الفراعنة الذي كان مخبئًا قبل الرسول بألف سنة، وبعده بألف ولا أحد يعرف ذاك التاريخ إلا التوراة... طيب، أمامك كل الفراعنة موجودون، إذًا، أين فرعون، ترجع إلى القرآن: ﴿فاليوم ننجيك ببدنك﴾ [يونس، 92]... القرآن يقول هو الذي سوف يكتشف في التواريخ هذه المعاني، لا شك أننا نستقيها من المكتشفات الحديثة، هذه المعاني هي التي تتبع من نتائج التطورات.
لكن تطور الإنسان والكون يجب أن يكون منسقًا مع تطوره وتفاعله مع كلمات الله، فهناك عناصر ثلاثة، الكون، والإنسان، وكلمات الله، فكلما عرف الإنسان شيئًا أكثر وتعمق في الكون وقرأ في الكون دروسًا أكثر، وطوى صفحات جديدة من صفحات الكون، يجب عليه أن يتعمق في كلمات الله فيكتشف أشياء جديدة.
إذًا، الصادق يعلمنا كيف نفهم القرآن أمام الموضوعات الحديثة والأحداث الجديدة، والتطورات العلمية الحديثة، ثم يؤكد هذا وأسبابه، يعرف من كتاب الله. هذه هي مودة ذوي القربى، كلمات الصادق وفهمها والعمل بها هو معنى المودة في القربى، فجعلهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، واحدًا تلو الآخر حتى جاء دور الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) صاحب هذه الليلة، وبركة اجتماعنا هذا.
أما هو فوقعت في عصره واقعة جديدة من دوره، هذه الواقعة أنه عاش في أيام الخليفة المأمون العباسي في قمة الحضارات وقمة المد الإسلامي في توسعة العالم العربي في وسعة الأفكار من أفكار العالم. المأمون كان يشعر بمشكلة، وهي أنه حينما كان الرشيد قد قسم إرثه إلى أولاده الثلاثة، جعل المأمون حاكمًا وواليًا على الشرق، على إيران، وقسم كبير من روسيا اليوم وأفغانستان، وجعل ابنه الكبير الأمين في بغداد، ونصحهما أن يتفقا، ولكن هيهات: الملك عقيم. فتعدى الأمين على المأمون وخلعه، ثم خرج المأمون على أخيه واعتمد واستند على أهالي خراسان، ففتح بغداد، وقتل أخاه الأمين، وأصبح خليفة على العالم الإسلامي كله. وهنا وقع في حيرة، هل يسكن في بغداد عاصمة العالم الإسلامي ويترك خراسان محل الجيش مقلع الأبطال؟ يترك قاعدته العسكرية، والوسائل النقلية ضعيفة في وقتها، ويمكن للجماعات أن تثور ثورة جديدة، فكما خلعوا الأمين، يخلعون غدًا المأمون؟ أو يدخل في خراسان ويترك بغداد والعباسيين والعلويين الكثيرين هناك؟ يمكن أن يبايعوا شخصًا قوي الإرادة، لا مثل الأمين، فيترك الخلافة لهم فيتفقوا وقبل أن يعرف المأمون يصنعون له مشكلة جديدة لعلهم يقضوا عليه، أو لعلهم يخلقون له مشكلة جديدة.
أمام هذه الحيرة فكر ووصلت نتيجة أفكاره إلى أن يجعل قاعدته خراسان، ويأتي بأشرس العلويين والعباسيين وهو علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، الذي يعترف له كل علوي وكل عباسي بالأفضلية، فطلبه من المدينة وأحضره إلى خراسان، وطلب منه أن يكون خليفة. كثير من التواريخ تبحث في هذا الموقف، فيتساءلون هل كان اقتراح الخلافة على علي بن موسى الرضا (عليه السلام) اقتراح حق أو مجاملة؟ لا أريد أن أدخل في هذا البحث، وحينما كلفه قال له: إذا لا تريد أن تقبل بالخلافة فاقبل ولاية العهد. فالإمام امتنع عن القبول، وبعد جدال قبل الإمام، على أن لا يتحمل مسؤولية الخلافة والمشاركة في الحكم، فقبل ذلك، استقر أمر المأمون وهدأ العالم الإسلامي... لماذا قبل الإمام الرضا (عليه السلام)؟ لأن المجتمع الإسلامي مع وجود المستغلين والساسة لا يتحمل الحكم الحقيقي الإسلامي، والصرامة في الحق والجد.
يقول الإمام الحسين (عليه السلام): الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. العالم يحكي في الدين كثيرًا ولكن إذا اصطدمت مصالحه مع الدين قل الديانون، هنا تعرف معنى الدين من غير الدين. الإمام الرضا يعرف أن هؤلاء الناس الذين يمجدونه لا يتحملون حكم الحق، حتى المأمون الذي دعاه للخلافة لا يتحمل ولهذا جرب تجربة صغيرة، قال المأمون لـعلي بن موسى الرضا (عليه السلام): أرجو أن تصلي بالناس صلاة العيد، اعتذر الإمام عن ذلك، فأصر المأمون، فقال الإمام: على شرط أن أصلي كما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: لك ذلك. فأعلنوا أن الإمام سوف يصلي صلاة عيد الفطر في البلدة، استعد الجنود... وهم مرتدون ملابسهم الضخمة، راكبون الخيل الجياد، واقفون على مدخل بيت الإمام الرضا (عليه السلام)، متهيئون كما كانوا يتهيأون لصلاة الخليفة من قبل. بعد مدة، الباب انفتح وخرج الإمام الرضا (عليه السلام) حافيًا، مقلوبة عباءته بصورة خشوع ووراءه غلمانه حفاة خاشعين، فنادى: الله أكبر، وهكذا نادى الغلمان فوجد الجيش أن الإمام حافٍ، فنزلوا عن جيادهم، وخلعوا أحذيتهم، كان أحسن حالًا من كان يحمل سكينًا لقطع رباط حذائه... فكلهم أضحوا حفاة، مشوا وراء الإمام فنادى الإمام: الله أكبر، والغلمان صرخوا: الله أكبر، وصرخ الجيش: الله أكبر. يقول الراوي: كأن السماء والأرض والسهل والجبل والأشياء كانت تنادي الله أكبر، تجلى أمامنا يوم رسول الله حينما يخرج إلى صلاة العيد تجلت عظمة هذا الحفيد، وصل الخبر إلى المأمون، وقال له الفضل وزيره: يا أمير المؤمنين لو لك حاجة في هذا الأمر، يجب عليك أن تُرجع علي الرضا إلى بيته، وإلا لو وصل على مثل الحال إلى المصلى لافتتن به الناس. فركض المأمون، وقال يا ابن العم: إنك تتعب وأنا لا أرضى بتعبك، فأرجو أن تعود إلى بيتك.
موقف واحد لا يتحملونه، فكيف إذا قام بالأحكام وبين الحلال والحرام، ووضع الأمور في نصابها وقال: القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له، إذا أراد تطبيق ذلك لا يتحملونه، ولهذا الجو لا يساعد. فيجب التدريب والترويض والتعليم والتثقيف، فبدأ يقوم بهذا العمل.
سيرة الإمام الرضا طويلة وليلتنا قصيرة، ولكن أذكر ناحية واحدة هي الناحية الخلقية التي أثارها الأخ الشيخ حسن فنسمع حديثًا عن لسان الشيخ معروف الكرخي أحد حجابه، ينقل سيرة الإمام لجماعته، يقول: عاشرته إحدى عشرة سنة، فوالله ما رأيته شتم، (أين المودة لذوي القربى، الذي يعمل بهذه التعاليم هو الذي يحب آل البيت)، والله ما رأيته شتم قط. الإنسان ذو حالات قد يغضب وقد يرضى، طبعًا الإنسان في الحالة الطبيعية لا يشتم، لكن في حالة الغضب لا أحد يستطيع رد لسانه، لا يرد الكيل كيلين، لا يعتبر حياة الشخص المتعدي عليه مهدورة، لا يهتك حرمه، أو عرضه في غيابه أو حضوره: ﴿لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ [المائدة، 8]. الإيمان يبدو في حالة الغضب فإذا غضبت وصبرت أنت المؤمن، أما في حالة عادية تشتم الناس... لا، لا أحد يشتم. في حالة الغضب هو المقياس، فالمقياس الإيماني ثلاث حالات:
حالة الغضب ﴿لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ [المائدة، 8]،
حالة المصيبة فعندما يصاب أحد بمصيبة يزعل ويغضب ويحكي أو لا يريد... إلا: ﴿الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون* أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة﴾ [البقرة، 156-157]،
حالة الخوف من الفقر، هنا إذا ما غش الإنسان، ما أكل الربا، ما احتكر، وهو يخاف على مستقبله ومستقبل أولاده، هنا يأتي ﴿الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء﴾ [البقرة، 268].
يقول معروف: ما رأيته شتم قط، ما رأيته قلل الأدب قط أمام الناس، ما رأيته متكئًا وناسيًا الدين، وهكذا... كان متواضعًا مع الضعاف، ولكن كان يدخل عليه فضل ذو الرياستين لكي يعطيه الورقة للتوقيع فكان يقف ساعتين أمامه ولا يرفع رأسه لأنه يكون في عبادة.
الاحتجاب عن الناس يوجب أن الإنسان يكبر في أعين الناس، لكن الكبر هذا هو وهمي، في عهد الإمام علي (عليه السلام) لـمالك الأشتر يؤكد على هذه النقطة، يقول له: لا تحتجب عن الناس، لأن الإنسان إذا احتجب عن الناس يكبر في عيونهم فيظنونه شيئًا ثانيًا لا يتصلون به، وإذا اتصلوا به يخافون منه فلا ينتقدونه، فيتعود على عدم استماع النقد، ويتعود على استماع المديح، فيعتبر نفسه رسولًا خُلق لإنقاذ هذه البشرية، يغتر بنفسه فلا يتحمل النقد، فيبتعد المخلصون والناقدون من حوله، يقترب الكذابون المتملقون الدجالون إليه، فيحوِّل الوظائف والمراكز لهم دون الصالحين، فينهي مقياس الصلاح ويتحول مقياس عبادة الزعيم، فتخرج الأمور عن نصابها وتنقلب الأمور والأحوال.
التحجب أمر مكروه أو حرام، ولهذا الإمام، إمام الزمان لا يجوز أن يبتعد عن الناس أو يرتفع عن مكان صلاة الناس، أو يتحجب عن الناس، فالإمام الصادق عندما يعطي هذه التعاليم ثم يقول: وتلك المقاصير والتي أحدثها الجبارون، (يعني بعد فتنة الخوارج، فجعل لنفسه مقصورة فكان يدخل من باب غير باب الناس من المقصورة المحاطة بحائط، والناس يصلون خلف المقصورة خوفًا من الناس لا تجبرًا على الناس)... تلك المقاصير التي أحدثها الجبارون... لا يريد الدين أن يكبر الإنسان في نظر الناس بخدمته الكاذبة التي تنبع من احتجابه عنهم، يريد أن يعيش العالم والزعيم بين الناس حتى يعرفوه فينتقدوه. يعرفوه فينتقدوه فيكبر الكبير الواقعي، أنريد أن نكون هكذا نكون؟!
لا يقبل أن يترفع أحد على الآخر، ولهذا يشعرون أن الكبير لا يتعرى أمام الناس في الحمام فيروا أن له رجل، له بطن... الرسول يأكل ويمشي في الأسواق، فيقول له صاحب الحمام سيدي هل تريد أن أفرغ لك الحمام؟ قال: لا، إن المؤمن أخف من ذلك، لا حاجة لي بذلك.
وهكذا سيرته العاطرة وكلماته الطيبة، تدوي في قلوب المؤمنين وتنير الطريق أمام من يحبهم، جعلنا الله منهم.
والسلام عليكم.
__________________________
* محاضرة للإمام الصدر في منزل عباس كرشت- كانو نيجيريا بمناسبة ولادة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في 21 شباط 1967، من محفوظات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات.