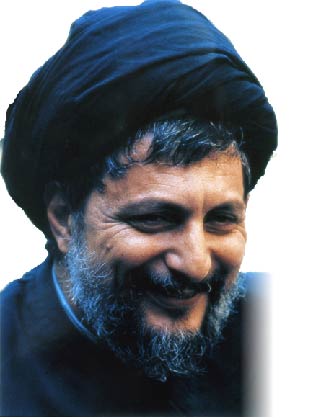لا شك في أننا نعلم أنّ الاقتصاد كعلم، هو علم جديد. ولكن الإنسان يتمكن من أن يكتشف، وكما ذكرنا في الحلقة الأولى، أن يكتشف من الأحكام الإسلامية المتفرقة، مذهبًا اقتصاديًا.
يعني أنّ الإسلام اختار، بين المذاهب الاقتصادية التي تبلورت في عصرنا هذا، اختار الإسلام طريقة واضحة، جميع أحكام الإسلام الاقتصادية تنصبّ في هذا المذهب.
إذًا، بعد أن بحثنا في الحلقات الثلاث الماضية، تحدثنا عن بعض أبعاد اقتصادية: مبادئ عامة اقتصادية، مكتشفة من خلال الأحكام.
اليوم نتحدث وبسرعة عن بعض قضايا فنية، حتى نضع أمامكم معالم هذا المذهب ونكتشف من هذه الأحكام الطريق.
نحن عندما ننظر إلى الأحكام في الإسلام نعرف أنها تنقسم إلى قسمين: الأصول والفروع. هذا التقسيم، كان تقسيمًا أكاديميًا، لمجرد الإحاطة والتدقيق والدرس. ولم يكن تقسيمًا حقيقيًا يفرّق بين الأصول والفروع.
كل الأحكام أصولية أساسية. فكانوا يتحدثون عن الإيمان، حسب التقليد - أرجو الإنتباه إلى هذه النقطة. ويرتبون عليها آثارًا كثيرة. نحن كبرنا وسمعنا أهلنا يقولون: أصول الدين ثلاثة، وأصول المذهب اثنان، فأصول الدين والمذهب خمسة. أما أصول الدين: فالتوحيد، والنبوة، والمعاد. وأما أصول المذهب: فالإمامة، والعدل.
كل هذه الترتيبات أكاديمية، لم ترد في القرآن، ولم يمارس الرسول هذا الأمر. حتى أنّ الرسول يبدأ بالأصول أولًا: قولوا لا إله إلاّ الله تفلحوا. وبعد فترة تبدأ بالصلاة.
عندما نراجع القرآن، في أول القرآن: ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين﴾ [البقرة، 2]. ثم يصف المتقين: ﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾ [البقرة، 3]. الإيمان بالغيب أصل من أصول الدين، لأنّ الإيمان بالله يعني الإيمان بغير المادة، الإيمان بالروح. ثم فورًا: ﴿ويقيمون الصلاة﴾ [البقرة، 3]. بالترتيب الأكاديمي الصلاة ليست من أصول الدين، هي من فروعه. ولكن مَن يسم هذه أصول وهذه فروع؟ كلها "على الرأس والعين" إنتاج علمائنا (رضوان الله عليهم)، للتعليم والتدقيق وللتصنيف، حتى يبوّبوا الكتاب. لا تفرقوا بين هذه الأمور.
﴿الذين يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصلاة﴾ [البقرة، 3]، هذا فرع من فروع الدين. ﴿ومما رزقناهم يُنفقون﴾ [البقرة، 3]، أيضًا من فروع الدين. ﴿والذين يؤمنون بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك﴾ [البقرة، 4]. هذه من الأصول، النبوّة العامة والنبوّة الخاصة. ﴿ما أُنزل من قبلك﴾ هي النبوّة العامة. ﴿وما أُنزل إليك﴾ هذه النبوّة الخاصة. ثم ﴿وبالآخرة هم يوقنون﴾ [البقرة، 4]، أي المعاد، فهو يعتبر من أصول الدين.
انظروا إلى هذا الترتيب والتصنيف، ليس ترتيبًا قرآنيًا إنما علماؤنا لتسهيل المهمات قالوا هذا ورتبوها هكذا. ويجب ألّا يخلق لنا هذا الترتيب أي نوع من الخطأ في الرؤية.
القرآن في عدة أماكن يقول، يصف الإسلام، يصف قواعد الإسلام، فيقول: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. إذًا، بإمكاننا أن نقول: الأصول، العقائد، الإيديولوجية، الإيمان هو: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. سمّها ما شئت! أصول، فروع. أنا أعرف أنه على المسلم أن يؤمن بهذه الأشياء. أن يؤمن! آمِنوا. هي قضية ممارسة، قضية العقيدة والإيمان، قضية معايشة، والمعايشة تطلب دليلًا. إذا قال لك أحدهم: الله موجود. وقلت له تكرمْ، فهذا ليس إيمانًا، هذا محاباة. الإيمان محتاج للدليل، للقناعة الواضحة، للرؤية.
إذًا، إذا نحن تحررنا من هذا التصنيف الأكاديمي، ودرسنا، نرى أنّ في الإسلام قواعد، ذكرنا بعضها ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾ [البقرة، 4]. ممّا رزقناهم، ليس مالًا فقط، الصحة أيضًا، ممّا رزقناهم. فالصحيح صحيًا عليه أن ينفق من صحته. والذكي، والمجرّب، والعالم، عليه أن ينفق من ذكائه وتجربته وعلمه.
الحديث يقول: هل أدلّكم على طريق الجنة؟ يقول الرسول ذلك. قالوا: بلى يا رسول الله، قال: صنّعوا الأخرق. يعني علّموا الصناعة للأحمق، هذا طريق الجنة؟ هل نريد أكثر من طريق الجنة؟ إذا علّمت الأحمق مهنة، الأحمق يقوم مقابل الأميّ، أميّ يعني لا يقرأ ولا يكتب، والأحمق يعني مَن لا يتقن المهنة. العرب يسمّونه الأخرق. إذا علّمنا الأخرق صناعة، فهذا هو الإسلام، طريق الجنة.
إذًا، قضية الإنفاق، قضية الزكاة، قضية العطاء، قضية شاملة. ليس فقط مالًا، بل علم، تجربة، صحة، شباب، كل شيء، حتى النصيحة.
هل قال إنّ الزكاة أو الإنفاق ليس من أصول الدين؟ لا إيمان بدون إنفاق. ليس من إيمان بدونه. ﴿أرأيت الذي يكذّب بالدين، فذلك الذي يدعّ اليتيم، ولا يحضّ على طعام المسكين﴾ [الماعون، 1-3]. ثم الحديث: "ما آمن بالله واليوم الآخر مَن بات شبعانًا وجاره جائع"، حتى ولو لم يكن عليه زكاة... يعني إذا أنا دفعت زكاتي كلها، وجاري جائع وأنا شبعان، فإذا تجاهلته فلست بمؤمن. مهم! ماذا تعني الأصول؟ مَن لم يزكِّ، مَن لم ينفق، مَن يتجاهل شؤون المعذبين، ليس بمسلم. خذْ الآيات العديدة في سورة البلد: ﴿ألم نجعل له عينين، ولسانًا وشفتين، وهديناه النجدين، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة﴾ [البلد، 8-12]. تصوّر، إنه يصف لك الهدف من إعطاء نعمة الله: ﴿وما أدراك ما العقبة، فكّ رقبة﴾، أيُّ تحرير، تحرير الفرد أو تحرير الجماعة.
اليوم، لا يوجد عبيد بالمفهوم التقليدي، ولكن يوجد عبيد، هناك بلاد واسعة كلهم فيها عبيد، يعني مذلولين، يعني المستعمر، الاقطاع، الجور، السلطان يتحكم فيهم.
﴿أو إطعام في يوم ذي مسغبة﴾ [البلد، 14]، إطعام أيّ إشباع: ﴿يتيمًا ذا مقربة * أو مسكينًا ذا متربة﴾ [البلد، 15-16]. إذًا، مسألة الزكاة، مسألة الإنفاق هي أولًا شاملة، وثانيًا أساس، أصول، لا إيمان بدونها.
وفي سورة المدّثّر آيات أخرى: ﴿قالوا ما سلككم في سقر * قالوا لم نكُ من المصلّين * ولم نكُ نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذّب بيوم الدين﴾ [المدّثّر، 42-46]. أربعة أمور:
1- ﴿لم نكُ من المصلّين﴾، فمن يقول إنّ الصلاة ليست من الأصول... مَن لا يصلي فهو في سقر، يعني النار.
2- ﴿ولم نكُ نطعم المسكين﴾، هذا الإطعام.
3- ﴿وكنا نخوض مع الخائضين﴾، اللهو، الالتهاء، عدم الجدّ، عدم الممارسة، إهمال الجهد، إفراغ الحياة من العمل: هو أيضًا كفر.
4- ﴿وكنا نكذّب بيوم الدين﴾، القيامة، المعاد.
وفي سورة المؤمنون، أول سورة المؤمنون: ﴿قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون﴾ [المؤمنون، 1-3]. انظروا إلى الجدية، الإعراض عن اللغو. الجدية أصل من أصول الدين، يعني الابتعاد عن اللهو، الابتعاد عن الباطل، الابتعاد عن الهدر، عدم البطالة. نفس الأركان الواردة في سورة المدّثّر: الصلاة، الإعراض عن اللغو، الزكاة.
إذًا، عندما نقرأ الأحكام الإسلامية، نجد في الأساس وفي العمق مسألة الإنفاق. والإنفاق أساس أولًا، وشامل ثانيًا. ليس لي أن أقول: أنا لا أملك مالًا، فالزكاة ساقطة عني. إذًا أنا لا أملك المال، فأنا أملك الصحة، أملك القوة الجسدية، أملك التجربة، أملك الثقافة، أدلّ على الطريق، بإمكاني أن أقدّم.
إذًا، بشيء من عمق الرؤية بالنسبة للإنفاق، وهو الأساس الشامل، نرى أنّ الإسلام يرفض أن يكون الإنسان يجتذب لنفسه ويأخذ لنفسه دون أن يشرك الآخرين.
أرجو الانتباه لهذا التعبير: ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾ [البقرة، 3]، يعني بنفس الوقت الذي يأتيك رزقك من الله، مالًا أو صحة أو علمًا، بنفس الوقت عليك أن تعطي. أريد أن أبيّن هذا الشيء لكي أعود إلى مسألة الصراع المطروح لدى الماركسية.
أول قاعدة مستفادة من الأحكام: إنّ الطموح، طموح الإنسان، ليس بالإكثار من الرزق، من المال، من الجاه، بل طموحه بالأخذ والتوزيع: ﴿مما رزقناهم ينفقون﴾ [البقرة، 3]، هذا هو الطموح، يعني الهدف، وهذا من الأصول.
ننتقل إلى الأحكام الاقتصادية الأخرى، فنرى إلى جانب الزكاة وأهميتها، زكاة الفطرة، زكاة المال، زكاة الأغنام، الأرباح، نجد طبعًا الخمس.
الخمس يقرّه الفقه الشيعي ويؤكد عليه، ويختلف في ذلك مع بقية المسلمين الذين يقولون إنّ الخمس الواجب هو خمس الغنائم الحربية. أما الشيعة فيقولون الخمس لكل غنيمة، حتى غنيمة التجارة، يعني حتى ولو ربح في تجارته. كل مَن غنم، كل مَن ربح شيئًا، مِن كنز، أو معدن، أو غوص يعني في البحر، أو تجارة، أرباح المكاسب، ففيها الخمس.
هذا نوع من الزكاة، وله أحكام خاصة. ولكن لا تقلقوا من أنّ هناك فرقًا بيننا وبين الغير: نحن نقول بالخمس والغير يقول بالزكاة! لا! الخمس نوع من الزكاة.
الزكاة صدقة المال. الضرائب المتوجبة على المسلم لأجل تحرير الطبقات هو الزكاة. وحول الزكاة بالذات، بحث خاص وطويل، أشير إليه بشكل سريع:
الزكاة من المكلف إلى الفقير. ولكن مَن هو الفقير؟ هو مَن لا يملك قوت يومه وقوت سنته فعلًا أو قوة.
ما هو القوت؟ يختلف! اليوم إذا كان أحد لا يملك ثمن سيارة، أجرة سيارة من هنا إلى القرية فيضطر أن يذهب سيرًا، فهو فقير، لأنّ شؤون الحياة تستلزم أن يركب سيارة. بينما فيما مضى لم تكن السيارة أو أجرتها من شؤون الإنسان العادي. هذا كان ينتقل سيرًا أو على الدابة. فيما مضى لم يكن نوع الخبز، الكهرباء لإضاءة البيت، من المستلزمات المطلوبة اليوم. كل وقت له مستوى. وبعبارة أخرى المستوى العادي لحياة المواطن هو متغير.
كل مَن يكون مستوى حياته أقل من مستوى حياة الإنسان العادي، هو فقير. الفقير اليوم، قد يكون أفضل حالًا من غني قبل ألف سنة، يعيش أفضل منه. الذين نسمّيهم نحن الآن بالفقراء، مَن هم؟ ماذا يلبسون مثلًا؟ نحن نلبس الآن، وكلنا والحمد لله فقراء، ملابس لم تكن تتوفر لكبار الأغنياء قبل مئة سنة، ملابس جميلة ونظيفة، من الصوف. مستوى الحياة يتغير، ومستوى الفقير يتغير.
إذًا، عندما نقول الزكاة، نعني عطاءً من الغني إلى مَن هو دون مستوى الحياة العادية، وكلما يتقدم الإنسان تتوسع دائرة الفقر النسبي التي تتعلق بها الزكاة، أذكر لكم حديثًا وأنتقل من هذه النقطة.
يسأل أحدهم الإمام الصادق (ع): أنا أعطي زكاتي لفلان، ولكني رأيته يشتري اللحم، فهو ليس فقيرًا؟ أي أنه استكثر اللحم على الفقير الذي يعطيه من زكاته. طبعًا في ذلك الحين اللحم لم يكن متوفرًا لكل الناس.
فالإمام قال له: أنفقْ عليه، لينفق على عياله، ليلحقهم بالناس. لاحظوا دقة التعبير. الاختلال بالمستوى الإنفاقي، ليس الطبقي. في الإسلام بإمكانك أن تعطي هؤلاء الناس حتى يرتفع مستوى الإنفاق المطلوب. أي يرتفع مستوى هذا الفقير حتى يكون بمستوى سائر الناس. يعني أنّ ما يكون مدخوله أقل من معدّل الدخل الفردي في المجتمع.
إذًا، الزكاة وهي الشاملة لكل شيء وهي أساس، هي متطورة: سبيلها يختلف، غاياتها رفع مستوى مَن هو دون المعدّل إلى المعدّل. يعني تعديل وتقارب بين مستوى الحياة لدى البشر.
مع العلم أنّ نوع مصروف الزكاة يختلف. سابقًا كنا نتصدق. اليوم يمكن أن نترجم الزكاة على شكل: الضمان الاجتماعي، تأمين الطب الاجتماعي، المدرسة المجانية، إدارة الأيتام، المؤسسات المهنية، هذه الأمور. ممكن تنفيذ الزكاة بشكل متطور. هذا بحث طويل حول الزكاة. مكتوب عند بعض الباحثين.
النقطة الثانية: بعد الزكاة، عندما نتبصّر، نرى الإسلام يحرّم أشياء ويحلّل أخرى. يحرّم الربا. ما هو الربا؟
الربا نوعان: الربا في القرض، والربا في البيع.
الربا في القرض: هو كل قرض يجرّ نفعًا. يعني أنا آخذ منك عشر ليرات وأعيدها إحدى عشرة ليرة بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة. آخذ منك عشر ليرات لأعطيك عشر ليرات وأبني لك غرفة، هو ربا أيضًا. آخذ منك عشر ليرات لأعطيك عشر ليرات وأرسم لك طيارة، أو أعلّم لك إبنك، أو أقدّم لك خدمة، هو ربا.
كل قرض يجرّ نفعًا فهو ربا. يعني المال النقد، العملة، لا ينجب، لا يعطي زيادة. وإذا كنت تريد أن تأخذ زيادة عن المال فهو حرام.
ولكن المال يعطي ربحًا غير ثابت، ربحًا مقترنًا بمخاطر "ريسك". يعني إذا أخذت منك مالًا، ألف ليرة مثلًا، ثم اشتغلت تجارة، فربحت مئة ليرة من هذا الألف، حسب التعاقد أعطيك خمسين ليرة أو ثلاثين ليرة أو ستين ليرة وآخذ الباقي. هذا الذي يسمى أحيانًا في لبنان "شريك مضارب".
ولكن، إذا أخذت الألف ليرة منك، وتريد أن تأخذ نسبة محددة، مبلغًا محددًا ثابتًا، يعني كل شهر تأخذ مبلغًا محددًا: خمسون ليرة، مئة ليرة. هذا حرام. العملة لا يمكن أن تنجب.
أما إذا اشتغلت بالمال، امتزج العمل بالمال، فبإمكانك أن تأخذ ربحًا.
ما هو الفرق؟ أنت صاحب المال لم تشتغل على كل حال. في الحالة الأولى لم تشتغل وفي الحالة الثانية لم تشتغل، ولكن أنا الذي أشتغل. الفرق هو الثبات، ليس للمال أن ينجب دخلًا ثابتًا. يحق له أن يربح إذا كان مهددًا بالخسارة. يعني، أنت الذي تقدّم مالك كشريك مضارب، إذا أنا خسرت فالخسارة منك أيضًا. فعملتك ربما لا تعطي شيئًا، وربما تعطي مئة، وربما تخسر عشرة. هذا الذي يجوز.
إذًا، النقد، المال لا يحق له أن يربح دخلًا ثابتًا. يحق له أن يربح ربحًا، متغيرًا مهزوزًا، مقترنًا بمخاطر. وعندما أشتغل بمالك، بإمكانك أن تعطيني أجرًا محددًا بالشهر: مئة ليرة، خمسمئة، ألف، سواء ربحت أم خسرت، يحق لي أن آخذ مبلغًا ثابتًا. ويحق لي أن آخذ ربحًا متغيرًا. يعني أنا إذا أخذتُ المال منك يمكن أوزّع الربح. فحلال لي أن آخذ الربح أيضًا.
هناك فرق بين المال والعمل، العامل يأخذ ربحًا ثابتًا، ويأخذ ربحًا متغيرًا. المال لا يأخذ ربحًا ثابتًا، يأخذ ربحًا متغيرًا.
هذا المال إذا تحول إلى آلة، سابقًا كانوا يستعملون البقر، أو جهازًا للحرث، لا يجوز إعطاء حصة للبقر أو لجهاز الحرث. يحق له أن يأخذ، أن أعطيه دخلًا ثابتًا. أحدد للثور مبلغًا ثابتًا، وكذا لجهاز الحرث مبلغًا ثابتًا. أجرته عشر ليرات، مثلًا، خمس ليرات.
هنا، ومع التطور أضع أمامكم الصورة التالية: الآلة، كل آلة: ماكينة، سيارة، وسائل النقل، وسائل الإنتاج: الآلة. الآلة لا يحق لها المشاركة في الربح، بل لها الأجر الثابت. المال عكس هذا، لا يحق له الأجر الثابت، يحق له المشاركة في الربح، العمل، كلاهما يحق له الأجر الثابت، ويحق له المشاركة في الربح.
إذًا، في عوامل الإنتاج وعناصر الإنتاج أهم العناصر هي:
العمل: الذي يحق له الأجر الثابت، ويحق له المشاركة في الربح.
المـال: لا يحق له الأجر، لأنّ هذا ربا ويحق له المشاركة في الربح.
الآلـة: يحق لها الأجر الثابت، ولا يحق لها المشاركة في الربح.
هذه العناصر الثلاثة في الإنتاج. لماذا نتكلم عنها؟ نستخرج من هذا البحث الفني السريع الموجز أنّ أهمّ عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي هو العمل، أهمّ من المال وأهمّ من الآلة.
فالعنصر الأول في الإنتاج الإسلامي ليس مالًا ولا آلة، بل العمل. وهذا له استنتاجات اقتصادية كثيرة وأوسع، سنتكلم عنها مستقبلًا.
إذًا، من تحريم الربا ومن تحليل المضاربة ومن عدم السماح بإشراك الآلة في الربح؛ من هذه الأحكام الفقهية الثلاثة اكتشفنا مبدأ اقتصاديًا لتوزيع الثروة. إننا نوزع الثروة، على ضوء أهمية العمل، على المال، والآلة. هذه نقطة. وإلى نقطة أخرى لكي نكمل البحث الفني بشكل موجز في الحلقة القادمة بإذن الله.
غفر الله لنا ولكم.