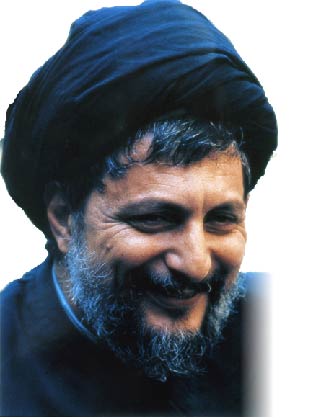بقلم علي حجتي كرماني
1- تبدأ هذه الايات بكلمة "إقرأ"، وتُسمي الله تعالى بـ "الرب" وهو ما يفيد معنى "التربية". واول عمل لله تشير اليه هذه الايات هو خلقه الانسان وانه قد خُلق من "علق" (دويبة تمتص الدم – الحيمن).
ثم تُكرَّر "إقرأ" مرة أخرى، وكذلك التعبير عن الله بصفة "الرب"، وتردفه بصفته الثانية وهي "الاكرم"، لأنه ﴿علّم الانسان ما لم يعلم﴾.
وقد أقسم الله تعالى بـ "القلم" و"الكتابة" في مطلع سورة أخرى من القران: ﴿ن والقلم وما يسطرون﴾. وفسروا النون بالدواة او الحبر.
وهذا التعظيم للقلم والكتابة تم في عصر لم يكن في الحجاز سوى سبعة او اثني عشر كاتبًا، وكان الجاهليون يحتقرون القلم، ويقدسون السيف والجواد.
2- ان "معرفة الله" و"التوحيد"، هما في الحقيقة تلبية للحاجات الفطرية والعاطفية للانسان؛ لأنه بحاجة الى قوة مطلقة وملجأ ومعنى مقدس وواضح في الوجود كله.
وبيّن جدًا ان "الثنوية" و"التثليث" و"تعدد الالهة" لا تلبي هذه الحاجة.
والتوحيد هو الاسلوب الوحيد من عبودية الله الذي يمنح الانسان اليقين والهدوء والامل ويخلق الالتزام، ويهب الوجود معناه.
3- من الطبيعي انه لا يراد بـ "القرب"، القرب الحسي؛ لأن الله تعالى ليس بجسم ولا يحده مكان، بل المراد به نوع من الشهود الباطني. فكما ان الانسان يرى صوره الذهنية، فقد يصل بفضل العبادة الى مرحلة لا يعود يرى غير الله، أي انه يراه بقلبه: "لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الايمان". (نهج البلاغة).
وموضوع "لقاء الله" الذي هو من قضايا العرفان الاسلامي المهمة ومن مراحل السير والسلوك، يشير الى هذا المعنى ايضًا، وقد اشير اليه في كثير من الايات القرانية. ففي سورة البقرة، الاية 46: ﴿الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون﴾.
4- الانسان العابد الذي ادرك مفهوم العبادة على اساس معرفة الله، وخضع للذات المقدسة والازلية لمبدأ الخلق، قد اخترق في الحقيقة حدود المادة وربط روحه بعالم اكبر واوسع بكثير من العالم الذي يدركه الماديون، لأن للقوة الصانعة له علمًا وقوة لا حدود لهما، وهذه القوة موجودة دائمًا وستبقى موجودة. ويجري العالم وفق تدبير عميق ودقيق جدًا. والموت لا يعني الفناء والزوال، بل هو مرحلة من مراحل التكامل البشري. والانسان بمثل هذا الاعتقاد لا يطاطئ رأسه ولا يستسلم للأصنام ولا للبشر من امثاله ولا للجبابرة والطغاة. انه لا يسجد الا لله ولا يستسلم الا لخالق الكون.
انه يسمو بالعبادة الى درجة بحيث يجد في الحياة هدفًا اكبر من الطعام والشراب والشهوة والغضب. نعم، العبادة اهم عامل تربوي، ومصدر جميع كمالات الانسان.
5 و6- الرائع في هاتين الايتين والعديد من الايات القرانية الاخرى انها قد امرت بالاهتمام بالجزئيات والمحسوسات: الاهتمام بالطعام، بالجميل، بالارض، بآثار الماضين، بالنجوم بالزيتون، بالنبات ... وكل القسم القراني هو بمثل هذه الامور. فلم يقسم القران ابدًا بالجوهر والهيولى والصورِة والعقل الاول!
فالقران يقول: فكر في طعامك وحمارك وجملك "فإنظر الى طعامك... وحمارك"، واهبط من ذاك العلو الى الاسفل، او على قول سقراط انقل العلم من السماء الى الارض: ﴿... فسيروا في الارض فإنظروا كيف كان عاقبة المكذبين﴾ [النحل، 36] (قاعدة حسية وتجربية).
﴿افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سُطحت﴾ [الغاشية، 17 – 20].
عندما سُئل ديكارت – احد بُناة التقدم العلمي والمدنية الحديثة – اي كتاب تطالع؟ قال وهو يشير الى جيفة حيوان: هذا الكتاب.
أليس هذا هو عينه الامر القراني الصريح: ﴿افلا ينظرون الى الابل كيف خُلقت﴾ [الغاشية: 7].
7- خلافا لبعض النظريات التي ترى ان العالم موطن للفساد ومحل للجور والظلم، وتتشاءم من نظام الخلقة؛ يرى الاسلام ان عالم الخلقة قائم على اساس الحق والعدل والنظام والحساب وقوانين ونواميس نظام الوجود وانه خالٍ من العيب والنقص.
ثمة كثير من الايات القرانية تعرف العالم على انه قائم على اساس الحق والعدل، نشير الى ثلاث منها:
أ- ﴿وما خلقنا السموات والارض وما بينهما الا بالحق...﴾ [الحجر، 85]
ب- ﴿ألم تر ان خلق السموات والارض بالحق..﴾ [ابراهيم، 19]
ج- ﴿... ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت..﴾ [الملك، 3].
8- الانسان موجود لا نظير له في هذا العالم سواء من الناحية الطبيعية والتركيب الجسمي، او من حيث المسؤولية والهدف، او من حيث المصير والعاقبة.
فمن بين كافة الكائنات التي عرفناها بالتقصي او من خلال اشارة الله سبحانه اليها، يتميز الانسان بانه كائن فريد، ومخلوق على اساس حساب دقيق ومن اجل هدف محدد، ولا يوجد في جهاز خلقته اي تصادف او عبث او لا هدفية.
ويتضح ذلك جيدًا من خلال الايات القرانية وكذلك من النظرة الاسلامية العامة حول الانسان.
ان تفرد الانسان في عالم الخلقة من حيث الطبيعة والتركيب والمسؤولية وغاية الوجود ومن حيث المصير والعاقبة، منطبق تماما مع ما ورد في النصوص الاسلامية والتي تبين بشكل عام التصور الاسلامي للانسان.
فالنصوص الاسلامية تؤكد ان الانسان كائن فريد، ومسؤول، وذو هدف، وانه سيخضع للامتحان خلال حياته، وسيحاسب على سلوكه وتصرفاته، ثم يثاب او يعاقب وفقًا لعمله.
نقرأ في قصة آدم:
• ﴿واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة...﴾ [البقرة، 30]
• ﴿اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرًا من طين. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين﴾ [ص، 71- 72].
• ﴿ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم في البرد والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلًا﴾ [الاسراء، 70]
• ﴿لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم﴾ [التين، 4]
• ﴿الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور﴾ [الملك، 2]
9- عند مطالعة الموقف الاسلامي سنكتشف ان الاسلام وان منح الحرية للانسان واطلق يديه في اعمار الارض واستثمار القوى والثروات، الا انه لم يترك له اختيار طريقة العيش بشكل مطلق، بل الزمه بطي طريق معين وانتخاب اسلوب محدد، لأن الانسان وان كان مزودًا بقوى لاكتشاف اسرار المادة عن طريق العلم النسبي، الا ان هذه القوى لا تنفع في اكتشاف ذات الانسان. فالانسان سيد الارض طبقا للتصور الاسلامي ويشغل مقام "خلافة الله"، وتخضع له كل الكائنات على الارض، ويتمتع بقابليات وامكانيات يمكنه بواسطتها ان يقف على شؤون تلك الكائنات، ويستثمر ما في الطبيعة من طيبة ونقاء وجمال.
وليس الارض فحسب، فقد هبّت السماوات والكائنات الحية والقوى لدعم الانسان كخليفة لله وسيد الارض، بل كانت الغاية من خلقها هي من اجل تكامل الانسان وصولًا الى مقام الخلافة الالهية.
10- ايمان المسلم بانتصار الحق والعدل – الذي هو انتصار الاسلام والمجتمع الاسلامي – ضرورة انسانية، وجبر تكويني، وتلبية لنداء الفطرة. ومع هذا الانتصار لا يمكن ان يتحقق بسهولة، لكن ينبغي ان نعلم ان ألم المخاض وان كان شديدًا وقاسيًا الا انه لا يؤثر على حتمية الولادة، وكما يقول "سيد قطب" فإن اولئك الذين يشككون في تحقق هذا الامر عليهم ان يتذكروا كيف حدث ذلك في المرة الاولى؟ نهض رجل لوحده، وواجه بمعونة النظام الالهي البشرية كافة. وقال لهم طبقًا للمهمة التي كُلف بها: انكم جميعًا في جاهلية، وان الهداية الوحيدة هي الهداية الالهية. وعندها حدث تحول كبير في التاريخ. ان تلك الحقيقة التي استقرت في قلب ذلك الرجل الوحيد، لا زالت قائمة مثل نواميس الكون الكبرى، وما زالت البشرية المنحرفة تعيش القهقرى الى الجاهلية!...
والقضية بايجاز كالتالي:
ستظهر نقطة البداية ... نقطة حلول هذه الحقيقة في قلب واحد .. في عدة قلوب... في قلب الفئات المؤمنة.. عند ذلك ستنطلق القافلة.. ستصل الى طريق ناء وطويل ومغروس بالاشواك.. مثلما وصلت القافلة الاولى.
وانا لا اعتقد ان هذه القضية سهلة او ان المعركة قصيرة.. لكني أعلم ان النتيجة مضمونة .. وكل شيء.. كل الاشياء الحقيقية والفطرية الموجودة في طبيعية الوجود وطبيعة الانسان.. قد هبت لدعمها..
ولا شك ان حشدًا غفيرًا سيهب لمعارضتها .. غير ان هؤلاء فقاعات هواء وهباء! نعم، حشد غفير! لكنه حشد من فقاعات الهواء والهباء!.
• ﴿والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ [يوسف،21].
(الاسلام ومشكلة الحضارة الغربية)
11- كتب سيد قطب: ان المصيبة العظمى للانظمة الاجتماعية الاوروبية في الشرق والغرب والتي صيغت باسماء وأشكال مختلفة، هي انها تسعى لإلغاء وجود "الفرد"، في حين ان الفردية متأصلة جدًا في الكيان البيولوجي (الحيوي) وبالنهاية في التكوين العقلي والنفسي للانسان، باعتبار ان النظام الذي ينسجم مع الانسان، هو ذلك الذي يوجه تلك الفردية – قدر الامكان – في اطار توظف فيه الخير العام؛ في حين ان محاولات هذه الانظمة لكبح جماح هذه "الفردية" وقتلها بمختلف الوسائل، تقضي على كيان الفرد بشكل كامل.
(الاسلام ومشكلة الحضارة الغربية، ص 205)
12- لمزيد من التفاصيل حول هذا البحث، يمكن مراجعة كتاب "الاسلام والتفرقة العنصرية". لكاتب هذه الهوامش.
13- قضية المساواة العامة بين الافراد القبائل، والامم، وإلغاء التمايزات والمحسوبيات والمنسوبيات والفوارق العرقية والعنصرية والطبقية وغيرها ... هذه القضية لم ترد في الاسلام على شكل وصايا اخلاقية وفي إطار التعابير الادبية والعاطفية او من خلال النصائح ذات المنحى التعليمي او الحكمي، كما هو الحال في الادب الانساني بعد الثورة الفرنسية الكبرى، او مثلما أخذنا نسمعه من المثقفين البورجوازيين والفاتحين المؤدبين للحربين المدمرتين الاخيرتين، او ما جاء في لوائح مسيري المنظمات الدولية لا سيما "بيان حقوق الانسان" والتي تعنى بالانسان، الانسان الابيض، الابيض تماما.
ان قضية المساواة العامة قد وردت في الاسلام حقيقة عينية وعلمية وقطعية، وتقوم هذه المساواة على اساس فلسفة علمية ومذهب فكري وعقائدي. ان المساواة بين كافة أفراد البشر وبين كل المجتمعات والامم ليست مشروعًا يقترحه الاسلام، او تعاليم اخلاقية يدعو الناس الى اتباعها، او طموحات انسانية يرى في تحققها خدمة للحياة الانسانية وتعزيزًا للسلام والوئام بين الجميع. بل ان الاسلام، وانطلاقًا من رؤية فلسفية وعلمية للكون، يريد ان يقول ان الناس متساوون فيما بينهم، لا انهم يجب ان يتساووا! وهذه حقيقة علمية وطبيعية وليست طموحًا او امنية اخلاقية...
فالاسلام الذي يطرح فكرة "المساواة العامة" على اساس انها قضية سياسية واجتماعية، يقيم تلك الفكرة على أسس علمية وفلسفية. والهدف من ذلك ان يقدمها اولًا كمبدأ طبيعي لا غبار عليه، وثانيًا للارتفاع بـ "المساواة الانسانية" من "المساواة الحقوقية" الى درجة "المساواة الحقيقية" او يرتقى بـ "المساواة" الى "الاخوة".
وهذه النقطة عميقة وقيمة للغاية، وهي ان المساواة تبين قضية حقوقية واعتبارية وخارجية ونسبية، في حين ان الاخوة تهتم بالحالة الذاتية والعينية والداخلية المطلقة الموجودة لدى الاخوة. ولهذا فإن "المتساويات" تكون في مستوى واحد وفي حالة تعادل وتساو، في حين ان "الاخوة" يكونون متجانسين ومن ذات واحدة وجوهر واحد. فالمساواة تكشف عن العلاقة بين إثنين او فردين في حين ان الاخوة تكشف عن منشئهما.
فالمساواة – في الحقيقة – ضرورة منطقية وجبرية متلازمة مع الاخوة، ومعلول طبيعي وبديهي لها ...
(راجع "معرفة الاسلام" للدكتور علي شريعتي ص 34 و117).
14- لقد كرم الاسلام العمل وقدّسه حتى اننا نقول بثقة: انه لا يمكن ان نجد مثل هذا التكريم في اي من المذاهب الاقتصادية المعاصرة. لقد رفع رسول الله (ص) يد عامل ورمت من شدة العمل وقال: انها يد لا تحرقها نار جهنم ابدًا، وانها يد يحبها الله ورسوله. ان من أكل من كد يده نظر الله اليه برحمة.
وورد في سيرة الرسول الاكرم (ص) انه كلما رأى شخصًا لا عمل له كان يلومه ويقول: من لا عمل له، يقتات بدينه.
وقال الامام الصادق (ع) لأحد أصحابه ويدعى "معاذ" بعد ان اعتزل العمل: هل اعتزلت العمل لضعف؟ فقال: لا، عندي مال كثير، ولست مدينًا لأحد، مالي هذا يكفيني لآخر حياتي ولهذا لا حاجة لأن أرهق نفسي بالعمل، فقال الصادق (ع): مع ذلك لا تترك العمل، لان اعتزال العمل يزيل العقل.
(راجع كتاب "اسلام، آيين زندگى" اي "الاسلام دين الحياة" لكاتب هذه الهوامش، ص 92).
15- غالبًا ما يُفْهم الدين على انه ردة فعل معنوية للانسان إزاء الحياة المادية، وهي إزاء الاخرة... وهذا التناقض المصحوب بالافكار الهندوسية، والرهبانية والرياضة المسيحية والمذاهب العرفانية الافلاطونية، والزرادشتية، والمانوية وغيرها، هو في الحقيقة ردة فعل على انغماس بعض الناس في الملذات والغرق في حمأة الرذيلة وعبادة الشهوة والمال، والمفاسد الناجمة عن حب الدنيا والتطلع الى المزيد من القوة (حيث كانت المسيحية خطوة نحو الحدّ من عبادة المادة والانغماس في الملذات الذي كانت عليه الامبراطورية الرومانية...).
والاعراض عن الدنيا والنزوع نحو الزهد في الثقافة الاسلامية، كانا في الحقيقة ردة فعل ايضًا على ما راحت تتمتع به الطبقة الاسلامية الحاكمة من بطر وترف وتفنن وانغماس في اللذة بعد الخلفاء الراشدين.
ولم يكن لإسلام الرعيل الاول مثل هذا التناقض، فالدنيا لا تتناقض مع الاخرة بل كان كل منهما مكملًا للآخر. فذم الدنيا بشكل مطلق وكبت الغرائز، فضلًا عن انه امر مغاير للفطرة ونظام الوجود، فإنه غير صحيح ايضًا من وجهة نظر القران. فالقران لا يسمح لأتباعه نسيان استثمار الدنيا: ﴿ولا تنس نصيبك من الدنيا﴾ [القصص، 77]، ولا تجاهل لذائذ الدنيا وطيباتها بشكل كامل: ﴿قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق..﴾ [الاعراف، 32] كما ان المنطق القراني يحتم طلب السعادة المادية والمعنوية من قبل المسلم: ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة﴾ [البقرة، 201].
وورد في الروايات الاسلامية ان "الدنيا مزرعة الاخرة" وانها: "مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي الله ومتجر اولياء الله".
وقد عبر الامام الصادق (ع) خلال جملة واحدة بصراحة ووضوح عما نريد ان نقوله، وبعد كلامه هذا مؤشرًا واضحًا على التصور الاسلامي خلال التذبذب الفكري البشري بين المادة والروح: "ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا ىخرته لدنياه".
(لمزيد من الاطلاع في هذا الموضوع إقرأ بحث "التوافق بين الدين والمدنية" من كتاب "معرفة الاسلام" ص 44 وبحث "الدنيا من وجهة نظر الاسلام" من كتاب "الاسلام دين الحياة" ص 8.
16- كان فلاسفة الاغريق قبل ارسطو يعتقدون ان اساس سعادة الانسان يكمن في "الفضائل النفسانية"، والانسان الذي له مثل هذه الفضائل، سعيد ولا شك، وان كان يعاني من كافة الامراض الجسمية: "فإن الانسان اذا بلغ تلك الفضائل لم يضره في سعادته ان يكون ناقص الاعضاء مبتلى بجميع امراض البدن".
(طهارة الاعراق لابن مسكوية، ص 78)
والمرتاضون الذين لا يزالون موجودين حتى اليوم، قد ذهبوا ابعد من ذلك حيث جعلوا سعادة الانسان في الحرمان وعذاب الجسم، ويقولون انه كلما كُبتت رغبات الجسم وقلت الاستجابة لها، سمت الروح وعظمت سعادة الانسان.
غير ان الاسلام يرى غير هذا. فالاسلام يعتبر الانسان مجموعة من الرغبات والميول الجسمية والروحية ولا يسمح بالنيل من أي منها، ويعتقد انه كلما كبتت رغبة من تلك الرغبات، تعرضت سعادة الانسان الى الضرر بالمقدار نفسه.
وعندما سمع الرسول الاكرم (ص) ان "عثمان بن مظعون" و"عبد لله بن عمر" و"إبن مسعود" و"قدامة" قد اعتزلوا الطيبات والنساء وكثيرًا من اللذائذ، وانهم يقومون الليل ويصومون النهار – باستمرار – وقد سكنوا الصوامع كالرهبان قال (ص) – ما مضمونه: انا اصوم وافطر وانام واتزوج النساء. لقد كان من قبلكم اناس قد هلكوا لأنهم حملوا انفسهم مشاق لا معنى لها، ولا زالت بقايا هؤلاء في الاديرة والصوامع. ثم قال: ليس مني من اعتزل النساء.
وقال لمن يصوم النهار ويقوم الليل: لا تفعل مثل هذا، صم وافطر، وصل ونم، لأن لجسمك وعينك عليك حقًا.
ويكفي هذا القدر لمعرفة التصور الاسلامي حول عدم التناقض، والانسجام بين الجسم والروح.
17- حول الخير والشر وموقف الاسلام منهما، راجع كتاب "العدل الالهي" للشهيد مرتضى المطهري، ص 99، الطبعة الثانية.
18- راجع كتاب "المطهرات في الاسلام" – بالفارسية، تأليف المهندس مهدي بازرگان.
19- ما يمكن ان يقال بإيجاز حول حكمة الحلال والحرام وفلسفتهما عمومًا هو ان ما حرم في الاسلام، لا بد ان يكون ضارًا بأحد الجوانب المادية والمعنوية للانسان، وان يكون ذلك التحريم لصالح الانسان نفسه.
لكن لا يمكن الادعاء بان الانسان قد وقف على كل تلك الجوانب.
وقد كتب محمد بن سنان الى الامام علي بن موسى الرضا (ع) يقول له: ان بعض المسلمين يتصور ان الحلال والحرام في الاسلام ليس له من علة سوى التعبد والطاعة. فأجابه الامام: "قد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدًا...".
20- معنى الحسد هو ان لا يطيق أحد رؤية آخر في نعمة وسعادة ويتمنى دائمًا زوالها. ومن البديهي ان الشخص الذي يعاني من هذا المرض النفسي – أي الحسد – لو ملك نفسه ولم يُقدم على عمل يلحق بواسطته الضرر بالمحسود، فإن ضرره لن يخرج عن دائرة نفسه وعنائها. ولو واظب على ضبط نفسه فإن ذلك المرض النفسي سيزول عنه تدريجيًا؛ على العكس مما لو أظهره فإنه سيزداد يومًا بعد آخر، ولا يمكن عندئذ القضاء عليه حتى يهلك هو او يموت الشخص المحسود. وقد قال امير المؤمنين (ع): "الحسد داء عياء لا يُزال الا بهلاك الحاسد او بموت المحسود".
ولهذا قيد الله تعالى في سورة "الفلق" الاستعاذة من الحاسد عند إظهاره لحسده: ﴿ومن شر حاسد اذا حسد﴾ [الفلق، 5].
21- نقل المؤلف الجليل هذه الرواية عن أصول الكافي، لكن يبدو انه قد نقلها بالمعنى، وربما كان المقصود الرواية الرابعة من باب "الوسوسة وحديث النفس" في أصول الكافي المنقولة عن علي بن مهريار: كتب رجل الى الامام الصادق (ع) وشكا اليه مما يخطر له فأجابه الامام: "ان الله عز وجل ان شاء ثبتك فلا يجعل لإبليس عليك طريقًا...".
(أصول الكافي، ج 4، ص 167)
22- قال الامام الباقر (ع) لحمران بن أعين: "المؤمن يُمتحن دائمًا ويُمحص، فيذنب ويتوب، ثم يذنب فيجعل في التوبة. ألم تسمع قوله تعالى: ﴿ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ [البقرة، 222]. وكذلك ﴿وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه﴾ [هود، 3].
(أصول الكافي، ج 2، ص 423)
23- قال الامام الصادق (ع): "داووا مرضاكم بالصدقة وامنعوا البلاء بالدعاء...". وقال الامام الباقر (ع): "الصدقة تدفع بلايا الدنيا وميتة السوء".
(فروع الكافي، ج4، ص 20)
24- الافضل ان يُعبر هنا عن الربانية بنفس التعبير الاسلامي الحقيقي والاصيل الا وهو "التوحيد" لأن "الربانية" في الاسلام قد طُرحت في إطار التوحيد، وان الاسلام قد بدأ نهضته بشعار "التوحيد": قولوا لا إله الا الله تفلحوا...
فالتوحيد اساس جميع أصول العقائد الاسلامية، والانسان المسلم يفكر في التوحيد دائمًا بمثل هذا الفهم، ويحرص غاية الحرص على ان لا تشوبه شائبة من خلال الفكر والشعور والعمل. فهو يفهمه على الوجه الصحيح ويحذر من كل ما يتناقض معه، ويقيم حياته الفردية والاجتماعية، المادية والمعنوية على اساسه، لأن اقل غفلة في هذا الاصل ستؤدي الى ضياع كل شيء.
والمفهوم الاوضح لهذا الكلام هو ان "التوحيد اساس العقائد كلها". ولهذا فإن التوحيد هو القاعدة الاساسية لجميع اوجه حياة الانسان المسلم، وافكاره ومشاعره، وأعماله مهما كان شكلها وطبيعتها. كما ان اوجه الصداقة والعداء كلها، وانواع الاجتماع والاختلاف والنشاطات السياسية والاجتماعية كافة، يجب ان تنظم بطريقة يكون التوحيد اساسًا لها.
ويُفهم من التوحيد – عادة – عبادة الخالق فقط، في حين انه عقيدة ذات أبعاد عامة وعديدة تكشف عن المنظر العام للعالم والمجتمع. وهي لا تُظهر العلاقة الطبيعية والعملية بين الانسان والوجود فحسب، بل تحدد ايضًا علاقاته السياسية والحقوقية والاقتصادية.
معرفة الله من وجهة النظر الاسلامية تستلزم عبادة المسلم الخالق العالم الذي هو المقنن له وحاكمه ومالكه ايضًا، والا يعبد غيره (وهذا هو التوحيد).
فإلغاء ونفي كافة المعبودات في شعار "لا إله الا الله" مقدم على إثبات العبودية للخالق.
فالتوحيد، فضلًا عن انه يعني وحدانية المعبود والحالق، يعني وحدة حاكميته ايضًا. يقعُ إلغاءُ حاكمية غيره ورفضها على رأس المفاهيم التي يمكن استنباطها من شعار (لا إله الا الله).
والتوحيد بهذا المفهوم يوسع من إطار العبادة كعقيدة، الى الاعتقاد بعدم أهلية الحاكم ووضّاع القوانين المستبدين وارباب القوة السياسية، للعبادة والاطراء، بل ولا تعدهم اساسًا أصحاب حق في الحكم والتشريع. ونعتقد ان المرجع الوحيد لتشريع القوانين الاجتماعية وأسلوب الحياة هو خالق العالم لا غير ﴿ان الحكم الا الله..﴾ [الانعام، 57].
25- لو توقف الاجتهاد في الدين حقًا، فإن ذلك لا يؤدي الى تبديد جهود الرسول (ص) فحسب، بل اخراج الاسلام عن مسار التاريخ والتكامل ايضًا.
اذ ان دعوة الرسول الاكرم (ص) هي تعزيز العقل وتحريره من الخمول ومواريث الجاهلية، والسعي لتعريف الانسان بنفسه والكشف عن قوته وثروته المعنوية، وتبيان كل ما يؤدي الى بناء شخصيته واستقلاله الفكري عبر الايات البينات والتعاليم العملية. ثم فتحت تلك الدعوة ابواب الاجتهاد بوجهه على اساس العقل والكتاب والسنة. وعلى هذا الاساس فإن الاجتهاد ملازم للخاتمية ونُسختها الباقية، او ان الاجتهاد نبوة مقيدة ومع الواسطة. ويجب ان تكون للمجتهد شرائط النبي نفسها ولكن بمستوى اقل وعمومية أكثر.
والنبي يتلقى عن الوحي بدون واسطة، اما المجتهد فبواسطة. فالنبي يأخذ الكتاب، والمجتهد عن الكتاب. النبي معصوم، والمجتهد يجب ان يكون عادلًا...
(راجع مقال "الخاتمية والاجتهاد" في مجلة "مكتب تشيع" ]بالفارسية[، لعام 1961، ص 159 وكذلك مقال "اصل الاجتهاد في الاسلام" في المجلة نفسها ص 301؛ وكذلك لقاءات الاستاذ العلامة الطباطبائي مع البروفسور هنري كوربان في المجلة نفسها، لعام 1960، ص 48).
26- لُقب ابو زيد عبد الرحمن بن خلدون بفيلسوف المؤرخين لأنه قد ابتكر طريقة في كتابة التاريخ لم يعهدها أي من المؤرخين الكبار حتى ذلك الحين في دراسة الموضوعات التاريخية. ينتمي الى البربر ونشأ في تونس، وطالما ذهب سفيرًا من بلد لآخر خلال حياته النشطة.
وانبرى بجرأة لتحليل تاريخ قومه وتوصل الى حقائق ذات قيمة تنطبق على أقوام آخرين. لقد أفاد من معلومات الرحالة المسلمين والتراث الثقافي اليوناني والتطورات الممزوجة بالعظات التي طرأت على المجتمعات الاسلامية والمسيحية فضلًا عن مشاهداته واختباراته السياسية. وكان يعتقد ان تاريخ المجتمع يحظى باستمرارية ذاتية، لكنه يتأثر ايضًا بالعوامل الخارجية لا سيما "الهجرة" وكان ينظر الى التاريخ نظرة باحثة مستقصية، على العكس من المؤرخين الاخرين ويقول: ان التاريخ مجموعة من التحولات الاجتماعية. والعوامل العينية والذهنية للتاريخ متصلة مع بعضها الى درجة ان بالامكان عدها واحدة.
واثره الشهير يدعى "كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر"، وهو في سبعة أجزاء، وتعدّ مقدمته الواسعة غنية للغاية من حيث العلوم الاجتماعية.
وقد اثنى ناثانيل شميدت (Nathaniel Schmidt) على الفلسفة الاجتماعية لابن خلدون قائلًا: "تتجلى شخصية ابن خلدون بوضوح ودقة في كتابه الكبير. ان كتابه هذا يضفي عليه الخلود اكثر من خدماته السياسية. وكتابه مرآة طبعه".
لقد طالع ابن خلدون الحياة الاجتماعية من زوايا مختلفة. وكان يدعو باصرار الى دراسة المجتمع دراسة شاملة قائمة على اساس الاهتمام العلمي، وقد بذل – ما سمح له الزمان والمكان – في هذا الطريق جهودًا صادقة. وكان فردًا فريدًا سبق عصره. ولا بد ان نتحدث عنه بنفس الاسلوب الذي عدّه مناسبًا لتبيان أي ظاهرة تاريخية؛ اذ تعرض ابن خلدون وطبقًا لقانون النمو والانحطاط الاجتماعي – الذي اكتشفه – فترة من الزمن الى النسيان، ثم كشف عنه هذا القانون نفسه. فالشخص الذي لا أتباع له ولم يصنع نحلة ولم ينفذ في عصره ولا في الاجيال التي اعقبته مباشرة، هل يمكن ان يعد زعيمًا ام لا؟
ان الشخص الذي يكتشف طريقًا جديدًا يعد هو موجد الطريق. ولو لزم إعادة معرفة ذلك الطريق، فذلك الشخص الذي يتقدم ابناء زمانه هو الزعيم، وان عُرف واتبع بعد قرون...
(راجع جزءاً من محاضرة الدكتور امير حسين اريانبور – استاذ علم الاجتماع – المنشور في مجلة "سهند" تحت عنوان "ابن خلدون رائد علم الاجتماع"، الدفتر الاول، ربيع 1970، ط تبريز، ص 51).
27- ان اتهام امة رافعة للواء الكتاب والعلم بإحراق الكتب، أسطورة مضحكة، وتبعث على التقزز ايضًا... ولا يوجد في القران الكريم ما يجيز القيام بمثل هذا العمل ولو كان بسيطًا، بل على العكس من ذلك توجد هناك ادلة قوية تؤكد قداسة الاثار المكتوبة للعلماء، وتُولي العلم والعلماء أهمية فائقة، ولا تفرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم.
وكانت وصايا الخلفاء للقادة الحربيين الموفدين الى البلدان الاخرى من اجل الجهاد في سبيل نشر الاسلام، تؤكد دائمًا على الحفاظ على الاثار الدينية والعمرانية لكل منطقة يدخلونها. ونلاحظ في المعاهدات المعقودة بين هؤلاء القادة وسكان مصر وسوريا وفارس والبحرين والعراق واذربيخان، ان بنودها الاساسية تؤكد على حفظ آثار هذه المناطق ورعاية عقائد اهلها وعباداتهم. ولا يلاحظ في الوثائق الاولى لكتب التاريخ الاسلامية منذ القرن الثاني الهجري فيما بعد، ما يشير الى حادثة من هذا القبيل. هذا فضلًا عن ان الاثار التي الفها نصارى مصر والشام على هذا الصعيد لم تشر هي الاخرى الى ذلك. وفي الاثار التاريخية والجغرافية والقصص والروايات الادبية المنقولة عن القرن الثاني وحتى القرن الهجري السادس لا يلاحظ ذكر لأي حدث يفيد بإحراق الاثار الاولى وكتب ما قبل الاسلام او القائها في الماء (1).
وقد كتب غوستاف لوبون: "نكتفي بهذا القدر من الكتابة ونقول ان ما يثير الدهشة الى حد بعيد هو كيف يمكن لمثل هذه الحركة الهمجية – التي تتناقض الى هذا الحد مع اوضاع وعادات هؤلاء الفاتحين – ومثل هذه الاسطورة التافهة – ان تحظى بالقبول والاشتهار. غير ان بطلان هذه الخرافة في العصر الراهن قد أصبح امرًا ثابتاً وواضحًا بحيث لم تعد هناك حاجة الى مناقشة او تحقيق. فما أصبح ثابتاً ومبرهنًا هو ان النصارى انفسهم قاموا قبل الاسلام بإحراق مكتبة الاسكندرية مثلما حطموا آلهتها ومعابدها، ولم توجد في عهد الفتح الاسلامي أية مكتبة كي يقوم المسلمون باحراقها (2).
ويشاطر غوستاف لوبون هذا الرأي كل من ويل ديورانت (3) والدكتور هونغ (4) وجان ديفن (5) وكثير غيرهم....
وهذه الرواية التي لم يُشَر اليها في تاريخ مصر ولا في تواريخ المسلمين والاقباط بعد الاسلام، لا ندري في دماغ أي مغرض نُسجت؟!. الا يُفهم من القرائن ان الايدي الصليبية الحاقدة كانت وراء صياغة مثل هذه الاسطورة، كي يحاولوا بهذه الطريقة، التقليل من حجم جرائمهم وقتلهم عشرات الالوف من المسلمين في بيت المقدس وإحراق أكبر مكتبات ذلك العصر في طرابلس؟!
وفي أعقاب تلك الفرية الكبيرة، وبعد تحريض الاستعمار للاقليات ضد الاسلام، لجأ الزرادشتية او القوميون المتعصبون (6) الى جرّ خرافة إحراق كتب الاسكندرية الى المدائن، ونسبوا ذلك العمل الى سعد بن أبي وقاص بعد ان نسبوه في الاسكندرية الى عمرو بن العاص (7).
28- من المؤكد ان موهبة العلم من أعظم ما وهبته الحضارة الاسلامية الى العالم الجديد، غير ان نتائجها ظهرت بشكل بطيء. فتاك الاستعدادات والاعمال العظيمة التي اوجدتها وقامت بها الثقافة العربية الاسلامية في اسبانيا، قد آتت ثمارها بعد فترة طويلة، حيث ظلت اشعة الحضارة الاسلامية العظيمة محجوبة لفترة طويلة من الزمن خلف السحب القاتمة. ولم يكن العلم هو الشيء الوحيد الذي أعاد الحياة لأوروبا، بل ان عوامل كثيرة أخرى من آثار الحضارة الاسلامية كانت مشعلًا أضاء بأشعته الباهرة الحياة الاوروبية. ففي تلك الفترة التي لم يكن للعالم انجازًا واضحًا على صعيد البحوث العلمية كانت الاثار المنفتحة المضيئة والعظيمة للثقافة الاسلامية، مصدرًا امينًا ورصينًا للعالم الجديد.
كتب "بريفولت" في كتابه "بناء الانسانية" (Making of Humanity) ص 109: "نحن لسنا مدينين للعرب المسلمين على صعيد ما قدموه لنا من اكتشافات واختراعات مهمة فحسب بل اننا مدينون لهم ايضًا على صعيد موهبة العلم بشكل عام، لأننا نعتقد انه لم يكن هناك علم بالمعنى الحقيقي في العالم القديم. والعلوم الفلكية والرياضيات الاغريقية كانت علومًا أجنبية أخذها الاغريق عن الاخرين، ولم تصبح هذه العلوم عالمية ولو ليوم واحد، وامتزجت فقط مع الثقافة الاغريقية المحدودة وأضفت عليها المدرسة الاغريقية نظاما خاصًا وأضافت اليها نظريات جديدة. غير انها لم تكن من حيث الاسلوب والطريقة والاتقان وجمع العلوم وتثبيتها، وكذلك من حيث ابتداع الاساليب الجديدة المتنوعة على صعيد البحوث العلمية والدراسات العميقة الواسعة في مختلف العلوم، وكذلك تأسيس المذهب التجريبي، لم تكن هذه جميعًا منسجمة مع طبيعة اسلوب العلوم الاغريقية! وقد ظهرت البحوث العلمية بهذا الاسلوب لاول مرة في الاسكندرية. واما ذلك العلم الحقيقي الذي ندعيه، فنحن مدينون له للمسلمين. نحن ندين لهم في تقليدنا المذهب التجريبي والاقتباس منه والتطور في الرياضيات وبشكل عام في التحول في العلوم الطبيعية الذي لم يكن لدى العلماء الاغريق اقل اطلاع عليه. وتلك الروح العلمية الوثابة، هي التي نفذ اسلوبها الخاص العظيم الى البلدان الاوروبية عن طريق العرب".
29- يمكن تعريف العرفان او التصوف باختصار انه: وسيلة الوصول الى الحقيقة، الحقيقة الكامنة على اي حال في باطن الانسان، وفي باطن كافة الاشياء، والتي تعني النظر الى كل شيء كما هو. وعلى الانسان ان يبدأ هذا السير من نفسه، أي يجب ان يعرف "نفسه" كما هي على حقيقتها. (وللأسف فإن الانسان اليوم قد أخضع كل شيء للتجربة عدا نفسه).
والعرفان باختصار نوع من استخدام قوى الانسان في معرفة ذاته. فالانسان خاضع لنوع من المشاعر والافكار التي تنفذ الى ذهنه دون ان يريد. واول خطوة في العرفان هي السيطرة على عامل وجود "الذات".
وفي طريق الوصول الى العرفان يلزم مقدار من التريض والتعرض للمشاق، ولا بد ايضًا من التضحية والايثار من أجل تحقيق هذا الهدف.
فالعرفان اذاً جهود ونشاطات داخلية قوية وشديدة من أجل معرفة النفس او الذات. ولا علاقة مطلقًا لهذا الامر باعتزال الدنيا وأساليب الزهد السلبي التي ينتهجها الدراويش من لباس الخرق وسكنة الخانگاهات (8)، وان كان الانقطاع المؤقت عن المجتمع في مرحلة من مراحل "السير والسلوك" ضروريًا احيانًا. وانطلاقًا من ذلك فإن اولى رسائل العرفان هي ايجاد نوع من التوازن الذاتي في قبال الاخلاق والقيم، ولا يمكن حل المعضلات والمشاكل البشرية دون العودة اليها.
والرسالة التي يحملها التصوف الاسلامي في هذا اليوم للعالم، يمكن ان تكون من أهم الرسائل الموجهة للانسان المعاصر التائه الغريب عن نفسه.
________________________
(1) مجلة وحيد، العدد 109/ مقالة محيط طباطبائي.
(2) حضارة الاسلام والعرب / ص 275.
(3) قصة الحضارة، ج11/ ص219.
(4) شمس العرب تسطع على الغرب / ص 362.
(5) عذر تقصير به پيشگاه محمد وقران / ص 129.
(6) مجلة هوخت، عدد حزيران، عام 1973.
(7) مجلة "مكتب اسلام" العدد 9، السنة 14/ مقالة " خرافة احراق الكتب" علي حجتي كرماني.
(8) الخانه گاه: مسكن المتصوفة.